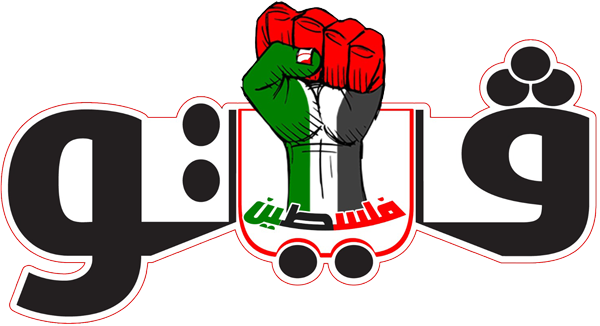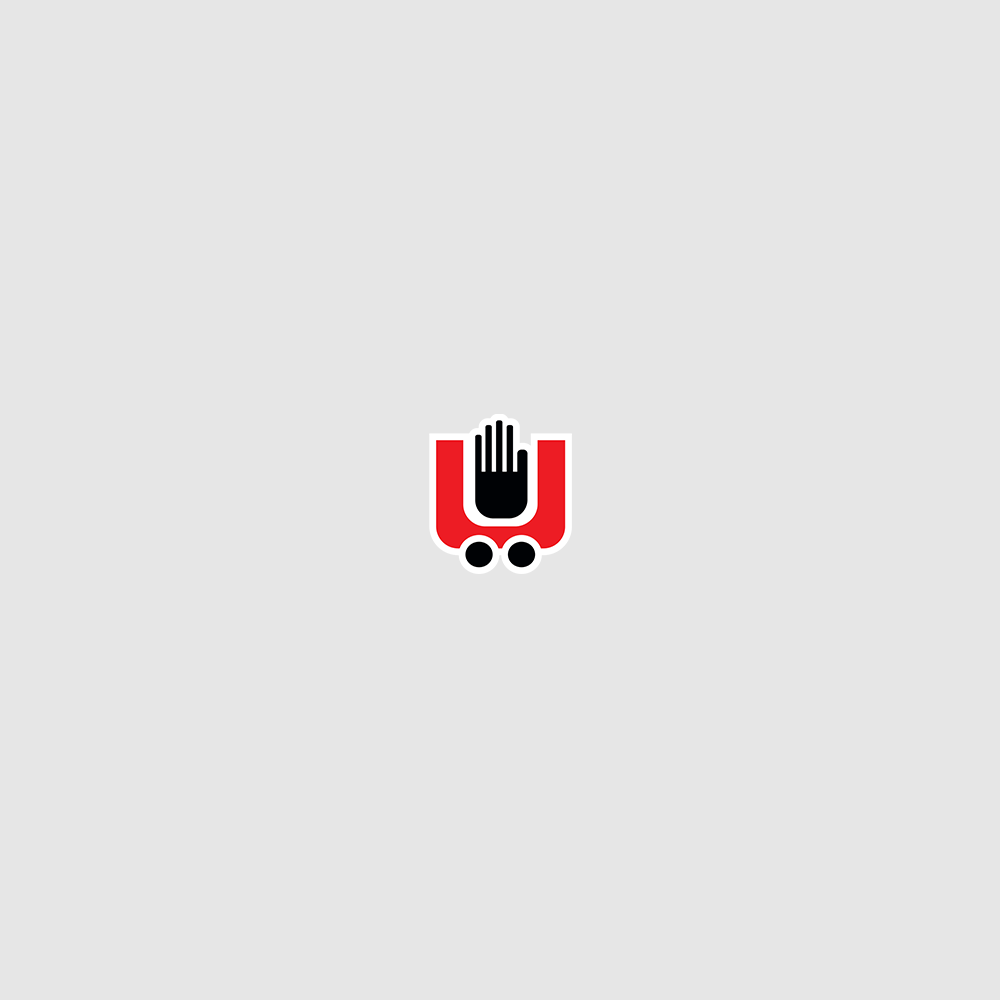«قلم في بيسان» قصة لـ«هبة الله سيد»

كنا جميعًا داخل «الباص» الذي نقلنا من مدينة «جنين» المُحتلة متجهًا إلى القدس، فقد طلب مرشدنا في الرحلة من السائق أن ينقلنا إلى القدس القديمة عسانا نلحق صلاة عشاء اليوم بالمسجد الأقصى، ويبدو أن ذلك أمرًا مستحيلًا فأكمنة اليهود تتناثر كالطاعون على أطراف البلدات والمداخل، فالطريق يطول وتتخمّر خلاله في صدورنا والمكان رائحة الذُل وكأن اليوم هو نسيان 1948!!
وعندما كنا على مشارف مدينة «بيسان» التي تبعد عن القدس مسافة عشرات الكيلو مترات، ناديت السائق: «يا سيدي هل لك أن تقف هنا عند هذا السهل الأخضر لحظات، أريد أن أحقق حلمي! فضحك وضحك جميع الركاب معه».. هاها، تحت أمرك آنستي.
وبالفعل توقف «الباص»، اخذت معي حقيبتي والهاتف النقال لالتقاط بعض الصور من المكان، وورقة وقلمي المفضل «الذي يجعل خطي السيئ أصلًا، أجمل مما هو عليه».
تركتهم يمشون عند طرف السهل وانتقلت أنا إلى مكان آخر بالطبع بعد أن أخذنا إذن قوات الأمن الإسرائيلية قبل الدخول والتجول بحرية عند السهل، فهنا فقط تستأذن الغريب كي تدخل بيتك وبيت إخوانك، نادوني فلم أجب وأكملت المسير، وما إن دخلت في منتصف السهل الأخضر ترددت على مسامعي أنشودة فيروزية كنت أسمعها دائمًا في طريق عودتي من العمل، تلك المرأة التي تفعل الأفاعيل بمهجتي وكياني، فما بالك وبالي إذا تغنت لموطن العشق بالقلب! كانت تنادي البعيدين أن يأخذوها معهم إلى بيسان مرة ثانية فقد تاقت شوقًا لبيتها وللزهيرات، أنا أيضًا كنت كالذي أحب روح آنسها مرة واحدة ورحلت ثم ها هو يراها أمامه مجددًا.
عادوا إلى النداء مجددًا فأعدوا روحي لجسدي ثانية بعد أن كنت تركتها وذهبت إلى حيث تسكن أنشودة «فيروز»، وقال لنا مرشد الرحلة، إن هذه المدينة تركها سكانها الفلسطينيين منذ عام 1948 وحل محلهم اليهود ولكن هيهات، فلسطين مازالت عالقة بسماء بيسان تنزل إلى الأرض كل ليلة لتطمئن على شجرات الموز والزيتون والكَرم، وقال لنا أيضًا: "هنا ياشباب حكم المصريون بضع سنين وتركوا أثرًا لا يُنسى، هذه التماثيل الفرعونية الضخمة التي ترونها".
أخذت أدون ما يقول وتتحرك أصابعي لا إراديًا فلم أكن أعي ما يقول فقط إبهامي وسبابتي يحلان محل عقلي وأذني! وبقيتي تجوب بيسان وكأن امتزجت روحي وفيروز وبت أتغني بصوتي النشاذ "خُذوني إلى الزُهيرات إلى غفوةِ عند بابي، خذوني إلى بيسان..."، ولم أفق إلا على صوت زملائي وزميلاتي يضحكون على قبح وبشاعة صوتي، فسـكت..
كانت كل ذرة تراب ببيسان تحمل بقايا شهداء النكبة بين راحتيها (قالوا لنا إن دماء الشهيد لا تجف ولا يكل نزيزها، فقط يواريها الثرى عن أعين الجبناء حتى تحن لحظة الانفجار العظيم!! كنت أسمها في كل خطوة وتلازمني والزملاء.
ظل المرشد بدوره يعيد ويكرر:
-قلنا يا شباب إن نصف هذه التماثيل العظيمة مصري والآخر روماني ولكن كما ترون الفرعونية هي الأقوى والأروع، أخذ يرغي ويُزبد حتى أحسست أنني أجلس على مقعدي بالمدرسة أمام معلم التربية الوطنية المُسهب حد الهذيان.
صمت أخيرًا..
وأنا أيضًا فرغت من التدوين والتصوير، وعندما بدأت أستفيق من تحليقي السماوي بالغ الوصال، قرأت ما كتبته طوال تجوالنا ووجدت بين السطور عبارة "حيــن كنا صغارًا، اعتدنا الجلوس عند البيارة المقابلة لشجرة الزيتون العتيقة، وكنا نسرق الزيتون منها ونلقيه في البيارة، والعجيب أنها لم تِضر في شيء بل كانت تطلب منا المزيد!!".
عدنا إلى "الباص" لنستكمل طريق الذهاب إلى القدس، كان الغروب قد لاح بالأفق، تحرك السائق وكان صوت المكبح كإنذار أخيـــر للرحيل قبل الأخير.
فتحت حقيبتي لأضع الهاتف والمتعلقات فلم أجد القلم الذي يجعل خطي أجمل مما هو عليه، ثم تذكرت أنني تركته على إحدى نوافذ بيت ريفي من الطراز الفلسطيني ترك أثرًا ومزارًا (وكأن فلسطين أصبحت ماضيًا ليس إلا)، ورحلـــت.