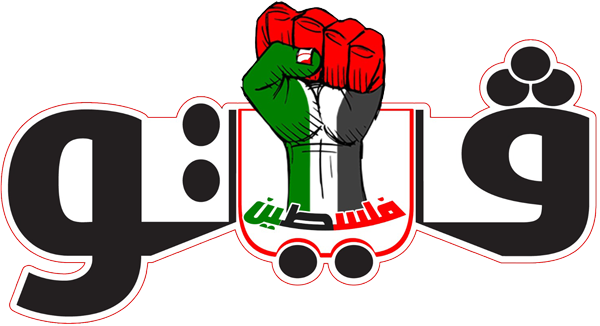خيري شلبي يتحدث عن التليفزيون ونوبل وسيدة الغناء في حياته

- هناك الكثير من المسكوت عنه في الكتابة، أشياء يجد الكاتب نفسه مجبرًا على مجانبة هذه الأشياء أو الأحاسيس أو المشاعر، حتى لا يصطدم بالمجتمع والقوة الجاهلة فيها.
- جائزة نوبل أصبحت مُوظفة لخدمة السياسة الأمريكية، وفي السنوات الأخيرة حصل عليها كُتّابٌ لا أعتقد أنهم جديرون بها.
- أنا نوع من الكتاب يقسون على أنفسهم عند الكتابة، خاصة أنني أتجرد دائما من أي تحفظات اجتماعية وأواجه العالم عاريًا تمامًا، ولا يعنيني أن يراني الناس في صورة كذا أو كذا.
- ما كتبته أثناء كتابته كان هو ما تمنيته، ولكنني كنت كمن يصعد جبلًا، حينما يصل إلى قمة يتصور أن هذه هي القمة، وكلما واصل الصعود اكتشف أن القمة لا تزال بعيدة.
- لا أفتح التليفزيون إلا لبرامج محددة وأكرهه كراهية شديدة، وأتمني زواله، لأنه دمر البشر في الدول النامية على وجه التحديد من إساءة استخدامه وتحويله إلى «دكان للإعلانات» وفقد شرفه.
- الموسيقى تحاصرني حصارًا جميلًا، وأترك لها الفرصة لهذا الحصار، وحين تسكت الموسيقي من حولي أشعر بالموت، وسيدة الغناء عندي هي فيروز بلا شريك، ثم أم كلثوم القديمة.
وجهة نظر خاصة جدًا يمتلكها الكاتب الراحل خيري شلبي حول كل الأمور، لا يقف كثيرًا عند «ما هو كائن»، لكنه دائما يسعى لإقرار «ما يجب أن يكون»، لا سيما وأنه الكاتب الذي بدأ من الصفر، ووصل إلى قمة «جبل الموهبة»، لكنه بعد هذه الرحلة الثرية الطويلة يرى أنه لا يزال في البداية، بداية الكتابة.. بداية الحياة.. بداية المُتعة.
الاستماع إلى وجهة نظر «عم خيري» في الحياة والكتابة، ممتع إلى حد الكمال، فالرجل الذي رحل عن عالمنا من سنوات عدة، كان يمتلك «قناعة الصوفي» و«محبة الدرويش» وجسارة العاشق وبساطة المحب وأحلام الأطفال النقية الطاهرة.
محطات كثيرة مر عليها قطار الكاتب الأشهر خيري شلبي، وكل محطة حفرت على جدران روحه علامات لم يستطع أن يطمسها الزمن، لا سيما وأن جزءا كبيرا منها حفره «عم خيري» في كتاباته، روايات كانت، أو مقالات أو دراسات أو قصص قصيرة.
الغريب هنا أن الكاتب الراحل، رغم مئات الأوصاف التي منحها له أحباؤه وقراؤه وتلاميذه، فإنه أصر تمام الإصرار، على الاكتفاء بلقب الكاتب المُبدع، حيث يقول: «أفضّل أن أكون الكاتب المبدع، وهي تشمل كل هذه الأوصاف، لأنني كتبت عن المهمشين والريف المصري والمدينة والحياة المعاصرة بكل جوانبها وكل مظاهرها الاجتماعية والفكرية والسياسية والفلكورية».
أديب نوبل، الروائي نجيب محفوظ، كان من ضمن المحطات المهمة التي مرّ عليها «قطار خيري شلبي» والتي قال عنها «نجيب محفوظ سيظل مؤثرًا في الرواية العربية إلى وقت طويل قادم، خاصة أنه لم يترك شاردة ولا واردة في الشكل الفني للرواية إلا وجربه، ولم يترك شاردة ولا واردة في تاريخ مصر الاجتماعي إلا وغطاها بفن مليء بالحياة والصدق والقدرة.
«كيف أكتب عن القرية ولدينا خيري شلبي»، جملة نطق بها «محفوظ»، في حوار مع جريدة الجمهورية بعد فوزه بجائزة نوبل.
التجربة الحياتية لـ«عم خيري» هي الأخرى كانت كصاحبها «متفردة»، والتي يحكي عنها قائلًا: «عملت في مهن كثيرة، وجميعها ساهمت في تشكيل عوالمي، فأنا تنقلت وأنا صبي بين العديد من المهن، فقد عملت نجارًا وحدادًا ومكوجيًا وخياطًا، وكنت بائعًا سريحًا، وبائعًا في المحل، وكنت قمسيونجيا، فكل هذه المهن التي تنقلت بينها، ولم أصمد في أي منها طويلا، اللهم إلا مهنة الخياطة، قضيت فيها شطرًا طويلًا من طفولتي، هذه المهن أطلعتني على حقيقة الشعب المصري بجميع طبقاته وفئاته والمخفي من أسراره ووجدانه، كما أن احتكاكي بطبقة الأنفار الزراعيين والتراحيل لمدة طويلة، أطلعتني على الفلكور المصري وحببتني فيه، وجعلتني من قرائه الدائمين، هذه هي المسيرة الحقيقية التي زودتني بالسماد الفني والموضوعي الذي لا أزال أستقي منه موضوعاتي إلى اليوم».
«المخفي الذي يريد إظهاره» أمر آخر تحدث عنه «عم خيري» مفسرًا إيّاه بقوله: «دائما أسعى للكتابة عن المشاعر التي نُقمع بسببها، ونقمعها في داخلنا خوفًا من الرقابة الاجتماعية أو الرسمية الإدارية أو الرقابة الدينية أو من جميع أنواع الرقابات، هناك الكثير من المسكوت عنه في الكتابة، أشياء يجد الكاتب نفسه مجبرًا على مجانبة هذه الأشياء أو الأحاسيس أو المشاعر، حتى لا يصطدم بالمجتمع والقوة الجاهلة فيه، وهي مهما كانت صغيرة إلا أنها قوية ولها سلطان كبير جدًّا مسيطر على الإبداع العربي بشكل عام، هناك أدب يجب أن يُكتب لم نكتبْه بعد، هذا الأدب الذي لم نكتبْه بعد هو الذي لا تقدم للبشرية ما لم يُكتب، وأظن أنني وبعض الزملاء قد اقتربنا بشكل أو بآخر من المسكوت عنه في الكتابة الأدبية، فشخصيًّا أعتز بعدد كبير من القصص والروايات صوّرتُ فيها دخيلة الإنسان، بصرف النظر عن أي رقابة اجتماعية أو دينية أو ثقافية».
رأي غريب كان يمتلكه الكاتب الراحل خيري شلبي فيما يتعلق بـ«الترشح للجوائز»، لا سيما أنه تم ترشيحه أكثر من مرة لنيل جائزة نوبل، حيث قال: لم أعلق آمالًا كبيرة أو صغيرة على هذا الترشيح، لاعتقادي أن جائزة نوبل ليست سهلة إلى هذا الحد، وكونها جاءت إلى نجيب محفوظ، فهذا لأنه صاحب موقف ريادي وصاحب إنتاج ضخم جدًا يقارن بأكبر كُتّاب العالم حتى في القرن التاسع عشر، أما بالنسبة لي ولجيلي فالمشوار لا يزال طويلًا، كما وأن جائزة نوبل أصبحت مُوظفة لخدمة السياسة الأمريكية، وفي السنوات الأخيرة حصل عليها كُتّابٌ لا أعتقد أنهم جديرون بها، آخرهم الكاتب التركي أورهان باموق، وكتبت عن هذه الظاهرة كثيرًا، وإعطاؤها لمن هم دون المستوى لمجرد تغطية مسائل سياسية أو توازنات أو ما إلى ذلك من وسائط لا ينبغي لجائزة نوبل أن تكون فيها، فأنا لا أعلّق أملًا، ليس فقط على جائزة نوبل، ولا على أي جائزة، وبطبيعتي نفيت نفسي من الجوائز، لم أتقدم لأي جائزة في حياتي، والجوائز التي حصلت عليها فوجئت بها، والجائزة الحقيقية هي أن تُفاجَأ بها، لا أن تتقدم إليها وتدخل مسابقة، ففي المسابقات دائما يفوز فيها غير الفرسان».
«السيناريو» محطة طارئة في حياة الروائي خيري شلبي، ورغم هذا فإنه استطاع بمهارة معروفة عنه، أن يترك بصمته واضحة على جدرانها، والتي قال عنها: «كنت أكتب القصة القصيرة، وهناك فترة اشتغلت فيها كاتبًا للسيناريو، وتخرجت في معهد السيناريو، الذي أقامه المرحوم صلاح أبو سيف، وكنت في أول دفعة ونجحت بتقدير متميز، وعملت في كتابة السيناريو سنوات طويلة جدًا إبان ظهور التليفزيون، وشاركت في الكتابة الدرامية لبرنامج «حياتي» وبرنامج الأدب، وأعددت قصصًا للإذاعة ومسلسلات ما يقرب من ألف تمثيلية إذاعية في صوت العرب والبرنامج العام والشرق الأوسط، وكانت صوت العرب كبيتي تمامًا ولو فتحت دفاترها لوجدت لي أعمالًا مع إسلام فارس وأمين بسيوني وعادل جلال، وزكريا شمس الدين، وكمال سرحان، ونفس الأمر في التليفزيون، وكان حلمي أن أكون كاتبًا مسرحيًا، ولكن ضُرب المسرح في عصر أنور السادات، وانهار تمامًا، فأحبط حلمي المسرحي، إلا أن ما أعددت نفسي له ككاتب مسرحي قد أفادني في كتابة الرواية وفي التوفيق في رسم الشخصيات الدرامية كما ينبغي».
وأكمل: «بالنسبة للسيناريو، فقد اتضح لي منذ وقت مبكر أنه ليس طريقي، لأني في الرواية أعيد بناء العالم من جديد كما أرى، أما في السيناريو فلا بد أن يشاركني شركاء كثيرون منهم المخرج ومنهم الممثل الذي يطالبني بتغيير الحوار ليستطيع أن ينطقه، اضطر إلى كتابة حوار مبتذل تماشيًا مع لسانه الذي أخذ على الابتذال في الحوارات الدارجة، كما أن المخرج لا ينفذ مما أراه إلا 50%، فامتنعت عن كتابة السيناريو مدة كبيرة جدا، حتى تم شراء رواية الوتد، وعرضوا عليّ 4 محاولات لكتابة السيناريو، فلم تعجبني أية محاولة، ووجدت أنه إنقاذًا للرواية لا بد أن أكتبها بنفسي، وكتبتها في عام ونصف عام، وصادفت مخرجًا واعدًا هو أحمد النحاس، الذي تواضع أمام النص، فجاء عملًا ناجحًا بكل المقاييس، ولكني رغم ذلك لم أجد في نفسي القدرة على الاستمرار في كتابة السيناريو، لأنه يحتاج إلى جهد مضاعف، وأنا دماغي أصبح مبرمجًا على تقنيات الرواية، حينما أكون هدافًا في كرة القدم، ثم أذهب إلى اللعب في كرة السلة لا بد أن أكون لاعبًا من الدرجة العاشرة».
وتبقى الرواية هي الابنة البكر لـ«عم خيري» ولهذا قال عنها: «رواياتي كلها يصعب عليّ تمييز إحداها عن الأخرى، لأن كل واحدة منها، أهدر فيها دمي بشكل قاسٍ جدًا، وأنا نوع من الكتاب يقسون على أنفسهم عند الكتابة، خاصة أنني أتجرد دائما من أي تحفظات اجتماعية وأواجه العالم عاريًا تمامًا، ولا يعنيني أن يراني الناس في صورة كذا أو كذا، أنا يهمني الحقيقة الفنية الإنسانية، وكيف أبرزها، أنا لست برجوازيًّا وأسعى أن تكون صورتي في نظر القراء مبهجة، ولكن يهمني أن أشعر القارئ أنني صادق في كتابتي ولا أبتغي سوى وجه الحقيقة».
«إحساسي بالكبر لا يؤلمني».. حقيقة لم يشأ أن يخفيها «عم خيري» بل زاد عليها قائلًا: «إحساسي بالكبر في السن، مشبع بالتجربة والرضا على ما حصلته خلالها، لكن ما يزعجني هو المرض، لأنه يذل الإنسان، ولأني أخذت نفسي بالشدة، فقد أثّر ذلك على صحتي كثيرًا، ولولا أنني أقاوم مقاومة جبارة حتى لا أستسلم للشيخوخة، ما كنت في هذه الحالة الآن، ولكن رغم ذلك أعتقد أنني بالكاد قد تعلمت الكتابة، بمعنى أن كل ما كتبته من قبل: الروايات والمجموعات القصصية، وكتب الدراسات الأدبية، والبورتريه الذي كتبت فيه 250 شخصية، كل هذا علمني الكتابة وأوصلني إلى حالة من الرغبة في الكتابة بهذه التقنيات الجديدة، التي استطعت الحصول عليها عبر هذه الرحلة الطويلة، المؤسف أن يجيء ذلك في هذه الشيخوخة، ولكن بروح المقاومة وقراءتي الدائمة للشاعر الكبير فؤاد حداد، الذي يملؤني بالرغبة في الحياة، وفي المقاومة، سوف أستطيع أن أكتب ولو عملًا واحدًا، المهم أن أضع فيه ما أتمني كتابته فيه».
وأضاف: «ما كتبته أثناء كتابته كان هو ما تمنيته، ولكنني كنت كمن يصعد جبلًا، حينما يصل إلى قمة يتصور أن هذه هي القمة، وكلما واصل الصعود اكتشف أن القمة لا تزال بعيدة، وأن هناك قممًا لا تزال ساحرة، أنا الآن قد أصبحت بإمكاني أن أصل إلى القمة الساحرة، والتي تتحقق في 3 أ و4 أعمال روائية كبيرة، لو أنجزت واحدًا منها أموت وأنا راضٍ عما فعلت».
وأردف: «أنظر إلى أعمالي باعتبارها درجات سلم يوصلني إلى المعنى الحقيقي للكتابة، فالكتابة ليست قلمًا وقرطاسًا أو "تسويد" ورق، لكنها عملية إبداعية معقدة جدًا، ومهمة جدًا في تاريخ البشرية».
التجربة.. كلمة سر «روعة خيري شلبي» والتي قال عنها: «العمل الروائي بحاله يكون رمزا لمعنى، ليست الشخصيات أو الأحداث، ويمكنني القول إن صالح هيصة، وكل أبطال رواياتي، هناك صلة وهناك وشائج قوية جدًا تربطني بهم، فأنا ليس عندي شخصيات مُخترعة، إنما شخصياتي دائما مستقاة من الواقع الذي لمسته بيدي، وعِشته بنفسي، ليس من المهم أن تكون القصة قد حدثت لي، أو أكون أنا بطلها، حتى وإن رويتها بضمير المتكلم، إنما لا بد أن أكون قد عايشتها ونقعت فيها، بحيث أرى ظلالها الدقيقة لأستطيع كتابتها، وكل شخصياتي لها صلة بي والواقع المعاش والمصرية، وهذه تهمني جدا».
القرية.. نقطة تفرد خيري شلبي، وإن كان أكمل مسيرة الكاتب الراحل يوسف إدريس، بل وحاول البعض ربط «قرية خيري» بـ «قرية إدريس» غير أنه قال: «أولًا تعلمت من يوسف إدريس الكثير جدًا، وكما قلت سابقًا إنني أسلوبيًا متخرج في 4 مدارس كتابية إبراهيم عبد القادر المازني، ويحيى حقي، وعبد الرحمن الشرقاوي ويوسف إدريس، هذه المدارس الأربع كل منها قدمتْ تصالحًا ما بشكل أو بآخر مع العامية المصرية (لغة الشارع)، وتعلمت من يوسف إدريس أن الشخصيات العادية من أهل القرية تصلح أن تكون أبطالًا لقصص، وتعلمت من عبد الرحمن الشرقاوي لغته البديعة المخلوطة بلغة الحياة، إنما قرية يوسف إدريس وقرية عبد الرحمن الشرقاوي، متقاربتان، وهما قرية من وجهة نظر البرجوازية الفلاحية، والطبقة المتوسطة الزراعية، وهما من أبناء هذه الطبقة، وهناك درجة من العلو بيشوفوا من فوقيها، إنما قريتي هي قرية الكادحين، قرية الأنفار، فهي من وجهة نظر الأنفار، فهي قرية مختلفة اختلافا جذريا عن قرية يوسف إدريس وعبد الرحمن الشرقاوي».
«مزاج عم خيري الغنائي» محطة أخرى تكشف مدى اعتزازه بكل ما هو شرقي، حيث قال: «أنا مستمع جيد للغناء والموسيقي منذ الطفولة، والأغاني دائما بجانبي، إما محطة الأغاني أو الشرائط، لدى مكتبة حافلة، وكنت أتمني أن أكون مطربًا في الصغر، كانت رغبة، لأني نشأت في الطفولة في بيت به أسطوانات والجرامافون، وحاولت أن أتذوق الموسيقى الكلاسيكية فلم أستطع، لأنني شرقي صرف، فالموسيقى الشرقية تهزني هزًا سواء كانت مصرية أو تركية أو أفريقية، لا أفتح التليفزيون إلا لبرامج محددة وأكرهه كراهية شديدة وأتمنى زواله، لأنه دمر البشر في الدول النامية على وجه التحديد من إساءة استخدامه وتحويله إلى «دكان للإعلانات» وفقد شرفه، لم أعد أصدق أي كلام يقال، وأصبح عندي شك في أنه يقصد وجه الحقيقة».
وأردف: «عندما كان التليفزيون خاضعًا للقواعد الأخلاقية والقومية والوطنية كان عظيمًا وكان جهازا يعتد به، أم الآن فقد أصبح سوقًا للإعلان، حتى أكبر مفكر في الدنيا لو تحدث في التليفزيون سيركب عليه الإعلان، فأصبح هنالك شك عند المشاهدة، وبالتالي صار التليفزيون جهاز تخريب بالمعنى الحقيقي للكلمة، وقد انتبه العالم منذ سنوات إلى خطورته فرشدوا استخدامه، وهناك جمعيات تحارب ما يعرضه».
وتابع: «الموسيقى تحاصرني حصارًا جميلًا، وأترك لها الفرصة لهذا الحصار، وحين تسكت الموسيقى من حولي أشعر بالموت، وسيدة الغناء عندي هي فيروز بلا شريك، ثم أم كلثوم القديمة، أم كلثوم زكريا أحمد، والسنباطي، قبل أن تتحول إلى مؤسسة ذات قوة ونفوذ كبير، مطربي أيضا عبد الحليم، أحبه جدًا، لأنه ممثل لجيلي، أعشق صباح ودلعها الجميل الحنين، أعشق هدى سلطان، وصوتها اللي فيه صوت شخللة الذهب الفلاحي، أيضا أعشق عباس البليدي، ومحمد قنديل صوت لا يعلى عليه بين الرجال، أعشق إسماعيل شبانة، في لحن عبد العظيم عبد الحق، في أغنية "يا سلام لو كنت تعرف قد إيه أنا قلبي حبك"، أعشق عبد الغني السيد، ومحمد فوزي صاحب المدرسة الثانية في تجديد الموسيقى بعد سيد دوريش، كل مدارس التلحين الحديثة خرجت من عباءة محمد فوزي، بشكل أو بآخر».
ثنائية «الأدب والسياسة» هي الأخرى تحدث عن خطورتها «عم خيري» وقال: «تعود إلى شخصية الأديب، إذا كان غنيًّا بالمادة الفنية وصاحب مشروع قبل أن يكون وزيرًا فإن الوزارة لن تؤثر عليه بالسلب، بل ربما تؤثر عليه بالإيجاب، تمكنه من رؤية أشياء والإسهام في تطوير أشياء، وأمامنا تجربة الأديب الفرنسي الشهير أندريه مالرو، الذي كان وزيرًا للثقافة الفرنسية، وكانت له روايات شهيرة جدًا، وهناك إيفو أندريتش، صاحب رواية جسر على نهر الدورينا، استقال خصيصًا من الوزارة لكتابة روايته الخالدة، ربما كان هذا هو الوضع الأمثل، لكن هذا لا يمنع الأديب من أن يكون وزيرًا شرط أن يكون لديه برنامج خاص بالوزارة، ويعرف دوره جيدًا، وإذا كان لديه مشروع فني سابق على الوزارة، فإن مشروعه الفني سيظل يلح عليه ولن يتركه إلا بأن يترك هو الوزارة ويتفرغ له».
واستكمالًا لموقفه من الجوائز، وتحديدًا تحليله لحالة التهليل للأديب العربي عندما يحصل على جائزة عالمية قال: «شعور بالنقص، والانسحاق أمام الآخر الغربي، وربما تكون هذه الجائزة أو تلك من الغرب بلا قيمة حقيقية، ومع ذلك تقام لها الأفراح عندنا، بصرف النظر عن تفاهتها أو سوء اتجاهها أو ما إلى ذلك، وهذا من بقايا انسحاقنا أمام الأمم التي احتلتنا سنوات طويلة، ومع الأسف التهليل لمثل هذه الجوائز التي انتشرت في حياتنا مؤخرًا أصبح لعبة خطرة، أصبح بعض الشبان يكتبون لهذه الجوائز، وأصبح هناك تنافس وتكالب على دور النشر لترشح أعمالهم لهذه الجوائز، وكثرة الجوائز خلقت وهمًا لدى الكتاب حتى الذين لا يجيدون الكتابة، يعني أي كاتب تافه لسه بيحاول محاولته الأولى، ويتقدم لنيل جائزة ما، تصبح اللجنة فاسدة، ولا يدور بخلده أنه قد يكون قد كتب نصًا تافهًا، وأنه لا يستحق أن يطبع، المجتمع الثقافي أصبح مليئًا بالعاهات التي تعطل الموهوبين الحقيقيين، وتشوشر على حكماء الساحة الذين يريدون تقديم خدمات حقيقية للنهوض بالأدب، البلطجة الثقافية تضخمت في أيامنا الأخيرة».
وشدد أنه «على العقلاء من القراء أن يعرفوا أنه لا توجد جائزة ترفع من شأن كاتب لا يستحق أن يرفع، لو اجتمعت جوائز الإنس والجن لا يمتلك استعدادا لأن يكون كبير لن يكون كبيرًا، ولو اجتمع نقاد الإنس والجن على صنع كاتب وهو خال من الموهبة، فسوف يفشلون لا محالة، والأمثلة كثيرة أمامنا، ويستحيل أيضا هدم كاتب موهوب، نجيب محفوظ ظل 20 عامًا ينشر دون أن يعرفه أحد، وعندما نشر في طبعات شعبية اكتسح، حتى عندما حصّل الجائزة بجهده وباستحقاقه شككوا في قدرته على الحصول على الجائزة، وادّعوا أن إسرائيل هي التي أوصت بإعطائه الجائزة وهذا انحطاط خلقي، لأن إسرائيل لا يهمها على الإطلاق أن يحصل مصري على جائزة نوبل، دائما أبدًا هناك تيارات «مصلحية» غير صادقة في توجهاتها».
المصدر:
حوار إذاعي للكاتب خيري شلبي في برنامج «بين قوسين» مع الإعلامي طارق حبيب