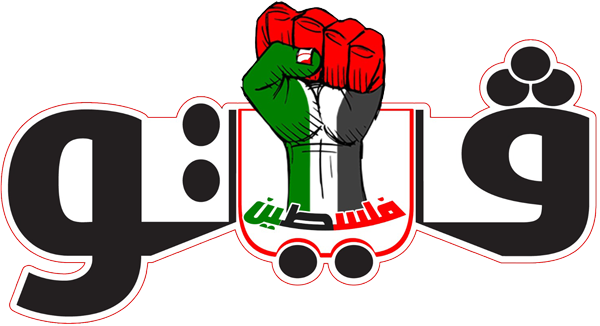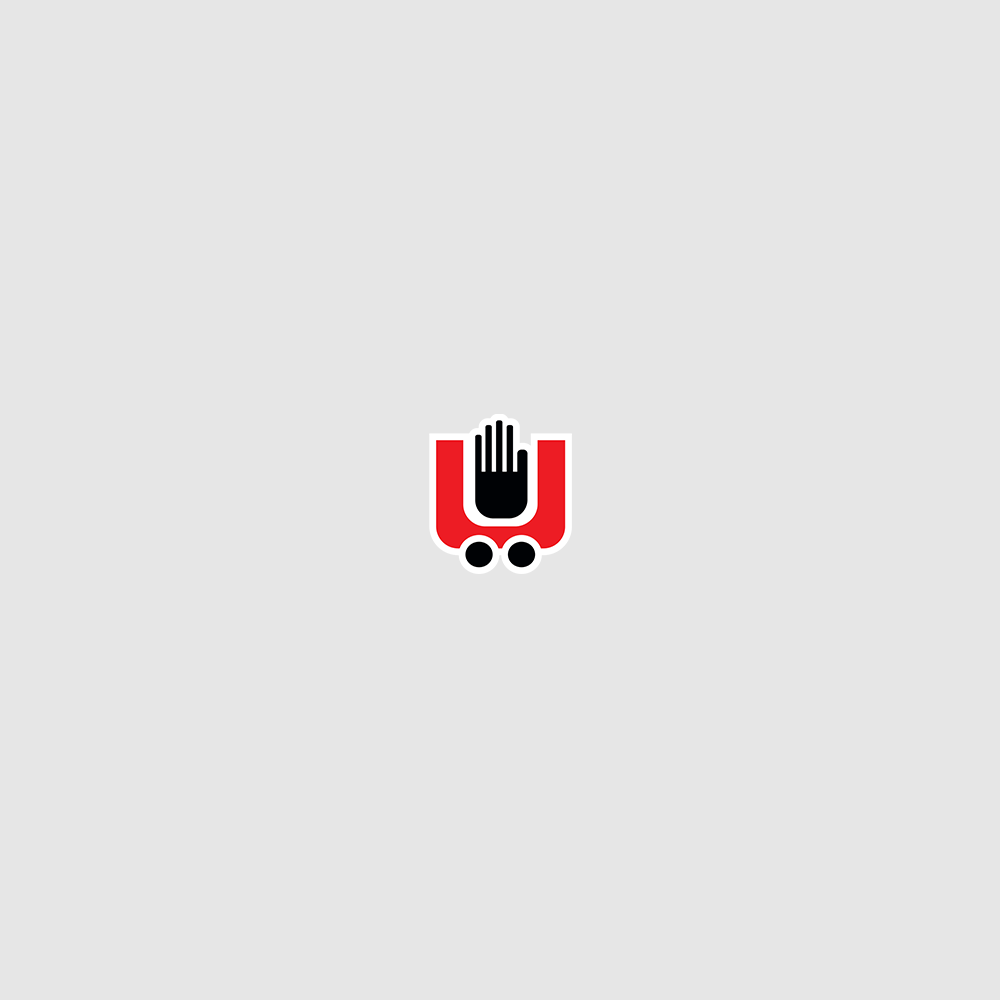اختفاء تدريجى لـأبو الفنون، السينما تلهث وراء الترند، ومبدأ "الجمهور عاوز كده" يهدر قوة مصر الناعمة

ليست الليلة أبدًا كالبارحة. ومصر اليوم ليست مصر خلال مائة عام منقضية. لم تعد مصر هوليود الشرق كما كانت. فقدت مصر ريادة فنية احتكرتها سنين عددًا وعقودًا متواليات. عندما كان عدد سكان مصر عُشر عددها فى 2024 كانت أرضها خِصبة، لا تنجب إلا مواهب، ولا يخرج من ثناياها إلا نوابغ. كانت مصر صاحبة الريادة فى المسرح “أبو الفنون”، والسينما “الفن السابع”، والتاريخ خير شاهد على ذلك، وبدا لسان حال الفن المصرى فى مجمله يشكو ويتماهى مع أغنية على الحجار: “انكسر جوايا شيء”، والواقع يؤكد أنه ليس شيئًا واحدًا، بل أشياء عديدة ومتنوعة!
المسرح المصري: تاريخ عريق وحاضر مؤسف
فن المسرح فى مصر قديم نسبيًا. عرفت مصر “أبو الفنون” منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر. ومع تطور حركة المسرح حتى وصلنا إلى العام 1921 أنشأت مصر المسرح القومي، تبعه إنشاء الفرقة القومية المصرية بقيادة الشاعر خليل مطران؛ تتويجًا للجهود المبذولة لحل أزمة المسرح فى ذلك الوقت. عندما قامت ثورة 1952 كان هناك فرقتان مسرحيتان كبيرتان هما: الفرقة القومية المصرية، وفرقة المسرح المصرى الحديث.
فى خمسينات القرن الماضي.. كان المسرح المصرى على موعد مع ظهور جيل جديد من الكتاب والمخرجين المتميزين الذين أسسوا لمرحلة جادة فى تاريخ المسرح المصرى الحديث. تضم القائمة أسماءً بارزة من بينها: لطفى الخولي، يوسف إدريس، نعمان عاشور، سعد الدين وهبة، ألفريد فرج، نبيل الألفي، سعد أردش، وعبد الرحيم الزرقاني.
وبعد عشر سنين أخرى..سعى المسرح المصرى إلى البحث عن هوية جديدة، تنأى كثيرًا عن الشكل الُمستعار والمُستلهم من المسرح الغربي. يُعتبر توفيق الحكيم ويوسف إدريس وغيرُهما من نجوم هذه المرحلة. وخلال هذه الفترة أنشأت مصر المؤسسة العامة لفنون المسرح والموسيقى التى قدمت إسهامات رائعة فى نهضة المسرح المصرى وترسيخ هويته المتحررة من الأثر الغربي. وفى نهاية الستينيات عرفت مصر المسرح الشعرى على يد الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور.
تواصلت رحلة العطاء فى سبعينيات القرن الماضي؛ حيث عرض المسرح القومى مسرحية “الأيدى الناعمة” لتوفيق الحكيم “ الأيدى الناعمة”، و”الجنس الثالث” ليوسف إدريس، والنار والزيتون لألفريد فرج. هذه الفترة شهدت أيضًا ميلاد جيل جديد من كتاب المسرح الأكاديميين مثل: الدكتور سمير سرحان، الدكتور فوزى فهمي، والدكتور محمد عناني.
مع انتهاء السبعينيات وبداية الثمانينيات..عاد القطاع الخاص بقوة إلى المسرح، من خلال فرقة “أستوديو 80” بقيادة الثنائى محمد صبحى ولينين الرملى اللذين قدما مجموعة من الأفكار الجادة، و”الفنانين المتحدين” التى تألق من خلالها عادل إمام، وقدم عددًا من المسرحيات الكوميدية.
ومع بداية التسعينيات توغل مسرح القطاع الخاص على حساب المسرح الجاد الذى انطفأ نجمه تدريجيًا، واستقر فى أذهان الجديدة أن المسرح لا بد أن يقدم أعمالًا هزلية ساخرة. هذه المرحلة أيضًا شهدت توهج مسرح سمير غانم ومسرح محمد نجم، واصطبغ المسرح بصبغة تجارية بحتة، وأصبحت النصوص المسرحية تسعى إلى زغزغة الجمهور وإضحاكه بأى شكل!
ولأسباب كثيرة، من بينها: التمويل، والبث الرقمى وظهور الوسائط الحديثة وانصراف الأجيال إليها..خفتت الأضواء حول المسرح، حتى وصلنا إلى مرحلة “مسرح مصر” لأشرف عبد الباقي، وهى المرحلة التى اعتبرها كثير من الفنانين والمراقبين، ومن بينهم محمد صبحى ومسرحيون وأكاديميون كبار- إيذانًا بانتهاء المسرح المصري؛ بسبب اقتصاره على تقديمه اسكتشات، معظمها مرتجل لا تربطه فكرة ولا يحيطه إطار، ويميل أحيانًا إلى الاستسهال والاستظراف، وأحيانًا إلى الإسفاف.
السينما المصرية..شيء من الخوف!!
فى العام 2007..احتفلت السينما المصرية بمرور 100 عام على انطلاقها. العام 1907 يمثل نقطة البدء بالنسبة للإنتاج السينمائى فى مصر، ما يعنى أن السينما المصرية أقدم نشأة وأعظم تاريخًا من بعض الدول!
خلال هذا التاريخ الممتد.. أنتجت السينما المصرية نحو 5 آلاف فيلم سينمائى تقريبًا. بعض هذه الأفلام كان مؤثرًا، ولا يزال تأثيره مستمرًا حتى الآن، ولا يزال المشاهدون يترقبون عرضها التليفزيوني، أو يبحثون عنه عبر الوسائط الجديدة، ويتحدثون عن جوانب إبداعية متعددة فيها: نصًّا وتمثيلًا وإخراجًا وهكذا.
نقطة التحول أو الارتكاز الأساسية فى صناعة السينما المصرية تجسَّدت فى تشييد أستوديو مصر فى العام 1934، حيث توالى إنتاج الأفلام المصرية، وكثر عدد المشتغلين فى هذا المجال الجديد. ويُعتبر أستوديو مصر المدرسة الأولى التى تخرج فيها معظم العاملين فى الحقل السينمائي.
كانت السينما فى عقودها الأولى وما بعدها تعكس واقع المجتمع المصرى بكل مرارته وقسوته: “الكرنك” نموذجًا، و”البريء” دليلًا، و”الأرض” برهانًا. كنت تشعر أثناء مشاهدتك فيلمًا ما أنك جزء أصيل منه، أو أنك البطل، أو أنك المؤلف، تعيش معه بكل أحاسيسك وجوارحك، وتترقب النهاية.
لم ينسَ المصريون حتى الآن دفاع “محمد أبو سويلم” عن أرضه فى رائعة عبد الرحمن الشرقاوى “الأرض” العام 1970. ولا يزالون يتماهَون مع أحمد مظهر فى فيلم “الناصر صلاح الدين” العام 1963، وكأنهم يرجونه أن يخرج من عالم الخيال إلى الواقع؛ ليحقق لهم رجاءات مجمدة ومؤجلة أو إن شئت قل: عاجزة. كما إنهم فى كل مرة يرهقون أنفسهم ويقطعون انفاسهم من الركض مع أحمد زكى فى فيلم “الهروب” العام 1988.. وقِس على ذلك أفلامًا أخرى عديدة.
مع مطلع الألفية الثانية.. بدأ الانحدار السينمائى يأخد طريقه بقوة. تخلت السينما بشكل رسمى عن رسالتها، وتجنبت تقديم فن هادف بالمعنى الحقيقي. لا يعنى هذا أن الأفلام أصبحت فى مجملها مبتذلة مثلًا، ولكنها انفصلت تمامًا عن الواقع، وأصبح هدفها تجاريًا، تمامًا كما حدث مع المسرح.
ربما كان هذا الانحدار وبروزه على هذا النحو الصارخ استكمالًا لمرحلة أخرى سابقة عُرفت بـ”أفلام المقاولات”، ظهرت فى ثمانينيات القرن الماضي.
أصبحت دور العرض السينمائى على موعد، فى كل موسم، مع أفلام ذات محتوى فارغ تمامًا. لا تعرف لقصة الفيلم بداية من نهاية. بعضهم يعمد إلى مغازلة الترند من خلال عناوين صارخة على غرار: “هاتولى راجل”، “البس عشان خارجين”، قبل أن تتدخل الرقابة لتعديل اسمه الإيحائي، وقس على ذلك عشرات الأفلام فى العقدين الأخيرين، وبعضها يعتمد على عرضه خارج مصر، ومن ثم فإن المشاهد المصرى لم يعد فى بؤرة صناع السينما.
الجمهور عاوز كده وشهوة الترند
تحت لافتة: “الجمهور عاوز كدة”، تورط الفن المصري: مسرحًا وسينما وغناءً، فى فخ الابتذال والسقوط. طالما برر منتجون وفنانون تقديم أعمال فنية رديئة تروج للبلطجة وتموج بحوار ساقط وألفاظ بذيئة وعبارات إيحائية، مهَّدت الطريق لظهور جيل من الكتاب والممثلين الذين يعتبرون الفن مرادفًا لنقل بذاءات الشوارع والعشوائيات وجلسات آخر الليل إلى الشاشة الكبيرة. كم إنها امتدت بطبيعة الحال مثلًا إلى الأغنية المصرية، وأغنية “3 ساعات متواصلة” التى كتبها ولحنها عزيز الشافعى وتؤديها “روبي” نموذج صارخ لمعازلة الترند؛ إيًا كانت العواقب.