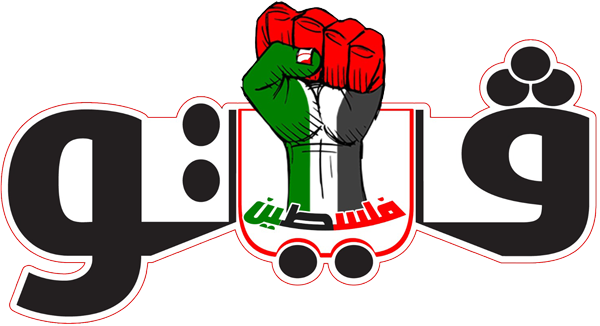تعرف على دور "الصيانة الوقائية" في الحفاظ على المباني والمنشآت الأثرية

أكد محمد مصطفى الباحث الأثرى والحاصل على ماجستير ترميم الآثار والمسجل لنيل درجة الدكتوراه، أن للصيانة الوقائية دورا هاما في الحفاظ على المبانى والمنشأت الأثرية خاصة الآثار الإسلامية التي تتعرض للعديد من قوى التلف المختلفة وخاصة الاستخدام الخاطئ لتلك المنشآت مما يعرضها للتدهور والتلف وفقد العديد من عناصرها الزخرفية والمعمارية.
وأوضح أنه يجب على جميع الجهات المعنية بالحفاظ على الآثار التدخل السريع لإنقاذ المنشآت الأثرية الإسلامية وخاصة التي تم تأهيلها وتوظيفها توظيف خاطئ غير مناسب وملائم للطبيعة الأثرية، مشيرا للدور الفعال لقطاع الآثار الإسلامية حاليا في محاولة منه لإنقاذ وتأهيل المنشآت الأثرية.
وأضاف "مصطفى" أن الصيانة الوقائية للمبانى والمنشأت عرفت منذ قدماء المصريين وهم أول من قاموا بإجراء عمليات الصيانة الوقائية.
وأشار إلى أن مفهوم الصيانة الوقائية كما وضحة الدكتور محمد عبد الهادى أستاذ ترميم وصيانة الآثار جامعة القاهرة، أن القدماء الذين شيدوا أنواعا متعددة من المبانى التي تخدم أغراضا مختلفة سواء دينية أو سياسية أو اجتماعية ما زال بعضها بحالة جيدة والعديد منها تحول إلى أطلال بفضل عوامل وقوى التلف المختلفة هؤلاء القدماء قاموا بأعمال من شأنها الحفاظ على تراثهم العمرانى وذلك بإجراء عمليات استكمال الأجزاء الناقصة أو المفقودة في العناصر الإنشائية أو بتغطية هذه المنشآت بكتل من أحجار ذات خواص جيدة قادرة على مقاومة عوامل التلف المختلفة.
وتابع: "هذه العمليات نعتبرها لونا من ألوان الحفاظ والصيانة الوقائية قبل أن ترى المواثيق الدولية النور بدأ من القرن 19 الميلادي وتحديدا في عام 1970 وذلك من خلال المؤتمرات والندوات التي أقيمت في بعض من الدول الأوروبية حيث ناشد من خلالها المتخصصين بتطبيق الصيانة الوقائية التي اعتبروها تطبيقا".
واستطرد: "الصيانة الوقائية هي الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لكى نمنع أو نحد من التلف الذي يقع على المبنى الأثرى في الوقت الحالى أو في المستقبل وكذلك التنبؤ بحدوث التلف أو وقت حدوثة والقيام بالإجراءات اللازمة لمنعه أو الحد منه بقدر الامكان، يقصد بها أيضا القيام بالأعمال التي من شأنها أن تدرأ الخطر عن المبانى وعناصرها ولذلك فإنها تركز على أعمال المراقبة والمرور الدوري لكل عنصر من عناصر المبنى وعلى فترات زمنية مناسبة بما في ذلك العناصر المستحدثة مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف وذلك بهدف الاكتشاف المبكر لأي خلل أو تلف يمكن أن ينشأ في المستقبل.
ولفت إلى أن عملية نجاح برامج الصيانة للمباني الأثرية تقاس على مدى القدرة على منع التلف غير المتوقع والتي تتم عن طريقها وضع خطط الصيانة الوقائية ثم بعد ذلك الصيانة العلاجية ومن المعروف أن عمليات تطبيق برامج الصيانة الوقائية تفيد في التحكم في تنفيذ أعمال الصيانة بقصد إنجازها وفق خطط زمنية محددة حيث تتمثل في أنشطتها في أعمال الفحص الوقائي بهدف تنظيم وتخطيط أعمال الفحص لمواجهة التلف الذي يمكن أن يحدث كذلك فان اعداد وتحليل البيانات والإحصائيات للتلف الذي يمكن حدوثه أثر في نجاح برنامج الصيانة الوقائية.
وشدد محمد مصطفى على ضرورة اتباع الطرق العلمية لصيانة المباني الأثرية:
1- تسجيل وتوثيق العناصر الانشائية والزخرفية للمبنى الأثري وإجراء الدراسات المورفولوجية والجيولوجية للمنطقة المحيطة ومكان المبنى الأثرى.
2- الدراسة التاريخية والأثرية للمبنى الأثري.
3- تقييم المبنى وتحديد كل عنصر منفرد للمبنى لامكان تحديد مواعيد الصيانة ومتابعة التدهور ويدخل في التقيم كل العناصر المحيطة والعناصر المعمارية والعناصر المكملة.
وكشف مصطفى المراحل الرئيسية لمشروعات الحفاظ والصيانة الوقائية.
• المرحلة الأولى: التوثيق Documentation
مرحلة التوثيق هي مرحلة الرصد الدقيق وإعداد قاعدة البيانات وتقييم عمليات التتبع التاريخى وجمع البيانات والمعلومات وحصر كافة الدراسات التي تمت على الأثر ثم عمليات رصد وتسجيل الوضع الراهن وتحديد المشكلات وأسباب التدهور.
• المرحلة الثانية: مرحلة التحليل Analysis
وهى مرحلة تضم عمليات تحليل البيانات والمعلومات ووضع البدائل التصميم وطرق العلاج بدورها تؤدى إلى مجموعة من التوصيات ومقترحات الحلول كاستراتيجيات للتعامل مع النطاقات المختلفة بهدف الارتقاء بالمنطقة المحيطة ككل وتعظيم الاستفادة من مشروعات الترميم والحفاظ.
• المرحلة الثالثة: مرحلة التعامل والتطبيق Interachion and Applicathon
وفى هذه المرحلة يتم اختيار البديل الأمثل للتعامل مع الأثر ووضع مشروع الحفاظ والترميم المقترح وأن مدخلات التعامل مع النطاق المباشر تركز على دعم فعاليات الترميم والصيانة ومفهوم التطوير وتوفيق الاستخدام كما تتكامل معها بما لا يتعارض مع أهمية الأثر وعلاقته بالمجال المحيط كما أن هذه المفاهيم لا تغفل الجوانب غير العمرانية والمتمثلة في الحياة التابعة للنطاق المحيط وأن توجيهات الحفاظ حاليا في اغلب الاحيان تتعامل مع المناطق ذات القيمة الأثرية بشكل كامل حيث إن الأثر يعتبر جزء لا يتجزأ من المكان الموجود فيه حيث يؤثر فيه ويتأثر به حيث إن أغلب المناطق الاثرية ذات القيمة تقع في محيط حيوى نابض وعمران قائم.