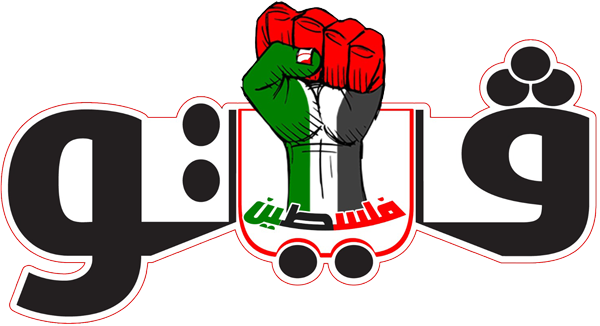كلام في السياسة!
الكلام في السياسة ممل وثقيل، وغالبا ما يذهب أدراج الرياح خصوصا، وأن السياسة صارت مكلمة ووسيلة لاستهلاك الوقت والجهد، ولم يعد أي نقاش سياسي حول أي قضية يُفضي إلى نتيجة أو تغيير رأي أو قناعة أو حتى تصحيح مفهوم خاطئ عند البعض، وهذا يدعونا إلى طرح بعض الأسئلة المهمة التي نغض الطرف عنها أو يمكن القول المسكوت عنها..
* هل لدينا ما يعرف بالسياسي أي من يباشر السياسة بصرف النظر عن النوع؟
* هل لدينا حياة سياسية بمفهومها الصحيح.. بمعني هل لدينا أحزاب تمارس السياسة وتربي وتُعلم وتُنتج كوادر سياسية قادرة على الحركة في المجتمع، والتعريف بنفسها من خلال مؤسساتها الحزبية للسعي نحو السلطة كما يحدث في العالم؟
الحقيقة أن واقع الحال لا يستطيع الإجابة عن هذين السؤالين، وهنا تكمن مشكلتنا الحقيقية، والتي تدفعنا إلى خلط الأوراق وتعميم المفاهيم المغلوطة وتكريسها حتى تستقر في اليقين أنها الصواب، وعليه يتحول معظم المتعاطون مع السياسة إلى نمط غريب فيفعل الشخص منهم الشيء وعكسه، ويدافع عن القيمة ويهدمها، وينادي بما لا يستطيع الالتزام به، وحتى يبدو للغير أنه فاهم ودارس وخبير ومتخصص وعالم ببواطن الأمور يظل متمسكا بما يقول وإن كان خطأ، ولكي يثبت لنفسه ولغيره أنه متابع.. يبحث دائما عن الآراء الشاذة بمنطق خالف تُعرف، ويري أن المعارضة وما تطرحه هي الثواب على طول الخط، وغير ذلك هو الخطأ على طول الخط!
الأمثلة على غياب الفعل السياسي، وغياب الحياة السياسية الحقيقية كثيرة منها على سبيل الحصر.. الحديث عن الديمقراطية الذي لا ينقطع، ومع ذلك تحاول دائما الأقلية فرض رأيها على الأغلبية، وإن لم تستطع تدعو إلى المقاطعة وعدم المشاركة في أي انتخابات أو استفتاءات تحت مبررات واهية ليهدم ركنا مهما من أركان الفعل السياسي، الذي يخلق تراكم الخبرة والتواصل مع المجتمع الذي يسعي للوصول فيه إلى الحكم وتداول السلطة ليبقي المبرر هو.. لا أحد يسمح لهم ولا يعطيهم الفرصة!
ومنها الحديث الذي لا ينقطع عن الشعب، باعتباره السيد وصاحب الحق الوحيد في تقرير ما يراه مناسبا، وفي مصلحته، ومع ذلك نرى البعض يصادر هذا الحق ويفرض وصايته على الشعب، بل يدعوه إلى الانصياع وراء ما يريده هذا البعض.. فقط من أجل المعارضة، وإذا رفض الشعب الانصياع خلف هذه الدعوات يتم اتهامه بالجهل والسطحية، وأنه قاصر ويحتاج وصايتهم، وإذا سار في ركبهم يصبح القائد والمعلم!
هذا البعض يري الشعب -صاحب السيادة- مجرد أداة أو قطعة شطرنج يكسب بها متي شاء ويضحي بها متي يشاء.. هذا البعض دائما ما يتحدث باسم الشعب، ودائما ما يتاجر بورقة الغلابة منه ويرفع رايتهم صباحا ويغرق هو في الملذات ليلا، يتحدث عن فقرهم أمام الشاشات وفي منصات التواصل، وبمجرد أن ينتهي من بيع سلعته الرديئة يذهب ليطمئن على مكاسبه وحساباته.. إحتراف لعبة التناقض مؤهلات لا يحصل عليها غيرهم!
ومن الأمثلة أيضا على غياب الحياة السياسية والسياسي أننا بعد أحداث يناير انفجرت ماسورة الأحزاب وأغرقت الوطن بما يزيد على مائة حزب بين العائلي والكرتوني وحزب الصحيفة، وحزب المقر الواحد، وحزب اللافتة المعلقة على حائط عمارة، وحزب الوجاهة، وحزب جمع التبرعات، وحزب التمويل، وحزب من ليس له حزب.. طرحت هذه الأحزاب لنفسها أسماء ارتبط نصفها بمسمي الثورة والنصف الثاني بشعارات الحرية والخبز والإصلاح والتنمية والفنكوش أيضا، ولو كان لدينا أدنى قدر من المصداقية أو الرغبة في إقامة حياة سياسية لتحقق ذلك ولو كان بالقدر اليسير!
ولأن البعض-سواء كان كثيرا أو قليلا– تحول إلى الشيء وعكسه، أو اقتنع بالفكرة وهدمها، أو آمن بالحق وسقط في الضلال، أو ادعي العلم وهو يجهل ما حوله، أو رأي الحقيقة وسعي خلف السراب فإن ذلك كله يرجع إلى غياب الإجابة على ما طرحته من أسئلة في صدر المقال، وتبقي التجربة وتراكم خبرات التعلم والممارسة هي التي تخلق المجتمع المتطور في كل مناحي الحياة.
أما الجلوس على الجسر وإلقاء المحاضرات في فنون العوم دون النزول إلى المياه ومشاركة من يسبحون فيها لن يفيد شيئا وسيظل الكلام مجرد كلام حتى وإن كانت المبررات لا حصر لها.. من السهل أن تجلس في خندق المعارضة، وتلقي على خصمك في كل ثانية حجر، ومن الصعب أن تجلس في نفس الخندق وتضع كل ساعة حجرا فوق حجر لتصنع بناءً قويا يبهر خصمك فتكون شريكا له.