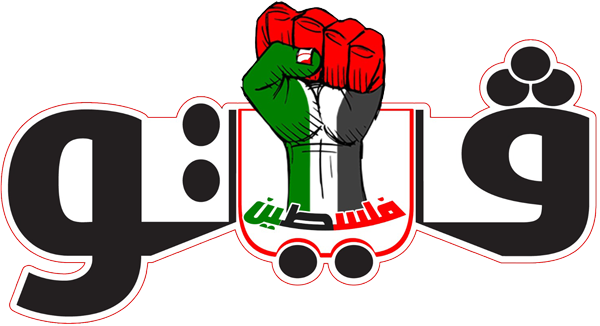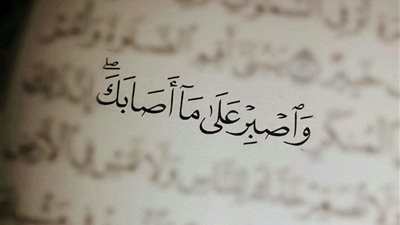أحمد السرساوي يكتب: محمود عوض كرَّس حياته للكتابة عن إسرائيل فوجد سفارتها بجواره.. امتلك اعترافات عبد الحليم حافظ الخاصة مُسجلة بالصوت.. ولكن أين ذهبت بعد وفاته؟

تحل هذه الأيام الذكرى الـ 16 لرحيل الكاتب الصحفى الكبير محمود عوض، أو “عندليب الصحافة” كما أسماه الكاتب والروائى العملاق إحسان عبد القدوس، عندما كان الاثنان يعملان بجريدة “أخبار اليوم” الأستاذ إحسان رئيسا للتحرير، والأستاذ محمود نائبا له.
محمود عوض لم يكن مجرد كاتب موهوب تميز قلمه بالرشاقة والجاذبية والقدرة على الإمتاع، بل كانت حياته مليئة بالمفارقات والأحداث والوقائع والشخصيات التى وضعها القدر فى طريقه، أو قاده هو نحو طريقها ليتشابك معها ويتفاعل بها، وكأنها حياة أقرب وأغرب من الدراما، وليس أدل على ذلك من درامية يوم رحيله، ودرامية مواقفه وشخصيته، كما سنكتشف بعد قليل.
كتب عوض عشرات الكتب ومئات المقالات، وكتب الحوار الصحفى على طريقته الخاصة، التي تمزج بين الحوار و”الفلاش باك” الذى يقدمه للقارئ عن الشخصية التى يحاورها، فكأنه يعرض فيلما وثائقيا على صفحات الجريدة.
نعود لتسميته بـ”عندليب الصحافة” ولها قصة طريفة، والسبب فيها أن الأستاذ إحسان كان، يقرأ حوارا كتبه الأستاذ محمود فى الصفحة التى خصصها رئيس التحرير لإجراء حديث أسبوعي مميز مع شخصية تكون تحت أضواء الأحداث، كان اسمها “شخصيات”، فلما قرأ الأستاذ إحسان سلاسة الحوارات، ورشاقة عباراته السريعة القصيرة المنطلقة كالرصاص، قال لنائبه بطريقة قاطعة: أنت لا تكتب حوارات، وقبل أن يفتح عوض فمه مندهشا من تعليق الأستاذ إحسان.. تابع رئيس التحرير: أنت تغرد يا عندليب.
أطلق الأستاذ إحسان هذه الدعابة منذ ما يزيد على 50 سنة، وهو لا يعرف أن “التغريد” سيكون ضمن مستقبل ما عرفناه باسم “التواصل الإلكتروني” أو “الاجتماعي”، وأنه سيكون صاحب حقوق الملكية فى هذه الكُنية التى أصبحت عالمية.
بداية الحكاية
لهذه الواقعة حكاية يرويها الأستاذ عوض فى مقدمة كتابه الشهير “شخصيات” قائلا: حدث هذا منذ سنوات.. استدعانى إحسان عبد القدوس، رئيس التحرير الذي أعمل معه فى جريدة “أخبار اليوم”، وقال لى: ممكن تفكر فى موضوع تكتب عنه فى الصفحة الأخيرة هذا الأسبوع ؟!
قلت محاولا تذكيره: إن كاتبها الثابت هو أنيس منصور.
رد إحسان: أعرف ذلك.. ولكننى أريدك أن تكتبها هذا الأسبوع.
قلت: لماذا؟
رد إحسان: لأن أنيس اختفى، ولا أدرى أين هو الآن.. ولا متى سيرسل مقاله الأسبوعي.
قلت له: صحيح أن اليوم هو موعد تسليم مقالات الصفحات الثابتة من الجريدة.. ولكن أنيس دقيق فى مواعيده كساعة سويسرية.. وربما نستطيع انتظار مقال أنيس حتى صباح الجمعة.
فقد إحسان أعصابه لأول مرة منذ عشر دقائق.. ورد فى عصبية:
أنا هنا رئيس عمل، ولست زعيم قبيلة! أريد مقالا منك للصفحة الأخيرة غدًا..
بالطبع إحسان رئيس عمل.. ولكنه يتعامل معى بالحب.. وليس بالسلطة!
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأفكار لا تأتى للكاتب بقرار من رئيس التحرير.. حتى لو كان هذا الرئيس هو إحسان عبد القدوس! إن إحسان بالنسبة لنا لم يكن أبدًا “رئيسًا للتحرير”، كان إحسان هو الصديق والأخ الأكبر والأب وحامل همومنا.. لقد خرجت من مكتب إحسان مباشرة إلى منزل أم كلثوم!
وفى اليوم التالى عدت لإحسان بمقال عن أم كلثوم، لكى يرسله إلى المطبعة فورًا، وينشر فى العدد الذى صدر بعد يومين من أخبار اليوم!
فى الأسبوع التالى تكررت نفس القصة، ولكنى فى هذه المرة كنت أكثر تصميمًا على مقاومة رئيس التحرير.
قلت لإحسان: أنت تفهم أن مقالات الصفحة الأخيرة من أخبار اليوم كانت دائمًا محجوزة للمخضرمين من الكتاب. إننى أشكرك على كل ثقتك في.. وأرجوك فى نفس الوقت أن تعفينى من كتابتها.. على الأقل لأننى أنا الآخر أريد أن أستمتع بمقال لأنيس منصور، وأنيس من قلائل كبار الكتاب، الذين يجرى القارئ وراءهم بحب وشوق ومتعة.
رد إحسان ضاحكًا: خير.
فى اليوم التالى عدت له بمقال عن طه حسين - وللمرة الثانية - نشره إحسان فى الصفحة الأخيرة، ثم.. ظهر أنيس منصور، بعد اختفائه فى الإسكندرية لمدة أسبوعين. فى هذه المرة كنت أول من نقل الخبر إلى إحسان.. ثم استدرت خارجًا من مكتبه.
نادانى إحسان متسائلا: إيه رأيك تكتب صفحة عن الشيخ الباقورى؟
قلت: أى صفحة؟
رد مبتسمًا: أنت تكتب.. وأنا أنشر!
قلت: ما الذى تريدنى أن أكتبه عن الباقورى؟
تساءل إحسان فى عصبية: من الذى يكتب، أنا.. أم أنت؟
خرجت من مكتب إحسان غير متحمس، لا للكتابة، ولا للباقورى. وظل هذا هو حالى إلى أن حان موعد تقديم المقال.. وبينما أنا فى حالة اختفاء كاملة عن إحسان وعن أخبار اليوم.. عثر علىّ مصور زميل فى الجريدة وصاح متحمسًا بمجرد أن رآني:
أنت فين؟ الأستاذ إحسان كلفنى بأن أذهب معك إلى الشيخ الباقورى لكى أصوره بمناسبة المقال الذى ستكتبه هذا الأسبوع!
قلت له: ولكننى لم أكتب أى شيء
رد المصور مذعورًا: لا تكسفنا مع إحسان وحياة أبوك.. لقد علمت منهم فى الجريدة أنهم حجزوا صفحة خالية تمامًا من الإعلانات لنشر هذا الموضوع.. صفحة غير الأخيرة
هنا سألته بحماس: تقدر تعمل صورة كبيرة؟ على خمسة أعمدة أو ستة مثلا؟
رد: يا ريت..
فى هذا اليوم بدأ إحسان اجتماعه الأسبوعى معنا بسؤال من جانبه: ما رأيكم فى هذه الصفحة الجديدة؟ أنا قررت أن تكون بابًا ثابتًا بعنوان تحلیل شخصیات.. أو - من باب الاختصار - نسميها (شخصيات) ونظر إلىّ إحسان ضاحكًا وهو يقول: الصفحة دى عهدتك!
بدأت أختار الذين أكتب عنهم.. كان كل شخص يمثل بالنسبة لى معنى أريد أن أقوله، وبقدر إحساسى بالمعنى.. كان يأتى انفعالى بالشخص، بعضهم كان الانفعال يبدأ معه بالاختلاف إلى اختلاف.. وبعضهم بالموافقة التى تتحول بعد الفحص إلى اختلاف.
السفارة فى العمارة بجد
كرّس الأستاذ محمود عوض القدر الأكبر من كتبه ومقالاته للحديث عن قضية العرب المركزية والدفاع عن فلسطين، وكشف حقيقة المشروع الاستعمارى للمحتل.. ففوجئ ذات يوم بأن سفارة هذا المشروع تحتل الأدوار العليا من البناية التى يسكنها، فأصيب بنوبة قلبية!
وربما كانت هذه المفارقة هى البذرة التى استمد منها الزميل يوسف معاطى فكرة فيلمه المدهش “السفارة فى العمارة” إنتاج سنة 2005، بطولة النجم عادل إمام، وإخراج عمرو عرفة.
عوض، الصحفى النابه الذى امتلك ثروة نادرة لم يسع أحد لاكتشافها أو البحث عنها بعد رحيله، وهى اعترافات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ التى خصه بها مسجلة بالصوت، على شرائط التسجيل الكبيرة “شرائط الريل” التى كانت مشهورة فى ستينيات القرن الماضي، ومنها تطورت فكرة شرائط الكاسيت الصغيرة، وذلك باعتبار عوض أحد أعز خلصائه وأصدقائه، فأمْنّه عليها.
خطورة هذه الاعترافات أنها تفشى أدق تفاصيل حياة عبد الحليم حافظ الشخصية، وقصص حبه الثلاث، التى لم يعرف أحد عنها شيئا، وأشهرها بالطبع قصة حبه الكبير، وارتباطه بالسندريلا سعاد حسني.. متى بدأت؟ وكيف انتهت؟
وقبل أن نعود لاعترافات العندليب الأسمر وما جاء فيها.. نرجع قليلا لمسألة الصدر الذى قتل الأستاذ محمود عوض قبل أن نتجاوزها، ولها قصة طريفة.. فمن المعروف عنه أنه كان مُدخنا شديد الشراهة، كان يعصف بنحو أربع أو خمس علب سجائر فى اليوم، بحيث كانت السيجارة تلاحق الأخرى فى فمه، لا يتوقف عنها إلا أثناء وجباته القليلة، أو نومه القلق، لدرجة أنه كتب منتصف التسعينيات عدة مقالات فى جريدة الحياة اللندنية، وفى مجلة الشباب الصادرة عن الأهرام، يتغزل فيها بالسيجارة، للحد الذى أسمى مقالته عنها فى الشباب “الجميلة التى قتلتني” كأنه يتغزل فى امرأة جميلة أحبها فكانت سببا فى دماره، محذرا الشباب فى نهاية المقال من خطورة التدخين وعواقبه، وأنه ليس إلا حبا مُدمرا.
كلام فى ورق سوليفان
كانت المقالة جميلة وشيقة، وغنية بالمعلومات فى عبارات من السوليفان، رغم موضوعها الجاف، فأفرد لها الأستاذ عبد الوهاب مطاوع رئيس تحرير الشباب وقتها صفحتين متقابلتين من المجلة.
والمثير هنا.. أنه رغم تحذيرات الأستاذ عوض للشباب من التدخين وآثاره، إلا أنه لم ينقطع عن شراهته المعهودة، حتى تمكن المرض تماما من رئتيه، وكنا فى نهاية التسعينيات، ومازاد من وطأة التعب عليه، أنه كان ممنوعا من الكتابة فى معشوقته “اخبار اليوم” التى صنعت له مجده الصحفي، وحقق لها عشرات الخبطات الصحفية، وذلك لخلافات مع رئيس تحرير الجريدة وقتها، الأستاذ إبراهيم سعدة، وكانت هذه المسألة تؤلم الأستاذ عوض كثيرا، رغم شهرته الكبيرة، وتهافت كبرى الصحف المصرية والعربية لكى يكتب لها ولقرائها، لكنه كان دائما متعطشا للكتابة فى بيته “أخبار اليوم”.
كنت دائم الاتصال به وفاء له، وحبا فى قلمه وشخصيته، وأحيانا كنا نلتقى على فنجان قهوة أو كوب من الشاى الساخن، فكان يُعبر عن غُصته بابتعاده عن جريدته، ويقول إنه سمكة أخرجوها من بحرها، لكنها قادرة على العيش فى النهر. واستمر الحال هكذا حتى اتصلتُ به عصر أحد أيام يونيه 2005 فوجدتُ صوته خافتا واهنا يكاد يلتقط الأنفاس، وأخذ يكح وهو يدخن سيجارته فطلبت منه أن نذهب حالا للطبيب، وقلت له أنا ارتبط بصداقة عميقة مع د.محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، سأتصل به وأعاودك.
أغلقتُ الخط واتصلت فورا بالعالِم د.محمد عوض تاج الدين المعروف بإنسانيته العالية، لأجد د.عوض يرد على الخط بابتسامته المعهودة: أنت فين يا أستاذ أحمد؟ شرحت له الحالة سريعا، فأجابنى أنه بأحد مستشفيات مصر الجديدة وأنه ينتظرنا.
أغلقت الخط وطلبت الأستاذ محمود عوض، وذهبت إليه فى الحال وركبنا السيارة وانطلقنا إلى مصر الجديدة.. فى الطريق أردت الابتعاد عن الحديث فى المرض، فسألته عن أشياء يحبها، منها لماذا لم يكتب عن صداقته العميقة مع العندليب الأسمر؟
قال لى سأطلعك على سر، هل تعرف جهاز الإسطوانات الموجود فى مكتبتى (كان الأستاذ محمود عوض يحتفظ بالفعل بجهاز “بيك آب” لتشغيل الأسطوانات الموسيقية القديمة، وكان موجودا فى مكتبته بجوار جهاز المسجل لتشغيل شرائط الكاسيت) فقلت: نعم، قال: خلف البيك آب هناك 3 شرائط تسجيل “ريل” طويلة، طول كل منها يتجاوز 3 ساعات، بصوت عبد الحليم، وهو يحكى لى على مدى شهور أدق أسرار حياته.. كان حليم بإحدى نوبات مرضه، وأراد أن يبوح لى كصديق، أو كأحد من أهله، لأن كلانا من جذور ريفية، هو شرقاوي، وأنا كما تعلم دقهلاوي.. لم يبح عبد الحليم بتلك “البلاوي” لى باعتبارى صحفيا، وهو مطرب مشهور، بل باعتبارى أخاه كما كان يقول لي.
صمتَ لحظة ثم أكمل: كل تلك التسجيلات تمت فى بيت حليم بالزمالك، وعلى جهاز التسجيل بتاعه، حتى انتهى من سرد كل الحكايات، وتكونت كل هذه الشرائط الموجودة خلف البيك آب.
تسجيلات لم ترَ النور
سألتهُ: ألم يحن الوقت للإفراج عن مكنون هذه الشرائط؟ أو بعضها على الأقل؟ فالتفت لى فجأة بكامل جسمه بعدما كان جالسا بجانبى ووجهه للأمام، وقد ظهرت على وجهه علامات الانزعاج قائلا فى استهجان: أتريد أن أخلف وعدى مع حليم يا سرساوي؟ (هذا هو الاسم الذى ينادينى به الأصدقاء).. رددت سريعا: لا أقصد ولكن أنت تعرف كم يتلهف الناس لسماع أى جديد عن حليم.
ثم ران الصمت بيننا إلى أن وصلنا إلى مصر الجديدة للقاء طبيب الصدر العالمى د. عوض تاج الدين، الذى استقبلنا مداعبا الصحفى الكبير، قائلا له: محمود عوض ومحمد عوض ده كدة إحنا قرايب.. ففى لحظة أذاب بمهارة فائقة جليد لحظات التعارف الأولى، بنفس مهارته الطبية، ثم أخذ فى إجراءات الكشف على الصدر، وبعد حوار تضمن أسئلة عن متاعبه الصحية؟ وكم سيجارة يدخن فى اليوم؟ وإجابات سريعة من المريض كأنه يكتب مقاله.. هنا ألقى د. محمد عوض تاج الدين قلمه على المائدة، وقال له دعنا نتكلم بصراحة.. عليك الاختيار بين حياتك وأول سيجارة قادمة، لأن هناك طبقة من الشمع الأسود تغطى رئتيك من التدخين، ولا تسمح لأى منهما بالتقاط أى نسبة من الأكسجين.
فما كان منه إلا مد يده اليمنى إلى جيب قميصه وأمسك باقى علبة السجائر القابعة فيه، ثم هرسها بين أصابعه وألقى بها فى سلة المهملات الصغيرة بجانبه، وسط حفاوة الطبيب العالمى وابتسامنا جميعا.
أخذنا روشتة العلاج وكأن روحا جديدة دبت فى الكاتب الكبير بعد أن ارتفعت معنوياته من كلام الدكتور محمد عوض تاج الدين.
استثمرت أجواء معنوياتنا العالية لأعرف على الأقل ما تضمه كل هذه الثروة من التسجيلات أو الاعترافات بصوت العندليب، والتى يرفض صديقه الصدوق الكشف عما بها حتى بعد كل هذه السنين التى مرت، فقلت له: بماذا تفسر تسابق بعض المحيطين الآخرين بعبد الحليم من أصدقاء وصحفيين بالكلام عن علاقة العندليب بالسندريلا خاصة بعد حادث مقتلها؟
فقال لي: ربما لم يستأمنهم حليم على أسراره، وربما لم يأخذ منهم عهدا بالحفاظ عليها كما حدث معي.. تعرف يا أحمد مجرد إن حليم طلب منى الاحتفاظ بهذه الشرائط كأمانة عندى هو دين فى عنقى لهذه الثقة التى لن أفرط بها أبدا، خاصة أنه لم يطلب منى كتابتها أو تفريغها، هو سلمها لى باعتبارى أخاه، وليس بصفتى المهنية.
السمراء والأميرة
سألته: هل الشرائط بها أشياء لا نعرفها بخلاف قصة زواجه من السندريلا؟ قال: لا تلعب معى لعبة الصحفى يا أستاذ، لكننى سأريحك ببعض الرتوش، منها قصة حب جمعت حليم مع إحدى كريمات العائلات الملكية العريقة، فى دولة من شمال أفريقيا، لكنها لم تكتمل لأن حليم كان قد دخل فى مرحلة المتاعب الصحية الكبيرة، وهناك أيضا قصة حب أخرى مع سمراء مصرية جميلة قبل قصته مع السندريلا بسنوات.
لكن أهم ما جاء بالاعترافات لم تكن غراميات العندليب، ولكن علاقته برجال ثورة يوليو 1952، والزعيم جمال عبد الناصر، ثم بالرئيس السادات بالرغم من اختلاف الخط السياسى بينهما، فحليم كان يعشق عبد الناصر، وبنفس الوقت يحمل تقديرا وإعجابا خاصا بالرئيس السادات، وكان صادقا أشد الصدق عندما غنى لكليهما.
السؤال الآن: أين ذهبت هذه الشرائط بعد وفاة عندليب الصحافة الأستاذ محمود عوض؟
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا