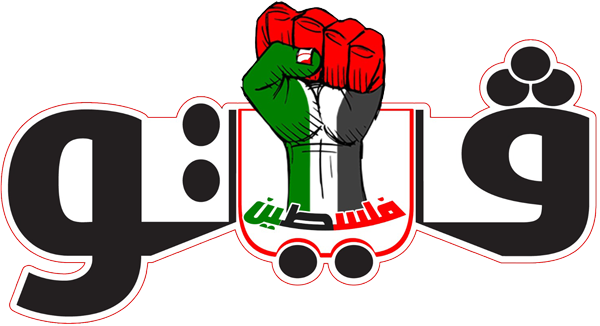من «محفوظ» و«الحكيم» إلى «ماركيز» و«همنجواي».. إجابة «سؤال الحب»

ما بين الرغبة في المعرفة، والشعور الذي يولد من رحم الموقف، والخبرة السابقة، تدور عملية الكتابة، أو هكذا يتعامل البعض معها، ومن هنا كان «سؤال الحب» لصاحبه الكاتب العراقي علي حسين، واحدًا من المؤلفات التي تلقي الضوء على الجانب الخفي في حياة الكُتاب والمؤلفين، وتكشف جزءً من حياة الكاتب الشخصية، ومواقفه من «مسألة الحب»، ليس هذا فحسب، لكنه يحاول الربط بين العلاقات التي نسجها الكاتب على الصفحات وتلك التي كانت في حياته الشخصية، وهو رابط يستحق التركيز عليه، لا سيما وأن غالبية الكُتاب يذهبون إلى تخليد وخط جزء من حياتهم مع حياة أبطالهم.. وفي التقرير التالي نجيب عن «سؤال الحب» عند أربعة من أشهر الكتاب، اثنان منهما مصريان، والثالث كولومبي، والرابع أمريكي.

نجيب محفوظ.. الحب «سر مغلق ولا يزال مغلقًا»
بدأت علاقته بالمرأة في سن مبكرة، ففي سنوات طفولته التي أمضاها في حي الجمالية، وهو أحد أحياء القاهرة القديمة، في ذلك الجو عاش نجيب محفوظ أول قصة حب حقيقية في حياته، ويروي لرجاء النقاش في صفحات من مذكراته أنه: «كان على أعتاب مرحلة المراهقة عندما شدته تلك الفتاة، وجه ساحر يطل من شرفة أحد البيوت»، ولم يكن يتجاوز الخامسة عشرة من عمره فيما كانت هي تقترب من العشرين، فتاة جميلة من أسرة معروفة، لها وجه أشبه بلوحة «الموناليزا» ظل حبه لها من بعيد ومن طرف واحد، لم يجرؤ يومًا على محادثتها أو الاقتراب منها، أو حتى لفت اهتمامها، كان حبًا صامتًا، يكتفي صاحبه بمجرد النظر إلى هذه اللوحة الجميلة التي تطل عليه بين الحين والآخر: «وعرفت كيف يغيب الإنسان وهو حاضر، ويصحو وهو نائم، كيف يفنى في الوحدة وسط الزحام ويصادق الألم». قصة الحب الأولى هذه سنجد ملامحها واضحة من خلال شخصية كمال عبد الجواد في الثلاثية.
اهتم نجيب محفوظ بفلسفة الحب منذ كتاباته المبكرة، ونراه في مقال نشر عام 1934 بعنوان «فلسفة الحب» بتشجيع من أستاذه سلامة موسى، يتبنى أفكار الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون عن مفهوم الشعور بالحب، كان عمره آنذاك ثلاثة وعشرين عامًا، وفي المقال يحدثنا «محفوظ» عن الحب الذي هو في نظره مشاعر لا يمكن تحديدها، فالحب هو أول الأشياء وآخرها، وهو الذي يُسير الأشياء جميعًا: « الحب هو تلك النسمة الحية التي تشيع في جميع الكائنات الحية، نبصرها في تآلف الخلايا وتجاذب الأطيار وتزاوج الإنسان، وقد يكون من الحكمة – إذا رغبنا أن نزكي إحساسنا به أو نسمو بعواطفنا فيه – أن نقصد جماعة الشعراء أو نصغي لأناشيدهم، وقد وهبهم الله من طاقة الإحساس بهذه العاطفة وغيرها ما يبلغهم مناهم من تصوير العواطف العميقة، حيث يقف العقل حائرًا مترددًا.. فما علاقة الفلسفة بالحب الحق؟ إن أي فلسفة هي وجهة نظر يفسر بها الفيلسوف مختلف الحقائق، ولما كان الحب أحد هذه الحقائق، فللفلسفة رأيها عنه، أو قل فللفلسفات المختلفة آراؤها المختلفة عنه، فواجب علينا نحو أنفسنا أن نعرف هذه الآراء. نعم إن الحب عاطفة ولكن المعرفة التامة للعاطفة لا تتطلب فقط إحساسنا بها وإنما يجب أن يضاف إلى ذلك امتحان وتكييف العقل لها حتى تملأ حقيقتها القلب والعقل، فيظهر العارف بمتعة الظافر بالنور بعد التخبط في الظلام، ويحس إحساس المطئن بعد التردي في مهاوي القلق والشك».

ويكتب نجيب محفوظ في مذكراته التي حررها إبراهيم عبد العزيز بعنوان «أنا نجيب محفوظ»: « الحب إن لم ينته بالزواج يخفت ويتوارى ولكنه يطل من الذاكرة بين الحين والآخر، ولقد صوّرت قصتي مع الحب في العديد من رواياتي، واستطيع أن أقول أن ما كتبته في (قصر الشوق) يمثل جوهر تلك القصة، فحين يصل الإنسان إلى سن الحب يخيل إليه أنه وقع في حب كل جميع يصادفه، حتى يأتي شيء يفهمه أن الحب غير كل ما قلت، أما لماذا اتجه الحب إلى هذا الشخص بالذات دون شخص آخر فهذا سر مغلق ولا يزال سرًا مغلقًا حتى الآن».
«ماركيز» و«ميرثيدس».. ليست الأولى لكنها الأخيرة

هل كانت «ميرثيدس» أول حب في حياة جابريل جارسيا ماركيز؟.. في مذكراته «عشت لأروي» يحدثنا صاحب مئة عام من العزلة عن امرأة أخرى اسمها مارتينا فونسيكا كانت هي حبه الأول، تعرف عليها عندما كان مراهقًا في الخامسة عشرة من عمره، وكان هي متزوجة، طاردها بالرسائل فقررت أن تضع حدًا لطيشه خوفًا من الفضيحة، لكنه بعد سنوات، عام 1954 يسمع صوتها عبر الهاتف ويقابلها في إحدى المقاهي، ويفاجأ بملامح تقدم السن الواضحة على وجهها، وتسأله إن كان لا يزال يشتاق إليها: «عندئذ أخبرتها بالحقيقة، وهي أنني لم أنسها قط، لكن وداعها كان قاسيًا جدا غير من وجودي»، وأخبرته أنها كانت تريد أن تطمئن على أحواله، ويخبرها بأنه كان يشتاق إلى رؤيتها.
في عام 1958 كان «ماركيز» يعيش في كاركاس، عاصمة فنزويلا، صحفي لامع، روايته «ليس للكولونيل من يكاتبه» نجحت نجاحًا كبيرًا، حتى إن الصحافة الفرنسية اعتبرتها واحدة من أنجح الروايات وشبهتها براعة أرنست همنجواي «الشيخ والبحر»، كانت «ميرثيدس» لا تزال تنتظره في كولومبيا، وفي يوم مشرق قال لصديقه بلينو ميندوثا وهما يجلسا في إحدى حانات كاراكاس بعد أن أطال النظر إلى ساعته: «تبًا.. ستفوتني الطائرة» فسأله بلينو.. إلى أن ستذهب؟ فيجيب وينهض: سأتزوج.
توفيق الحكيم والحب.. «كمن يغني في الظلام طردًا للفزع»

لم تشغله حياة الطبقة الأرستقراطية التي تعيشها عائلته، وإنما شغلته حكاية غرفة الست زنوبة، ومنديل سنية الذي تحايل حتى أخذه واحتفظ به في «عودة الروح»، ولم يدخر وسعًا في الابتعاد عن المرأة التي كان يخشى أن يعيش معها قصة حب فاشلة، مثل تلك المرأة التي قرأ عنها في روايات شارلز ديكنز: قرر أن يكرس نفسه لدور واحد فقط هو دور الفنان الذي يطرد من عقله كل شيء إلا الفكر والفن والثقافة، ولم يكن يدرك أن باريس ستكشف أمامه ألوانًا جديدة من الحب، الفرنسيون الذي استأجر منهم غرفة صغيرة أطلقوا عليه اسم «عصفور من الشرق»، كانوا يرونه شابًا خياليًا، وهذا الخيال جعله يعشق فتاة لم يرها سوى مرة واحدة، تبيع التذاكر في مسرح الأوديون يكتب عنها: «أراها تشرق كل مساء بعينين فيروزتين جميلتين وابتسامة ساحرة»، لكنه حائر لا يريد أن يتقدم منها، وحين ينصحه صديقه أندريه بأن يقدم لها باقة من الزهور ويفاتحها بما في نفسه من مشاعر، يرفض ويقول له: «يا عزيزي أندريه، ما زال في رأسي قليل من الإدراك يكفي لإفهامي على الأقل أن مثل هذا الجمال في شباك مفتوح للجمهور، لا يمكن أن يبقى حتى الآن في انتظار قدوم هذا الصعلوك الشارد الذي هو أنا. ويسأله أندريه: كيف عرفت أنها تحب شخصًا ما؟.. الفراسة.. ولا يمكن لأندريه إلا أن يصرخ به: الفراسة.. هذا بابها، وهذه هي جالسة، أكاد أراها من هنا، أقسم أنني لم أر مثل هذا في حياتي.
في رسالة يوجهها إلى صديقه أندريه يكتب توفيق الحكيم: «إن الحب قصة لا يجب أن تنتهي.. إن الحب مسألة رياضية لم تحل.. إن جوهر الحب مثل جوهر الوجود لا بد أن يكون فيه ذلك الذي يسمونه المجهول أو المطلق، إن حمى الحب عندي هي نوع من حمى المعرفة واستكشاف المجهول والجري وراء المطلق، ماذا يكون الوجود لو أن الله قذف في وجوهنا نحن الآدميين بتلك المعرفة أو ذلك المطلق الذي نقضي حياتنا نجري وراءه؟ لا أستطيع تصور الحياة حينئذ.. إنها ولا شك لو بقيت بعد ذلك لصارت شيئا خاليًا من كل جمال وفكر وعاطفة.. فكل ما نسميه جمالًا وفكرًا وشعورًا ليس إلا قبسات النور التي تخرج أثناء جهادنا وكدنا وجرينا خلف المطلق والمجهول».
وفي كتابه «زهرة العمر» الذي تضمن مجموعة من الرسائل كتبها بالفرنسية لصديقه أندريه، يعترف «الحكيم» بهزيمته أمام الحب، حيث يقول: «صدقت فراستك، الخيال أضاعني يا أندريه، أنا شخص شقي وليس الشقاء هو البكاء، وليست السعادة هي الضحك، فأنا أضحك طوال النهار لأني لا أريد أن أموت غارقًا في دموعي، أنا شخص ضائع مهزوم في كل شيء. وقد كان الحب هو آخر ميدان، وخسرت فيه، وإذا كنت تسمع من فمي أحيانًا أناشيد القوة والبطولة، فاعلم أني أصنع ذاك تشجيعًا لنفسي، كمن يغني في الظلام طردًا للفزع».
همنجواي.. «هناك ما هو أفضل من الموت!!.. أن نموت حبًا»

في مارس عام 1918 رست سفينة حربية في ميناء بوردو الفرنسي، كان على متنها خليط من الجنود، تطوّع معظمهم للقتال إلى جانب فرنسا في حربها ضد ألمانيا، كانوا من جنسيات مختلفة، بريطانيون أمريكيون وأستراليون والبعض جاء من كندا، وبين هؤلاء الجنود كان هناك فتى لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، قال للضباط وهو يسأله لماذا تطوعت: أريد أن أمارس اللعب ضد الفريق الألماني الخصم.
كان قد تطوع للعمل سائق سيارة إسعاف، أمضى ليلته الأولى في الميناء الفرنسي، ليجد نفسه في اليوم التالي بالقرب من خنادق المعركة، ولم يمض سوى ثلاثة أيام في عمله حتى انفجرت بالقرب منه قذيفة قتلت وجرحت العديد من الجنود، كان نصيبه منها عشرات الشظايا التي استقرت في ظهره وساقه اليسرى، وقد أصر وهو مصاب أن يحمل أحد الجنود الجرحي، مما أدى إلى إصابته بوابل من الرصاص إحداها في ركبته.
في المستشفى الذي نقل إليه سائق الإسعاف أرنست ميلر همنجواي، أصبح محط إعجاب الجميع، فهذا الفتى الأشقر الوسيم كان دائم الانشغال بالقراءة والكتابة، لم تفارقه رواية «قلب الظلام» لجوزيف كونراد، هذه الرواية بالنسبة إليه تلخص هدفه من الحياة: «الإخلاص المدقق لحقيقة أحاسيسنا العاطفية».
ذات يوم اقتربت منه ممرضة شابة سمراء مشرقة الوجه، تعلق بها معظم المرضى، لكنها أغرمت بالفتى الأمريكي الأشقر.. ألا تكف عن القراءة أيها الفتى؟ قالت له وهي تبتسم.. أحب القراءة، هذه العادة أخذتها عن أمي التي كانت تحمل معها الكتاب أينما ذهبت، وأنا أيضا أدس الكتب في جيبي لأقرأ في أي مكان وفي أي وقت، وأطمح إلى أن أصبح كاتبًا.. لكن يبدو أنني لن أتمكن من ذلك.. بالأمس كتبت مجموعة من الأوراق، مشروع لقصة طويلة أتمنى أن تطلعي عليها.
مد يده إلى تحت الوسادة ثم أخرج رزمة من الورق، وبدا قلقًا كأنما يمر بامتحان، قال للممرضة الجميلة أنيسس فون كورسكي: أريدك أن تقرأي شيئا، قد يكون مملًا، لقد قرأها أحد الجنود المرضى وقال لي إن شعر جلده انتصب من فرط الإثارة، وآمل ألا يكون الحمق قد بلغ بي حدًا أتصور أن كلام هذا الجندي يدل على أنني كتبت شيئا جيدًا لأن أحدًا قد أعجب بها.
تناولت منه الأوراق وذهبت إلى غرفتها أضاءت المصباح، قلبت الأوراق، كان العنوان مكتوبًا بالحبر الأزرق «حب في الحرب»، كانت حشرات البعوض تتطاير على المصباح وأصوات أنين الجرحى تترامى إلى سمعها، ولكنها شعرت وهي تقرأ الصفحات الأولى أنها تعيش على مقربة من جبهات القتال، وأن بطل هذه الحكاية يشبه كثيرًا الفتى الوسيم صاحب الأوراق، فالملازم هنري شاب أمريكي يقود سيارة إسعاف، وهذه الصفحات المكتوبة بخط دقيق تحكي عن علاقة الحب التي تربطه بالفتاة كاثرين باركلي التي تعمل ممرضة في مستشفى الصليب الأحمر. وتبدأ بينهما علاقة رومانسية.
تتوقف أنييس عن القراءة، قالت لنفسها: هل يعقل أن هذا الأمريكي قد أحبني فعلًا؟، إنها تشاهد ملامحها في شخصية بطلة الرواية كاثرين، تنتبه إلى صوت يناديها، تترك الأوراق على المكتب تذهب باتجاه الصوت، كان أرنست ما يزال مستيقظًا اقتربت منه وهي تقول: يبدو أنك خالي الفكر.. الموت يطاردنا في كل لحظة وأنت تكتب قصصًا عن الحب.
يضحك بصوت عال وهو يقول: «لم تسلبني الحرب سعادتي، لقناعتي أن الحياة نفسها تراجيديا ونهايتها واحدة، لكني أدرك أن بإمكان الإنسان اختلاق شيئا ما، والإبداع بما يكفي من المصداقية، كفيل بجعلك سعيدًا لدى قراءته، لأعيش سعادة لم أعرف مثلها قبل. وإزاؤها تغيب معاني التفاصيل».
-أتعرف.. إذا لم نضحك في هذه الأيام الدموية.. سنموت كمدًا بدلًا من الموت برصاص الألمان.
-هناك يا عزيزتي ما هو أفضل من الموت!! أن نموت حبًا.
-ألم أقل لك أنك خالي القلب يا فتى.
-منذ أن دخل المستشفى كانت أنييس كوفيسكي تهتم به بشكل خاص، ويكتب في إحدى رسائله لشقيقته الصغرى: أحبها.. وأظنها ستكون حبي الأول والأخير.. سأتزوجها إذا قبلت ذلك.. ولماذا لا تقبل.. وهي معي كل الوقت؟!.. بل هي كثيرًا ما تقضي جزءً من الليل على مقعد بجوار فراشي.
------
المصدر: كتاب «سؤال الحب.. من تولتسوى إلى أينشتاين».. علي حسين.

نجيب محفوظ.. الحب «سر مغلق ولا يزال مغلقًا»
بدأت علاقته بالمرأة في سن مبكرة، ففي سنوات طفولته التي أمضاها في حي الجمالية، وهو أحد أحياء القاهرة القديمة، في ذلك الجو عاش نجيب محفوظ أول قصة حب حقيقية في حياته، ويروي لرجاء النقاش في صفحات من مذكراته أنه: «كان على أعتاب مرحلة المراهقة عندما شدته تلك الفتاة، وجه ساحر يطل من شرفة أحد البيوت»، ولم يكن يتجاوز الخامسة عشرة من عمره فيما كانت هي تقترب من العشرين، فتاة جميلة من أسرة معروفة، لها وجه أشبه بلوحة «الموناليزا» ظل حبه لها من بعيد ومن طرف واحد، لم يجرؤ يومًا على محادثتها أو الاقتراب منها، أو حتى لفت اهتمامها، كان حبًا صامتًا، يكتفي صاحبه بمجرد النظر إلى هذه اللوحة الجميلة التي تطل عليه بين الحين والآخر: «وعرفت كيف يغيب الإنسان وهو حاضر، ويصحو وهو نائم، كيف يفنى في الوحدة وسط الزحام ويصادق الألم». قصة الحب الأولى هذه سنجد ملامحها واضحة من خلال شخصية كمال عبد الجواد في الثلاثية.
اهتم نجيب محفوظ بفلسفة الحب منذ كتاباته المبكرة، ونراه في مقال نشر عام 1934 بعنوان «فلسفة الحب» بتشجيع من أستاذه سلامة موسى، يتبنى أفكار الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون عن مفهوم الشعور بالحب، كان عمره آنذاك ثلاثة وعشرين عامًا، وفي المقال يحدثنا «محفوظ» عن الحب الذي هو في نظره مشاعر لا يمكن تحديدها، فالحب هو أول الأشياء وآخرها، وهو الذي يُسير الأشياء جميعًا: « الحب هو تلك النسمة الحية التي تشيع في جميع الكائنات الحية، نبصرها في تآلف الخلايا وتجاذب الأطيار وتزاوج الإنسان، وقد يكون من الحكمة – إذا رغبنا أن نزكي إحساسنا به أو نسمو بعواطفنا فيه – أن نقصد جماعة الشعراء أو نصغي لأناشيدهم، وقد وهبهم الله من طاقة الإحساس بهذه العاطفة وغيرها ما يبلغهم مناهم من تصوير العواطف العميقة، حيث يقف العقل حائرًا مترددًا.. فما علاقة الفلسفة بالحب الحق؟ إن أي فلسفة هي وجهة نظر يفسر بها الفيلسوف مختلف الحقائق، ولما كان الحب أحد هذه الحقائق، فللفلسفة رأيها عنه، أو قل فللفلسفات المختلفة آراؤها المختلفة عنه، فواجب علينا نحو أنفسنا أن نعرف هذه الآراء. نعم إن الحب عاطفة ولكن المعرفة التامة للعاطفة لا تتطلب فقط إحساسنا بها وإنما يجب أن يضاف إلى ذلك امتحان وتكييف العقل لها حتى تملأ حقيقتها القلب والعقل، فيظهر العارف بمتعة الظافر بالنور بعد التخبط في الظلام، ويحس إحساس المطئن بعد التردي في مهاوي القلق والشك».

ويكتب نجيب محفوظ في مذكراته التي حررها إبراهيم عبد العزيز بعنوان «أنا نجيب محفوظ»: « الحب إن لم ينته بالزواج يخفت ويتوارى ولكنه يطل من الذاكرة بين الحين والآخر، ولقد صوّرت قصتي مع الحب في العديد من رواياتي، واستطيع أن أقول أن ما كتبته في (قصر الشوق) يمثل جوهر تلك القصة، فحين يصل الإنسان إلى سن الحب يخيل إليه أنه وقع في حب كل جميع يصادفه، حتى يأتي شيء يفهمه أن الحب غير كل ما قلت، أما لماذا اتجه الحب إلى هذا الشخص بالذات دون شخص آخر فهذا سر مغلق ولا يزال سرًا مغلقًا حتى الآن».
«ماركيز» و«ميرثيدس».. ليست الأولى لكنها الأخيرة

هل كانت «ميرثيدس» أول حب في حياة جابريل جارسيا ماركيز؟.. في مذكراته «عشت لأروي» يحدثنا صاحب مئة عام من العزلة عن امرأة أخرى اسمها مارتينا فونسيكا كانت هي حبه الأول، تعرف عليها عندما كان مراهقًا في الخامسة عشرة من عمره، وكان هي متزوجة، طاردها بالرسائل فقررت أن تضع حدًا لطيشه خوفًا من الفضيحة، لكنه بعد سنوات، عام 1954 يسمع صوتها عبر الهاتف ويقابلها في إحدى المقاهي، ويفاجأ بملامح تقدم السن الواضحة على وجهها، وتسأله إن كان لا يزال يشتاق إليها: «عندئذ أخبرتها بالحقيقة، وهي أنني لم أنسها قط، لكن وداعها كان قاسيًا جدا غير من وجودي»، وأخبرته أنها كانت تريد أن تطمئن على أحواله، ويخبرها بأنه كان يشتاق إلى رؤيتها.
في عام 1958 كان «ماركيز» يعيش في كاركاس، عاصمة فنزويلا، صحفي لامع، روايته «ليس للكولونيل من يكاتبه» نجحت نجاحًا كبيرًا، حتى إن الصحافة الفرنسية اعتبرتها واحدة من أنجح الروايات وشبهتها براعة أرنست همنجواي «الشيخ والبحر»، كانت «ميرثيدس» لا تزال تنتظره في كولومبيا، وفي يوم مشرق قال لصديقه بلينو ميندوثا وهما يجلسا في إحدى حانات كاراكاس بعد أن أطال النظر إلى ساعته: «تبًا.. ستفوتني الطائرة» فسأله بلينو.. إلى أن ستذهب؟ فيجيب وينهض: سأتزوج.
توفيق الحكيم والحب.. «كمن يغني في الظلام طردًا للفزع»

لم تشغله حياة الطبقة الأرستقراطية التي تعيشها عائلته، وإنما شغلته حكاية غرفة الست زنوبة، ومنديل سنية الذي تحايل حتى أخذه واحتفظ به في «عودة الروح»، ولم يدخر وسعًا في الابتعاد عن المرأة التي كان يخشى أن يعيش معها قصة حب فاشلة، مثل تلك المرأة التي قرأ عنها في روايات شارلز ديكنز: قرر أن يكرس نفسه لدور واحد فقط هو دور الفنان الذي يطرد من عقله كل شيء إلا الفكر والفن والثقافة، ولم يكن يدرك أن باريس ستكشف أمامه ألوانًا جديدة من الحب، الفرنسيون الذي استأجر منهم غرفة صغيرة أطلقوا عليه اسم «عصفور من الشرق»، كانوا يرونه شابًا خياليًا، وهذا الخيال جعله يعشق فتاة لم يرها سوى مرة واحدة، تبيع التذاكر في مسرح الأوديون يكتب عنها: «أراها تشرق كل مساء بعينين فيروزتين جميلتين وابتسامة ساحرة»، لكنه حائر لا يريد أن يتقدم منها، وحين ينصحه صديقه أندريه بأن يقدم لها باقة من الزهور ويفاتحها بما في نفسه من مشاعر، يرفض ويقول له: «يا عزيزي أندريه، ما زال في رأسي قليل من الإدراك يكفي لإفهامي على الأقل أن مثل هذا الجمال في شباك مفتوح للجمهور، لا يمكن أن يبقى حتى الآن في انتظار قدوم هذا الصعلوك الشارد الذي هو أنا. ويسأله أندريه: كيف عرفت أنها تحب شخصًا ما؟.. الفراسة.. ولا يمكن لأندريه إلا أن يصرخ به: الفراسة.. هذا بابها، وهذه هي جالسة، أكاد أراها من هنا، أقسم أنني لم أر مثل هذا في حياتي.
في رسالة يوجهها إلى صديقه أندريه يكتب توفيق الحكيم: «إن الحب قصة لا يجب أن تنتهي.. إن الحب مسألة رياضية لم تحل.. إن جوهر الحب مثل جوهر الوجود لا بد أن يكون فيه ذلك الذي يسمونه المجهول أو المطلق، إن حمى الحب عندي هي نوع من حمى المعرفة واستكشاف المجهول والجري وراء المطلق، ماذا يكون الوجود لو أن الله قذف في وجوهنا نحن الآدميين بتلك المعرفة أو ذلك المطلق الذي نقضي حياتنا نجري وراءه؟ لا أستطيع تصور الحياة حينئذ.. إنها ولا شك لو بقيت بعد ذلك لصارت شيئا خاليًا من كل جمال وفكر وعاطفة.. فكل ما نسميه جمالًا وفكرًا وشعورًا ليس إلا قبسات النور التي تخرج أثناء جهادنا وكدنا وجرينا خلف المطلق والمجهول».
وفي كتابه «زهرة العمر» الذي تضمن مجموعة من الرسائل كتبها بالفرنسية لصديقه أندريه، يعترف «الحكيم» بهزيمته أمام الحب، حيث يقول: «صدقت فراستك، الخيال أضاعني يا أندريه، أنا شخص شقي وليس الشقاء هو البكاء، وليست السعادة هي الضحك، فأنا أضحك طوال النهار لأني لا أريد أن أموت غارقًا في دموعي، أنا شخص ضائع مهزوم في كل شيء. وقد كان الحب هو آخر ميدان، وخسرت فيه، وإذا كنت تسمع من فمي أحيانًا أناشيد القوة والبطولة، فاعلم أني أصنع ذاك تشجيعًا لنفسي، كمن يغني في الظلام طردًا للفزع».
همنجواي.. «هناك ما هو أفضل من الموت!!.. أن نموت حبًا»

في مارس عام 1918 رست سفينة حربية في ميناء بوردو الفرنسي، كان على متنها خليط من الجنود، تطوّع معظمهم للقتال إلى جانب فرنسا في حربها ضد ألمانيا، كانوا من جنسيات مختلفة، بريطانيون أمريكيون وأستراليون والبعض جاء من كندا، وبين هؤلاء الجنود كان هناك فتى لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، قال للضباط وهو يسأله لماذا تطوعت: أريد أن أمارس اللعب ضد الفريق الألماني الخصم.
كان قد تطوع للعمل سائق سيارة إسعاف، أمضى ليلته الأولى في الميناء الفرنسي، ليجد نفسه في اليوم التالي بالقرب من خنادق المعركة، ولم يمض سوى ثلاثة أيام في عمله حتى انفجرت بالقرب منه قذيفة قتلت وجرحت العديد من الجنود، كان نصيبه منها عشرات الشظايا التي استقرت في ظهره وساقه اليسرى، وقد أصر وهو مصاب أن يحمل أحد الجنود الجرحي، مما أدى إلى إصابته بوابل من الرصاص إحداها في ركبته.
في المستشفى الذي نقل إليه سائق الإسعاف أرنست ميلر همنجواي، أصبح محط إعجاب الجميع، فهذا الفتى الأشقر الوسيم كان دائم الانشغال بالقراءة والكتابة، لم تفارقه رواية «قلب الظلام» لجوزيف كونراد، هذه الرواية بالنسبة إليه تلخص هدفه من الحياة: «الإخلاص المدقق لحقيقة أحاسيسنا العاطفية».
ذات يوم اقتربت منه ممرضة شابة سمراء مشرقة الوجه، تعلق بها معظم المرضى، لكنها أغرمت بالفتى الأمريكي الأشقر.. ألا تكف عن القراءة أيها الفتى؟ قالت له وهي تبتسم.. أحب القراءة، هذه العادة أخذتها عن أمي التي كانت تحمل معها الكتاب أينما ذهبت، وأنا أيضا أدس الكتب في جيبي لأقرأ في أي مكان وفي أي وقت، وأطمح إلى أن أصبح كاتبًا.. لكن يبدو أنني لن أتمكن من ذلك.. بالأمس كتبت مجموعة من الأوراق، مشروع لقصة طويلة أتمنى أن تطلعي عليها.
مد يده إلى تحت الوسادة ثم أخرج رزمة من الورق، وبدا قلقًا كأنما يمر بامتحان، قال للممرضة الجميلة أنيسس فون كورسكي: أريدك أن تقرأي شيئا، قد يكون مملًا، لقد قرأها أحد الجنود المرضى وقال لي إن شعر جلده انتصب من فرط الإثارة، وآمل ألا يكون الحمق قد بلغ بي حدًا أتصور أن كلام هذا الجندي يدل على أنني كتبت شيئا جيدًا لأن أحدًا قد أعجب بها.
تناولت منه الأوراق وذهبت إلى غرفتها أضاءت المصباح، قلبت الأوراق، كان العنوان مكتوبًا بالحبر الأزرق «حب في الحرب»، كانت حشرات البعوض تتطاير على المصباح وأصوات أنين الجرحى تترامى إلى سمعها، ولكنها شعرت وهي تقرأ الصفحات الأولى أنها تعيش على مقربة من جبهات القتال، وأن بطل هذه الحكاية يشبه كثيرًا الفتى الوسيم صاحب الأوراق، فالملازم هنري شاب أمريكي يقود سيارة إسعاف، وهذه الصفحات المكتوبة بخط دقيق تحكي عن علاقة الحب التي تربطه بالفتاة كاثرين باركلي التي تعمل ممرضة في مستشفى الصليب الأحمر. وتبدأ بينهما علاقة رومانسية.
تتوقف أنييس عن القراءة، قالت لنفسها: هل يعقل أن هذا الأمريكي قد أحبني فعلًا؟، إنها تشاهد ملامحها في شخصية بطلة الرواية كاثرين، تنتبه إلى صوت يناديها، تترك الأوراق على المكتب تذهب باتجاه الصوت، كان أرنست ما يزال مستيقظًا اقتربت منه وهي تقول: يبدو أنك خالي الفكر.. الموت يطاردنا في كل لحظة وأنت تكتب قصصًا عن الحب.
يضحك بصوت عال وهو يقول: «لم تسلبني الحرب سعادتي، لقناعتي أن الحياة نفسها تراجيديا ونهايتها واحدة، لكني أدرك أن بإمكان الإنسان اختلاق شيئا ما، والإبداع بما يكفي من المصداقية، كفيل بجعلك سعيدًا لدى قراءته، لأعيش سعادة لم أعرف مثلها قبل. وإزاؤها تغيب معاني التفاصيل».
-أتعرف.. إذا لم نضحك في هذه الأيام الدموية.. سنموت كمدًا بدلًا من الموت برصاص الألمان.
-هناك يا عزيزتي ما هو أفضل من الموت!! أن نموت حبًا.
-ألم أقل لك أنك خالي القلب يا فتى.
-منذ أن دخل المستشفى كانت أنييس كوفيسكي تهتم به بشكل خاص، ويكتب في إحدى رسائله لشقيقته الصغرى: أحبها.. وأظنها ستكون حبي الأول والأخير.. سأتزوجها إذا قبلت ذلك.. ولماذا لا تقبل.. وهي معي كل الوقت؟!.. بل هي كثيرًا ما تقضي جزءً من الليل على مقعد بجوار فراشي.
------
المصدر: كتاب «سؤال الحب.. من تولتسوى إلى أينشتاين».. علي حسين.