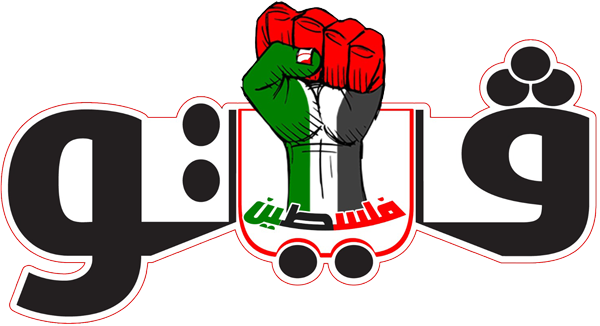محمد عيسى يكتب: حكايات شهرزاد في الميكروباص

هُنا القاهِرة.. صيفٌ قائظٌ.. لَهِيبٌ لا يَرحَمُ أحدًا، يُمْسِك بالفردِ لا يَبْرَحَه إلا وقد أكل عليه وشَرِبَ، يَسْرِق طَاقته.. ويَتْرُكه وَجْهًا لوجهٍ مع لسعات شمسه.. دَعْكَ من هذا.. يمكن أن نجد له علاجًا أما لهيب الفقر، فهذا دواؤه عند الخالق وحده، فالفقراءُ سواسيةٌ في كلِّ شيء.. حتى لهيب العيش يتجرعونه سويًا، ويدفعون ضريبةَ الفقرِ كلَّ صباحٍ.. يواجهون الموت بين الفينة وأختها.
كان صَباحًا مُزعِجًا، ثَمَّةَ أوراقٍ عَليَّ أن أنجزها من مصلحةٍ حُكُومِيّةٍ.. أوَّاهُ من ذاك الصباح.. قُرأت الفاتحة على يوم الإجازة.. صَفَعاتُ الشمسِ لم تَرْأَف بِضَعْفِنا إثر نَوْبَةِ حُزْنٍ أصابتنا مُنْذُ زَمَنٍ قريب، لم تَبْرَحَ القلبَ حتى كتابةِ السطور.. تُطاردني وتُحْكِم المُطاردة كلما حَاوَلتُ الفِكَاك.
رُحتُ ألملم أوراقي وانصرفت.. سَبَبٌ مَا مَنَعَنِي من استقلال سيارتي.. ركبت تابوتًا يحمل أحد عشر بَائِسًا، سائقه يقف كل نصف دقيقة ليَرْكَب ذاك ويَنْزِل الآخر.. لَعْنَةُ اللهِ على الوجوهِ العابسة في الصباح.. لا أُحِبُّها ولا أُحِبُ صَبَاحَها.. بَيْدَ أنها العاصمة تمنحك كلَّ يومٍ قَدرًا من البُؤس يَكفيْكَ حتى تذهب إلى مضجعك بسلام.. تُجْبِرُك أن تعيشَ هكذا، ولو أنك فكرت لتوِّك فيما يَدور حولك، لذهبَ عقلك ومضيتَ في الطرقات تجمع الأوراقَ وأكياسَ البلاستيك مِثلما يَفعل «الإستروكس» في معاتيهه.
في المقعد الخلفي تَقْبَعُ أربعينية - ربما في نهاية العقد - سَمِينةُ العقل إلا في بعضِ أحيان، سليطةُ اللسانِ، لم تتوقف عن الثرثرةِ مع الراكب إلى جوارها، قصَّت له كل شيء عنها وكأنه جاء لخطبتها.. دفع لها الأجرة، رغم أن صداقتهما لم يتخطَ عمرها دقائق ثلاثة.. كأن بالوعة صرف فُتحت.. كانت الأمور تمضي في طريقها الصحيح.. قبل أن تقطعَ سُكُونَ الرحلةِ دون مقدمات: «أنا مش عارفة ياخويا الجو الحر دا.. مش حرام اللي أنا فيه دا.. الله يرحم الرجالة.. حسبي الله ونعم الوكيل في النطع اللي في البيت».. في إشارةٍ لزوجِها قَعِيْدِ البيتِ وسعيها لإطعامه بعد أن تسببت في إصابته بجلطة.
رَاحَ الرَّجُلُ يَتَحَسَّس طريقَه إلى وترِهَا المنحولِ، حدَّثَته عن زوجها الأول كيف كان لعوبًا.. تزوج عليها دون علمها، وما أن عرفت تَرَبَّصَت له ليل نهار تستعد لتحكم قبضتها كمن يُجَهِزَ لافتراس ضحيته.. وبينما يقف ذات مساء في شرفة الشقة.. إذا بها تسحبه من قدمه بكلِ ما أوتيت من قسوة وجبروت، لتلقي به في الشارع «زرع بصل»!!.. لكن إرادة الله أرادته حيًا.. شهرزاد ظلت تحكي والابتسامة لم تفارق شفتيها، لم تكتفِ بذلك، بل ساومته في حالِ أبْلَغ عنها ستفضح أمره وتخبر القاصي والداني أنه يريد أن يحضر إلى الشقة رجالا ليضاجعوها لأجل المال.. فسكت المغلوب على أمره وطلقها.
وفقًا لمنطقيةِ الأشياءِ.. بدأ عدد الركاب يقل، وإذا بها فجأة تضع يدها على كتفي أنا الجالس أمامها: «طب إنت إيه رأيك في اللي أنا عملته دا؟».. نظرت لها ولم أجد ما أقوله إثر بشاعة ما روت.. لم تَعْبَأ بردةِ فعلي وقَرَّرَتْ أن تسرد قصة زوجها الثاني.. كان مختلفًا بعض الشيء عَرَفَته في تسعينيات القرن المنصرم، حينها كان يعمل في «بوفيه» إحدى الشركات، أما هي فكانت عاملة نظافة آنذاك بنفس المكان.
لم أعرها اهتمامًا يُذكر.. فراحت إلى ذلك الذي آثر أن ينزل نهاية الخط حتى تنتهي شهرزاد من الحَكْي.. استمرت السيدة الفاضلة في تُرّهاتها، أخبرت شهريار أنها تنفق على زوجها وأبنائها.. زوجها أصيب بجلطة.. كانت تعامله بقسوة وجبروت على حد قولها لأنه لا يقوى على العمل مثل باقي الرجال نظرًا لسابقةِ مرضٍ قديمةٍ في القلب.. تُهِينه أمام أبنائه.. لم ترحم قلة حيلته وفقره، ضاق الحال يومًا بعد الآخر وهي تريد المال.. ذات يوم وعدته أن تصيبه بجلطة وقد فعلت.. أغرب من كل ذلك أنها تحكي ببرود لا أعرف من أين لها.
حين تُرتب الأوراق تَجد أن الفَقرَ يَدفَعك إلى الخُضوعِ والخُنوع، يَفتِكُ بما تَبقى من أملٍ وصبرٍ وربما ما تبقى من رغبةٍ في العيش.. تُطالعنا الحياةُ كل يومٍ بحكايات بَطَلُها العوزُ، ذلك الذي لا حيلة أمامه غير الدعاء والسعي.. الفقرُ ينهشُ دونَ رحمةٍ لا يتوقف عن النخرِ في أعمدة البنيان.. يا الله نسألك حسن الخاتمة.