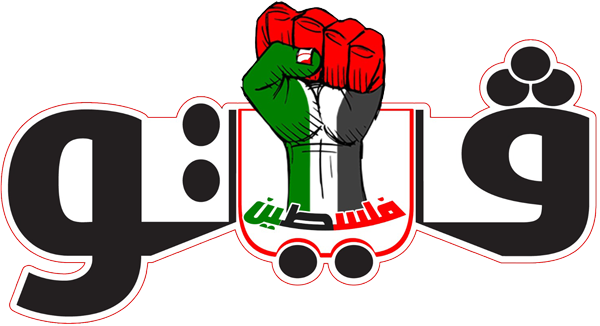علي جمعة يطالب بدراسة النموذج المصري في تجربة الدولة الحديثة

طالب الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، بدراسة النموذج المصري في ماضيه وحاضره ومستقبله، ووصفه بالنموذج الرائد الفريد، مؤكدًا وجود خلط في تحليل النموذج المصري إما عن سوء قصد أو بحسن نية.
دراسة النموذج المصري
وقال إن محمد علي، في بناءه لمصر الحديثة، أراد أن يحقق التوازي بين الثقافة السائدة والشريعة الإسلامية، فأنشأ تعليما موازيا للأزهر الشريف، ولكنه سحب السلطة من المماليك بتراثهم المعروف، ومن رجال الدين أيضا، حيث كان لرجال الدين سلطة في اتخاذ القرار، ولم يعد للأزهر سلطة في اتخاذ القرار السياسي، ولكن ظلت له سلطة علمية أدبية.
وكتب الدكتور علي جمعة تدوينة على الفيس بوك "النموذج المصري نموذج يستحق الدراسة في ماضيه وحاضره ومستقبله، وذلك لأنه نموذج رائد، ولأنه أيضا نموذج فريد، ولأن النماذج التي جاءت من بعده تحتاج إلى إعادة تقويم، ولأن كثيرا من اللبس والخلط قد حدث في تحليله وفهمه مرة عن سوء قصد، ومرات عن حسن نية، ولكن إما عن جهل بحقيقته، وإما عن تحيز في مدرسة تحليله يمينًا ويسارًا، وإما لعدم الوعي بتطوره أو بتغيره".
مستقبل الثقافة في مصر
وقال "ويحتاج شبابنا كثيرا إلى دراسة هذا النموذج ليس فقط لتقويمه، وإنما أيضا لمستقبل الثقافة في مصر، ولمستقبل الثقافة في العالم العربي والإسلامي، ولمزيد من الصلة مع العالم كله"
وأضاف "ونقصد بالنموذج المصري تجربة الدولة الحديثة بكل جوانبها السياسية، والثقافية، والقانونية، والدينية، والاجتماعية، والعلمية، وسائر الجوانب التي تكون الحياة منذ عصر محمد علي، وحتى الآن"
وتابع قائلًا: "اتجه محمد علي باشا إلى بناء الدولة العصرية الحديثة في مصر، وهي دولة حاولت أن تستقل عن أشخاصها بقدر الإمكان، والاستقلال بين الدولة وأشخاصها يتم عن طريق المؤسسات، ويتم عن طريق النظام، ويتم عن طريق الدستور، ويتم عن طريق التقنين، ويتم عن طريق الفصل بين السلطات، ونحو ذلك".
الديمقراطية والليبرالية
وعن الديمقراطية قال جمعة: "والديمقراطية بالأساس مبنية على المساواة بين المواطنين، وأن فكرة المواطنة وليس فكرة الرعايا هي التي تسود في دولة ما، والمساواة هنا تشمل المساواة في الحقوق وفي الواجبات، وتشمل عدم الاستثناء من القانون أو التمييز العنصري، وكلما تحقق ذلك كانت الدولة أقرب إلى تحقيق الديمقراطية."
وأضاف "والليبرالية تعني احترام الحريات، حرية العقيدة، حرية الانتقال، حرية العمل، الحرية السياسية، والتي هي بالأساس مبناها التعددية، ومبناها التمثيل الشعبي."
واستطرد قائلًا: "ثم بعد ذلك تأتي النظم والتنظيمات التفصيلية التي قد تختلف من بلد إلى آخر طبقا للتجربة التاريخية، وطبقا لما يمكن أن نسميه بالثقافة السائدة، والتي لا يجوز الخروج عنها إلا بقدر تحقيق المصلحة، لأن الخروج عن الثقافة السائدة– خاصة في صورة طفرات- يؤدي إلى ضياع المصالح وإلى اضطرابات، أكثر ما يؤدي إلى تحقيق المصالح والمقاصد لشعب ما."
محمد على والدولة الحديثة
وقال "أراد محمد علي أن يحقق ذلك بالتوازي مع البقاء على الثقافة السائدة، وعلى الشريعة الإسلامية التي هي المكون الأساسي لجمهور الشعب في مصر، فأنشأ تعليما موازيا للأزهر الشريف، ولكنه سحب السلطة من المماليك بتراثهم المعروف، ومن رجال الدين أيضا، حيث كان لرجال الدين سلطة في اتخاذ القرار، ولم يعد للأزهر سلطة في اتخاذ القرار السياسي، ولكن ظلت له سلطة علمية أدبية، وليست تنفيذية، والفرق بينهما كبير على قدر اتصاله بالرأي العام، واتصاله بوجدان الأمة، وعلى قدر الثقة فيه الناشئة من تاريخه أولا، ومن منهجه العلمي الوسطي ثانيا، ومن شموليته ثالثا، ومن احترام علمائه لأنفسهم ولأمتهم ولتراثهم رابعا، وهكذا".
وأضاف جمعة "ولكننا نؤكد أن السلطة والمسئولية وجهان لعملة واحدة، وما دام أن السلطة الزمنية قد رفعها محمد علي باشا من علماء الدين، فإن لا مسئولية زمنية عليهم، وما دام الشعب والرأي العام قد أولى الأزهر سلطة أدبية، فإنه يكون مسئولًا أدبيا أيضا أمام الرأي العام على قدر ما أولاه من سلطة من هذا النوع."
إسماعيل باشا
وتابع "في عصر إسماعيل باشا أراد أن يكمل ما بدأه جده محمد علي باشا في بناء الدولة الحديثة، فأنشأ البرلمان، ودعا إلى الفصل بين السلطات الثلاث، وأقر نظام الانتخاب، وبنى الهياكل الأساسية الحديثة، واستمر في عمليات الاستقلال، وسعى إلى وضع نظام للتقنين المصري."
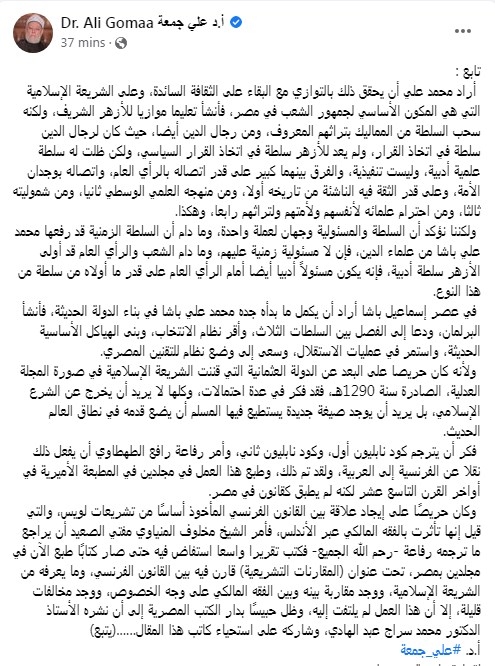
قال "ولأنه كان حريصا على البعد عن الدولة العثمانية التي قننت الشريعة الإسلامية في صورة المجلة العدلية، الصادرة سنة 1290هـ، فقد فكر في عدة احتمالات، وكلها لا يريد أن يخرج عن الشرع الإسلامي، بل يريد أن يوجد صيغة جديدة يستطيع فيها المسلم أن يضع قدمه في نطاق العالم الحديث."
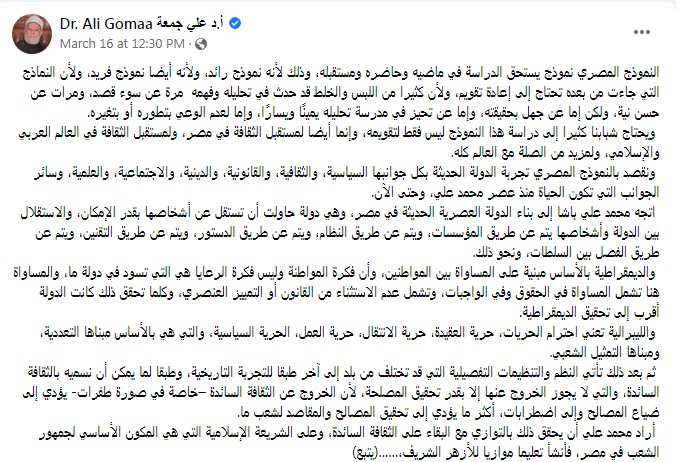
وأضاف جمعة "فكر أن يترجم كود نابليون أول، وكود نابليون ثاني، وأمر رفاعة رافع الطهطاوي أن يفعل ذلك نقلا عن الفرنسية إلى العربية، ولقد تم ذلك، وطبع هذا العمل في مجلدين في المطبعة الأميرية في أواخر القرن التاسع عشر لكنه لم يطبق كقانون في مصر."
واختتم جمعة حديثه قائلًا: "وكان حريصًا على إيجاد علاقة بين القانون الفرنسي المأخوذ أساسًا من تشريعات لويس، والتي قيل إنها تأثرت بالفقه المالكي عبر الأندلس، فأمر الشيخ مخلوف المنياوي مفتي الصعيد أن يراجع ما ترجمه رفاعة- رحم الله الجميع- فكتب تقريرا واسعا استفاض فيه حتى صار كتابًا طبع الآن في مجلدين بمصر، تحت عنوان (المقارنات التشريعية) قارن فيه بين القانون الفرنسي، وما يعرفه من الشريعة الإسلامية، ووجد مقاربة بينه وبين الفقه المالكي على وجه الخصوص، ووجد مخالفات قليلة، إلا أن هذا العمل لم يلتفت إليه، وظل حبيسًا بدار الكتب المصرية إلى أن نشره الأستاذ الدكتور محمد سراج عبد الهادي، وشاركه على استحياء كاتب هذا المقال".