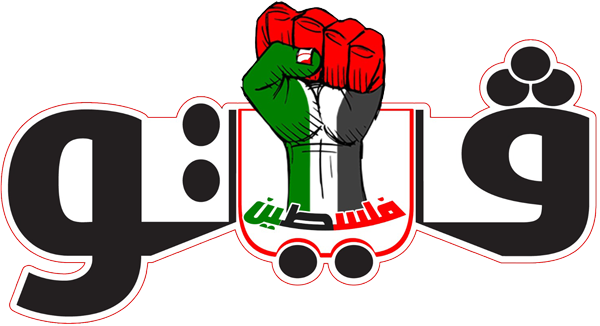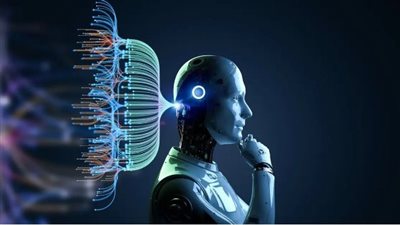لماذا لا نَشعُرُ بالانتِمَاءِ؟!
قام أحد المواقع الإلكترونية باستطلاع رأى الشباب المصرى حول رغبة أحد المصريين المغتربين في إنهاء تعاقده بدول الخليج والعودة إلى مصر.. فجاء أكثر من 90% من التعليقات بـ"لا" أوعى تتهور "خليك عندك".
حقيقى كانت إجابات صادمة بالنسبة لي، فاضحة لمشاعر الانتماء لهذا البلد العظيم، تلك المشاعر التي لا تقوم بلد ولا تتقدم بدونها؛ فتسأءلت: إذا كان ذلك تجاه دول الخليج.. فما بالنا إذا كان الشاب مغتربًا في أوروبا "بلاد الجن والملائكة"؟! بالإضافة إلى أن مصر تعد من أكثر الدول التي يطلب شبابها الهجرة إلى دول أوروبا وأمريكا؟.. فتساءلت مع نفسى، وأردت أن أتساءل معكم عَبَرَ هذا المقال: لماذا صِرنَا هكذا؟ وهل نحن فعلًا لا نشعر بالانتماء لهذا الوطن.. ولماذا؟! أم أن مواقع التواصل الاجتماعى صارت خادعة، ككل شيء يُحِيُط بنا؟!
فبعد ثورة 25 يناير.. ترددت عبارات اجتماعية عديدة.. أشدها خطرًا عبارة "أن الثورة أخرجت من المصريين أسوأ ما فيهم"، أو "أنها أظهرت الوجه القبيح للإنسان المصري".. وسواء اتفقنا مع هذا العبارات أم لم نتفق فلابد أن نعترف بأننا لدينا أزمة قوية في الانتماء.. وإذا كان الانتماء دافعا غريزيا.. فإن قسوة الدولة في التعامل مع قضايا مواطنيها، عادة ما تدفعهم للانتماء إلى جماعات غير مشروعة؛ ربما تنجح ببراعة في تحويلهم إلى مواطنين ضد المجتمع!
فمحور الأزمة لدى المواطن غالبا ما تتعلق بعلاقته بالسلطة ،وربما بثقافة المجتمع الذي يعيش فيه.. فالإنسان بطبيعته لا يستطيع العيش دون الانتماء لجماعة أو لمجتمع.. ومن ثم فأكبر عقاب للمجرمين هو حرمانهم من الاستمتاع بالحياة الاجتماعية. فالإنسان لا يستطيع أن يجد للحياة معنى إلا إذا أعطى من نفسه للمجتمع الذي يعيش فيه!
وإذا كانت الحياة في وطن والانتماء إليه تتطلب من الوطن أن يوفر لأبنائه ثلاثة مزايا هي القوة والكرامة والأمان.. فلا غرابة أن يشعر الأفراد بالانتماء للوطن الذي يمنحهم "القوة" ولا يشعرون فيه أمام السلطة بالضعف وقلة الحيلة والاستهانة بكرامتهم. والتي غالبا ما تكون جميعها نتائج حتمية لفساد السلطة أو لإجرام السلطات العمومية؛ بدعوى الحفاظ على الاستقرار.. الذي لا يعد أكثر من رماد تحته نار تنتظر الاشتعال!
ولعل هذه هي وجهة نظر عالم النفس "أدلر" أما "فرويد" صاحب مدرسة التحليل النفسي فيرى أن الشعور بـ"اللذة" أو "المتعة" هو المحرك الأساسي للسلوك البشرى، وأن الإنسان عادة ما ينتمي للمكان الذي يتلذذ فيه، ويشعر بأن الانتماء إليه نعمة والحياة فيه متعة.. فعادة لا ينتمي الإنسان إلى "وطن " يُكدس أرصدة "الدموع" في أحداق أبنائه!
ورغم منطقية أن يكون الشعور بالسعادة والقوة هو المحدد الأساسي للشعور بالانتماء، إلا أن "فرانكلين" يرى أن الإنسان عادة ما ينتمى للوطن الذي يشعره بأن لحياته فيه "معنى"! ويرى أن الشعور بالمتعة لا يدفع للانتماء بل ربما تكون "المتعة" هي النتيجة الطبيعية للانتماء.. وأن القوة ليست هي الغاية من الشعور بالانتماء، بل هي الوسيلة إليه.. ومن ثم فإن المجتمع يفقد استقراره، ويتحول إلى الحالة المَرَضِيَة عندما تصبح الغلبة في الانتماء إليه للقوة والمتعة.. وإذا كان هناك أفراد لا يشعرون بأنهم يعملون إلا إذا كان للعمل مقابل مادى، فإنه لا يكون لحياة الإنسان "معنىً" إلا إذا تحرر من "الاحتباس" في ذاته إلى "الانعتاق" خارجها. وبقدر ما يمنحه للمجتمع دون مقابل!
وغالبا ما يتحقق ذلك من خلال رغبة الإنسان في التطوع لخدمة المجتمع الذي يعيش فيه.. ومن ثم فإن فتح المجال للتطوع هو حق أصيل من حقوق الإنسان التي يجب أن تكفلها الدولة لكل مواطن؛ كى يعبر من خلاله عن مشاعر الانتماء التي بداخله؛ وذلك بتفاعله مع قضايا المجتمع.. فيتحول المجتمع تدريجيًا إلى "كحلةٍ " بعينِ كل مواطن، أو "كائن" يعيش بداخله! ولهذا فإن قيام الدولة بفرض قيود على التطوع يَعَد محاصرة لحرية الضمير وانتهاكًا متعمدًا لحقوق الإنسان وتدميرا شديدًا لمشاعر الانتماء.. والذي قد يتسبب في خلق أزمات وكوارث، ربما لا تقوى الدولة نفسها على مواجهتها!
ومخطئ من يتصور أن "دخل الفرد" المعيار الأهم في تحديد مشاعر الانتماء؛ فأكثر الدول تحضرًا ومدنية هي أكثرها في معدلات التطوع. والانضمام إلى المنظمات التطوعية في أمريكا لا يقل كثيرا عن معدلات التطوع في الجيوش العربية.. فرغم أن أمريكا بلد يقدس "الرأسمالية" إلا أنه من كل 4 أشخاص شخص يُفني جزءًا من حياته في التطوع. حتى تجاوز مجموع ساعات العمل التطوعى الـ8 بلايين ساعة. كما تجاوزت الموازنة السنوية للجمعيات التطوعية الـ1.5 تريليون دولار.. أي ما يعادل 10% من الدخل القومى الأمريكى. ورغم أنهم متهمون بـ"العلمانية " إلا أن المنظمات الدينية تحصل على ما يزيد على 35% من مساهمة المواطنين في النفع العام!
وفى مصر.. رغم التسهيلات التي قدمتها الدولة لإنشاء الجمعيات الأهلية حتى تجاوزت أعدادها 54 ألف جمعية أهلية.. فقد وضعت الدولة "عراقيل" عديدة تحول دون قيام هذه الجمعيات بمهامها التنموية والاجتماعية. وأصبح المتطوعون مطاردين "أمنيًا" وموصومين بـ"الخيانة" كما أنهم مهددون بالمطالبات "الجنائية! وبين يوم وليلة يدفع المتطوعون الشرفاء ثمن انتمائهم.. وربما يُزَج بهم في السجون، ويعد القانون رقم 70 لعام 2017 شاهدا على رغبة الحكومة في تدمير حق الإنسان في التطوع لخدمة الوطن الذي يحبه ويشعر بالانتماء إليه.. وعلى السيد الرئيس أن يتدخل لإيقاف هذه المهزلة التاريخية، والجريمة التي ترتكب في حق المجتمع المدنى، الذي هو شريك أساسى للدولة في التنمية، وتعد حرية الحركة بالنسبة له دليلا دامغًا على سير الدولة في دروب الديمقراطية، وبالشراكة والتكامل في السياسات والجهود تصبح مصر قادرة على اللحاق بقطار النهضة والتنمية!