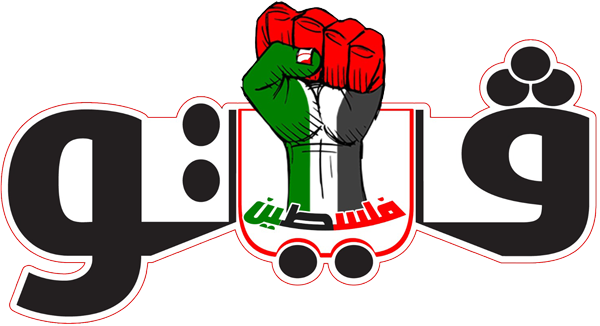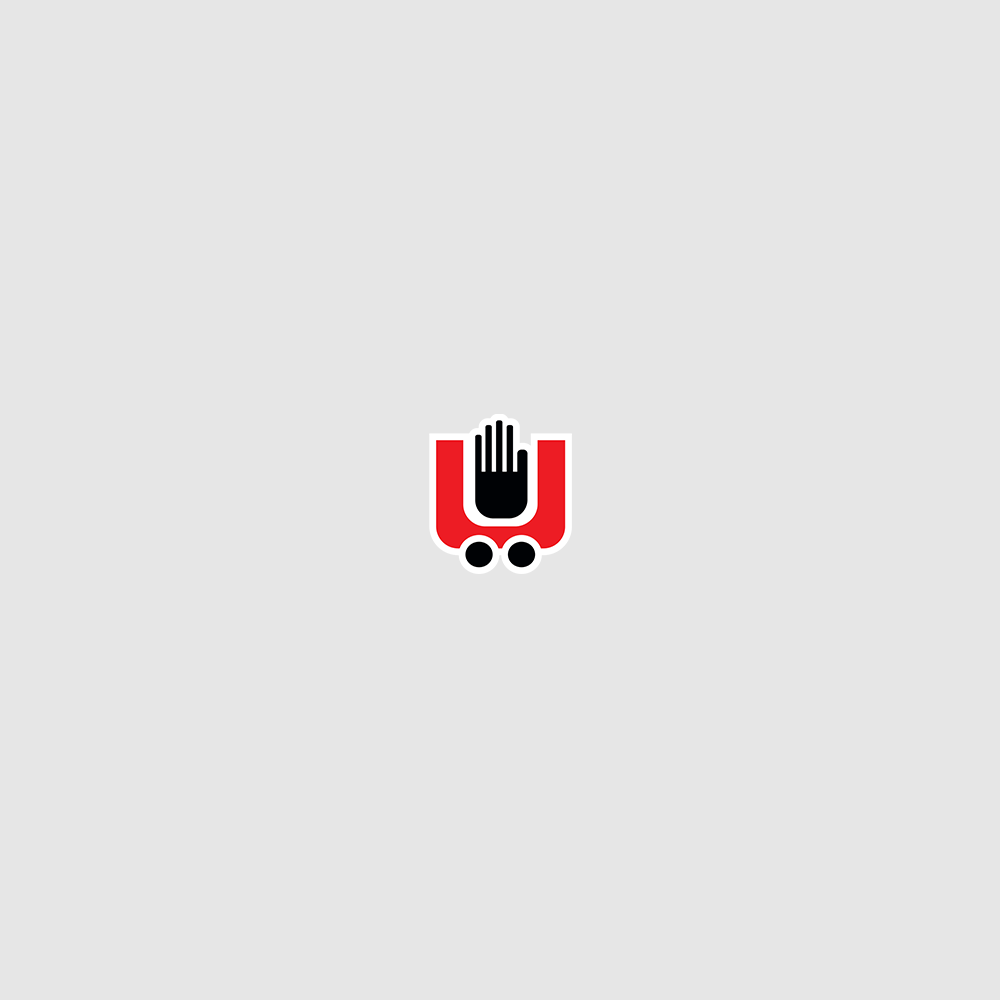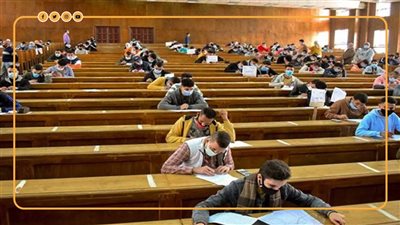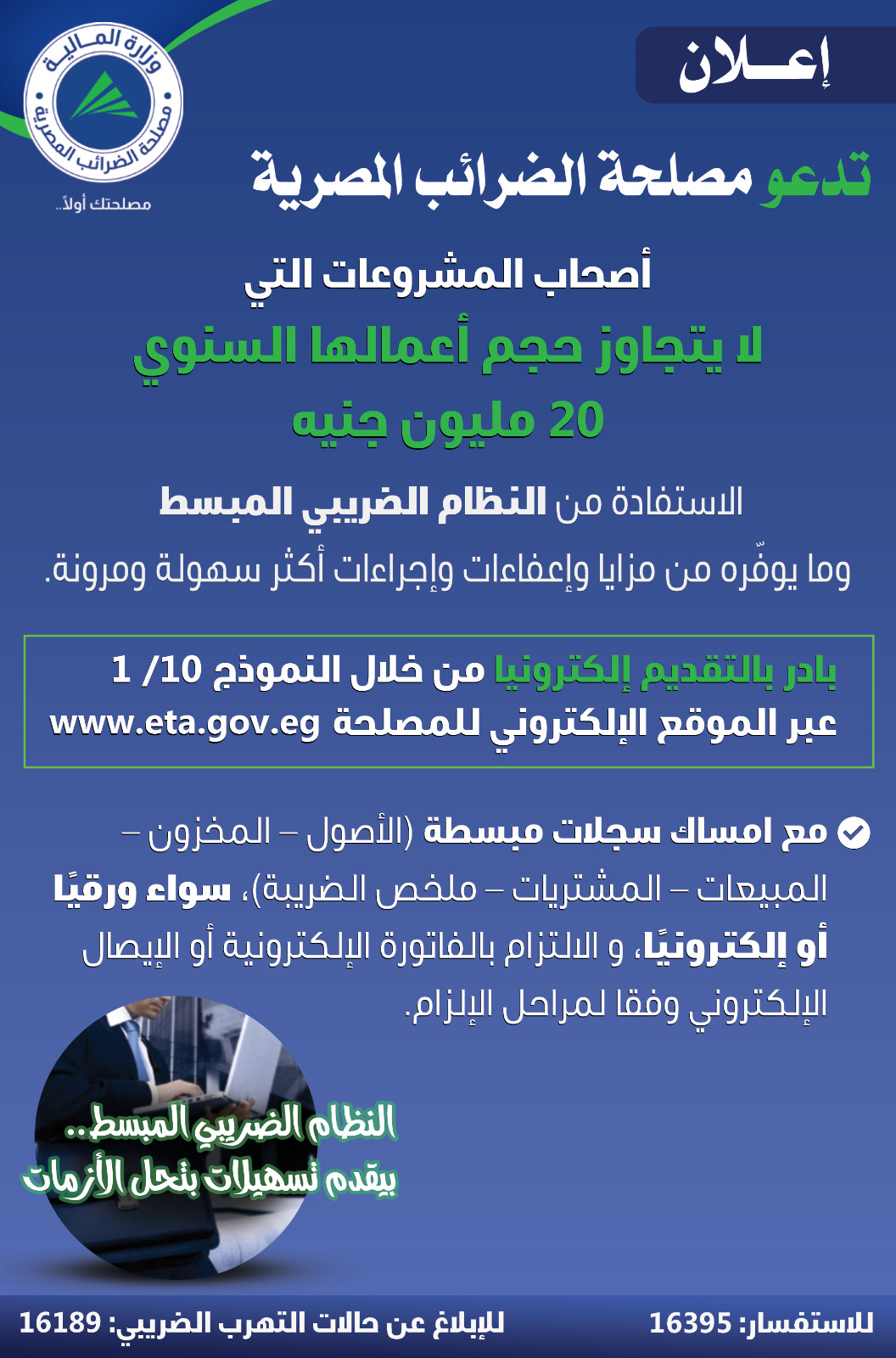فهمى هويدى محذرا من «الأصولية العلمانية»: أشد خطرا من التطرف الدينى
في أكتوبر 2008، منعت صحيفة «الأهرام» مقالا للكاتب فهمى هويدى، دون إبلاغه، الأمر أزعج الأخير كثيرا وأثار غضبه، لا سيما أن المقال لم ينطو على إشارات سياسية، كالتي تمنع الصحيفة نشر المقالات بسببها..
مقال «هويدى» كان عنوانه «الأصولية العلمانية»، محذرا ومندهشا من توغلها في الحياة الثقافية، بشكل غير مسبوق، وجاء في نص المقال الذي ننشره بتصرف محدود:
«الأصولية العلمانية التي انتعشت في السنوات الأخيرة لم تنل حقها من الرصد والرد، رغم أنها تطل علينا بين الحين والآخر بأكثر من وجه ولسان، حتى اللغط الدائر حول السنة والشيعة هذه الأيام، لم يفت أبواقها أن تخوض فيه.
لست صاحب مصطلح «الأصولية العلمانية»، الذي اعتبره جديدًا بالنسبة لى على الأقل. وهو أكثر تقدمًا وأشمل من مصطلح «التطرف العلماني» الذي استخدمته قبل خمس سنوات، وبسببه هاجمنى كثيرون من غلاة العلمانيين، واعتبروه محاولة من جانبى لتغيير دفة الحوار الذي كان مثارًا آنذاك حول التطرف الإسلامي، رغم أننى حينذاك كان لى موقفى المعلن في نقد ذلك التطرف، لكنى قلت فقط أن الغلو ليس مقصورًا على فئة دون أخرى، ولكنه موجود عند الجميع، بمن فيهم العلمانيون انفسهم. ولذلك يجب أن نتصدى له على كل الجبهات.
مصطلح الأصولية العلمانية جديد ومثير من زاويتين، الأولى: أنه صادر عن اثنين من الباحثين الأمريكيين، والثانية: أنه يشير إلى تصور للعلمانية ليس باعتبارها دعوة لإقصاء الدين عن المجال العام من خلال المطالبة بفصل الدين عن الدولة، ولكن باعتبارها فكرة مقدسة وعقيدة، ليست موازية وإنما مخاصمة.
الباحثان الأمريكيان اللذان أشارا إلى المصطلح هما: جون اسبوسيتو ومحمد مقتدر خان، وقد أعدا دراسة «حول الدين والسياسة في الشرق الأوسط»، نشرت ضمن كتاب «الشرق الأوسط- محاولة للفهم»، أحد إصدارات المشروع القومى للترجمة في مصر، وقد تحدثت الدراسة عن أن تحيز نفر من الباحثين إلى العلمانية حول النظرية إلى عقيدة تستند إلى افتراضات مسبقة. وفى رأيهما انها أصبحت أيديولوجية مسلمًا بها. وبمرور الزمن اكتسبت الفكرة قداسة وصارت معتقدا يقوم على الإيمان. أشارت الدراسة إلى أن بعض علماء الاجتماع يستشعرون كراهية فطرية وغريزية للدين. وهؤلاء لم يعودوا متحيزين ضد الدين فحسب، وإنما أصبحوا يناصبونه العداء أيضًا.
هذا الإيمان الأعمى بالعلمانية لم يمكن أولئك النفر من الأصوليين من تقدير الدور المهم الذي يضطلع به الدين في الشرق الأوسط، رغم أن مختلف المؤشرات تدل على أنه بصدد أن يصبح القوة الموجهة الرئيسية في ميدان السياسة العالمية في القرن الحادى والعشرين. هكذا قالا. -كشف الأستار عن حقيقة الأصولية العلمانية أسهم فيه أيضًا باحث عراقى متميز هو الأستاذ هادى العلوى في كتابه «المرئى واللامرئى في الأدب والسياسة»، الذي سجل فيه شهادة استمدت أهميتها ليس فقط من أن الرجل عبر عن رأيه بصراحة كاشفة، ولكن أيضًا لأن صاحبها مثقف له خلفيته الماركسية التي مكنته من أن يحتل موقعًا بارزًا بين القيادات البعثية في العراق.
الأمر الذي يعنى أنه ليس محسوبًا على الحالة الإسلامية من أي باب.في هذا الصدد ذكر الكاتب أن الدكتور نصر حامد أبوزيد أعلن لجريدة» الأهالي» إبان العدوان الأمريكى على لبنان أنه يجب عدم استنكار العدوان، لأنه يعنى الوقوف مع حزب الله. وبالتبعية يكون أوثق الحلفاء في هذه الحرب هو أنظمة قطاع الطرق على اختلافها. أضاف أن كاتبة لبنانية من صفوف اليسار قالت في اجتماع مفتوح (حضره الكاتب) أن مشكلتنا ليست الإمبريالية ولا أنظمة قطاع الطرق، بل إن الامبريالية مسمى موهوم وان الولايات المتحدة تتصرف كدولة مسئولة عن العالم. وينبغى دعمها لئلا تنهار. وصدق على قولها جميع الجلساء.
أضاف العلوى قائلًا: هكذا يصبح العدو الأوحد لتسعين في المائة من مثقفينا هو الإسلام (السياسي). وهذه الإلحاقة للتمويه. فالعدو هو الإسلام نفسه: تاريخه الحضارى وتراثه العظيم ومنجزاته العالمية، التي مهدت بالتكامل مع منجزات الحضارة الصينية لولادة العصر الحديث.
في موضع آخر ذكر الكاتب أن إهدار الجهود الفكرية الضخمة في المناوشة مع الإسلام يصب في المخطط الصهيونى الإمبريالى الذي يهدف إلى اشغالنا بحروب جانبية وإيقاع الخلط في الأولويات والجبهات التي يجب خوض النضال ضدها. وقد حصلت انظمة الفساد على متنفس واسع بانخراط مثقفين يفترض أنهم من صفوف المعارضة في جهازها الإعلامي والأمني، وبما حظيت به من تزكية لدورها في مواجهة المد الديني، بوصفها أنظمة علمانية تكافح في سبيل الفكر التقدمى ولإنقاذ الناس من الخرافات. فهى ملاذ الفكر وأداته الضاربة ضد «الظلاميين».
إن الصراع الحقيقى في الساحات الحقيقية - الكلام لايزال للعلوي- ليس صراعًا فكريًا. ومشكلتنا ليست مشكلة أيديولوجية وما هو مستهدف من قبل العدو ليس الثقافة ولا المثقفين. بل هي أراضينا وثرواتنا وكرامتنا الوطنية. هو صراع بين معتد ومعتدى عليه. بين شعوب وقوى احتلال واستعمار- انتهت الشهادة.
-ما سبق اعتبره مفتاحاَ لفهم كتابات عديدة تنشرها صحفنا لأناس ركبوا موجة الحرب ضد الإرهاب. واستثمروا أجواء الخصومة الحاصلة بين السلطة وبعض الجماعات الإسلامية، وأعلنوها حربًا مفتوحة ضد ما سمى بالإسلام السياسي والأصولية. وعندهم فإن كل من اعتز بدينه ودافع عنه وانحاز إلى نموذجه الحضاري. فلابد أن يكون أصوليًا وامتدادا لحركة الإخوان المسلمين، وخلية متقدمة للإسلام السياسي. وداعيًا إلى استنساخ النموذج الإيرانى في قول ونموذج حركة طالبان في قول آخر. وهو في كل أحواله كائن مشوه، لايؤمن بالدولة المدنية ولايحترم حقوق الإنسان. إذا امتدح الديمقراطية فهو منافق ومخادع، وإذا دافع عن التعددية والآخر فهو كذاب، وإذا تحدث في أمور الوطن فهو مدع يخفى أجندته الحقيقية التي يريد بها إقامة الدولة الدينية.
عند هؤلاء فإن المسلم الملتزم لايمكن أن يكون سوياُ ولا معتدلًا، ولايمكن أن يكون مكانه خارج التصنيفات التي يحاصرونه فيها. لا هو أصولى ولا إخوانى ولا إيرانى ولا طالباني. والصورة النمطية التي يريدون ترويجها عنه أنه لا يمكن أن يكون مشغولًا بهموم وطنه وامته، ومن ثم جزءاُ من التيار الوطنى العريض، وإنما ينبغى أن يظل محاصرًا في قضايا التكفير والحجاب والنقاب وتطبيق الحدود وإقامة الإمارة الإسلامية، تمهيدًا لإقامة الخلافة وتنصيب الأمامة العظمى.
من مفارقات الأقدار وسخرياتها أن ذلك التنميط الساذج الذي يلح عليه الأصوليون العلمانيون العرب، لم يقع فيه بعض الباحثين الغربيين المعنيين بدراسة المجتمعات الإسلامية. وبين يدى كتاب أصدرته جامعة هارفارد في عام 2003 بعنوان «إسلام بلا خوف» للدكتور ريموند ويليام بيكر أستاذ العلوم السياسية (ترجمته إلى العربية الدكتورة منار الشوربجى ونشر في الأردن هذا العام)، وهو يقدم صورة أكثر أمانة ودقة لمن اسماهم بالإسلاميين الجدد أو الإصلاحيين في مصر، الذين اعتبرهم «قوة تقدمية ومستقلة». وهو ليس وحيدًا في ذلك، فقد سبقه إلى تلك القراءة الأمينة والمنصفة آخرون، في المقدمة منهم البروفيسور جون اسبوسيتو، الذي أصدر هذا العام عدة كتب في ذلك الاتجاه، من بينها مؤلفاته عن الانبعاث الإسلامي، والتهديد الإسلامى بين الحقيقة والوهم، والإسلام والديمقراطية، وأخيرًا من يتحدث باسم الإسلام.
-ما دعانى إلى ذلك الاستطراد أنه خلال الأسبوعين الأخيرين الذين أثير خلالهما الجدل في الأوساط الإسلامية حول العلاقات بين الشيعة والسنة، خاض نفر من الأصوليين العلمانيين في الموضوع. ومنهم من لم ير في ذلك الجدل سوى أنه تعبير عن مأزق بين اسلاميين يقدمون السياسة على الدين، وآخرون يتبنون موقفًا معاكسًا. البعض الآخر اعتبر المأزق كاشفًا لموقف الإسلاميين من الحرية الفردية وحق الإنسان في الاعتقاد والإيمان، الأمر الذي سلط الضوء على « الوجه المقبض والمعتم» لتلك الفئة من المتدينين الذين يدعون دفاعا عن الاعتدال والديمقراطية والدولة المدنية.... إلخ.
الأهم من تهافت الحجج التي وردت في الكتابات والأغاليط التي تخللتها أن إخواننا هؤلاء لم يروا في الحوار الدائر أي وجه إيجابي. لم يرصدوا فيه الشفافية والموضوعية والانطلاق من الحرص على المصالح العليا للأمة. من خلال الحث على الاحتشاد لمواجهة المخاطر التي تتهددها، ممثلة أساسًا في الاحتلال الإسرائيلى والهيمنة الأمريكية. وهى المسئولية التي تستدعى إما ترحيل ملف الاختلافات المذهبية أو مناقشتها في حدود دوائر أهل العلم، حتى لا تؤثر على وحدة الصف ولا تؤدى إلى بلبلة وتشتيت الرأى العام.
هذا الحوار الذي تركز حول أولويات المرحلة من وجهة النظر الوطنية، وكيفية إدارة الاختلافات السنية الشيعية، تصيده أولئك البعض واعتبروه مناسبة لمواصلة حملة الاغتيال المعنوى والتعبئة المضادة التي تجاهلت تمامًا كل ما قيل عن مصلحة الأمة ودعوات التصدى لأعدائها الحقيقيين. الأمر الذي قدم برهانًا جديدًا على أن معركتهم الحقيقية هي مع الشقيق وليست مع العدو، وأن الأول هو الخصم الحقيقى وليس الثاني. إنهم يفضلونها حربًا أهلية لتصفية حسابات الصراع الفكري، غير مبالين بإشعال الحرائق في السفينة التي تقل الجميع وهى تترنح موشكة على الغرق.
c.v
- ولد عام ١٩٣٧ بإحدى قرى محافظة الجيزة.
- تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٦٠
- استقال من «الأهرام» على إثر منع هذا المقال ومقالات أخرى واستقر الآن في «الشروق».
- صدر له «١٧» كتابًا عن مصر وقضايا العالم الإسلامى.