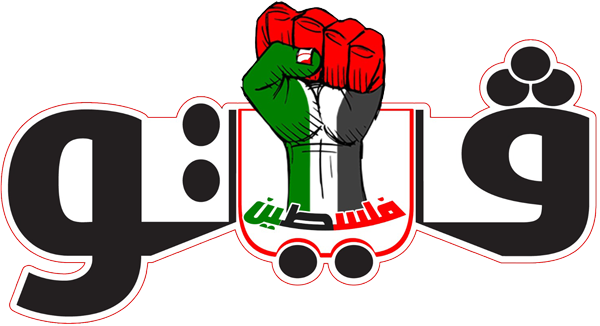جلال أمين يرصد.. أربعة مشاهد مهدت الطريق لـ"يناير".."شيالين المطار".. "تذاكر السينما".. "الموت الجديد".... و"نساء المرأة ثون"

بعد ما يقرب من مرور 300 يوم على ثورة يناير
2011، خرج علينا الكاتب الراحل جلال أمين، بمؤلف جديد من مؤلفاته القيمة، ليتحدث
عن الثورة التي شهدتها مصر، «آمين» لم يكتب أملًا في النضال.. أو هجومًا على
النظام الذي خُلع.. أو حتى تأريخًا لما سبق، لكنه رصد وقائع من الممكن وصفها بـ«الهامشية».
وقائع يرى – من وجهة نظره – أنها كانت أقرب إلى طرق متعددة تؤدي إلى نهاية واحدة.. وهي الثورة على الأوضاع.. واضعًا علامة استفهام كبيرة في نهاية عنوان كتابه الذي كان «ماذا حدث للثورة المصرية؟.. أسباب ثورة 25 يناير 2011 ودواعي الأمل والقلق وآفاق المستقبل».
وفي مقدمة الكتاب قال الكاتب الراحل «مر أكثر من عشرة أشهر على قيام ثورة 25 يناير 2011 في مصر، التي أطاحت بعد أقل من شهر من قيامها، بعهد من أسوأ ما مرّ على مصر من عهود، وهو عهد حسني مبارك، الذي حكم مصر ما يقرب من ثلاثين عامًا، تدهور فيها الاقتصاد المصري، وأحوال المجتمع، ومركز مصر العربي والدولي.
وأشاعت الثورة فرحًا شديدًا بين نفوس المصريين، بنجاحها في التخلص من رأس النظام، والقضاء على فكرة توريث الحكم لابنه، وبزغت آمال قوية في أن يعقب هذا السقوط استئصال النظام من جذوره، ودخول مصر عهدًا جديدًا من النهضة والتقدم، ولكن سرعان ما تكاثرت العثرات على طريق الثورة، فبدأ القلق يتسرب إلى النفوس، والخوف من ألا تتحقق تلك الآمال العظيمة التي بعثتها الثورة».
وفي الباب الأول من الكتاب، والذي اختار له الدكتور «جلال» عنوان «دواعي الثورة» يرصد مشاهد عدة في المجتمع المصري، بدء من بوابة الوصول في مطار القاهرة، ومرورًا ببوابة السينما، وبوابة العمل، وصولًا إلى «بوابة الخروج» التي فتحها فقراء مصر في عرض البحر الأبيض المتوسط، برحلات «القوارب المطاطية» التي تحملهم إلى الجانب الآخر من العالم، على أمل الحصول على وظيفة غير قانونية، بعدما فشلوا في الحصول على وظيفة قانونية في بلادهم.
المشهد الأول.. شيال المطار.. خريج جامعة
كلما عدت إلى مصر، بعد غياب طويل أو قصير، راعني بمجرد أن تطأ قدمي أرض المطار، مظهر أو آخر من مظاهر المجتمع الطبقي، موظفون صغار في انتظار موظفين كبار، شخص يحمل جوازات لمجموعة مهمة من الناس يقوم بتشطيب إجراءات الجوازات بالنيابة عنهم ليخرجوا من المطار قبل غيرهم، أو مستخدمون لدى شركات السياحة، هم في الأغلب خريجو جامعات، لم يجدوا وظيفة أفضل من أن يحملوا اسم شركتهم ليراها الركاب العائدون.. إلخ.
بمجرد أن شرعت في وضع حقائبي في الأوتوبيس الذي يحملنا من المطار إلى موقف السيارات، انشقت الأرض عن شابين، سرعان ما أصبحا ثلاثة، ثم أربعة، يتنافسون على مساعدتي أنا وزوجتي في حمل الحقائب، ثم بمجرد أن وقف الأوتوبيس وشرعت في إنزال حقائب، انشقت الأرض مرة أخرى عن أربعة شبان آخرين يتنافسون على نفس العمل.
لاحظت أن المتنافسين على القيام بهذه المهمة لا يبدو عليهم ما كان يبدو قديمًا على الشيالين في مصر، فثيابهم الآن أفضل، وسنهم أصغر، ولكن الذل البادي على وجوههم أفظع مما كان يبدو على وجوه الشيالين القدامى.
اعتراني كالعادة في مثل هذه المواقف شعور بالذنب، لم أكن أشعر به طوال وجودي بالخارج، فالعائد من دولة أوروبية أو الولايات المتحدة، أو حتى من أي بلد عربي آخر، لا يصادف مثل هذا الموقف أبدًا.
نعم، هناك بالطبع الغني والفقير، ولكن ليس بهذا الشكل. نعم، يمكن تقسيم المجتمع هناك إلى طبقات، ولكن ليس هناك مثل ما تراه في مصر، منذ أول لحظة وصولك إليها، مزايا يحصل عليها علية القوم، ومذلة الطبقة الدنيا.
المجتمع الطبقي قديم جدًا بالطبع، سواء في مصر أو في العالم، ولكنه لم يكن دائما يسبب مثل هذا الشعور بالذنب من ناحية، ولا بكل هذه المرارة من ناحية أخرى، فحتى وقت قريب جدًا، ظل علية القوم يعتقدون بإخلاص أنهم يستحقون ما يعيشون فيه من نعيم، إما لأنهم جنس مختلف، وإما لأنهم من عائلات ممتازة، وإما حتى لمجرد أنهم يملكون أطيانا زراعية شاسعة.
وفي معظم الأحوال كانوا يعتبرون هذا الثراء والتميز عن غيرهم دليلا على رضا الرب عنهم، والطبقة الدنيا ظلت حتى وقت قريب تقبل هذا التفسير وكأنه من المسلمات: «نعم نحن من جنس رديء، أو ولدنا في عائلات وضيعة لا تملك جاهًا ولا أرضًا، مما يدل على غضب الله علينا لسبب أو لآخر».
حدث خلال مائة العام الماضية ما بدد هذه الأفكار أو أضعفها بشدة من الناحيتين: فلا الجنس ولا اللون ولا السلالة ولا التاريخ ولا الدين يمكن أن يبرر هذا التميز الطبقي، والمسألة كلها ظلم في ظلم، والذي زاد الأمر سوءا أن كل شيء أصبح معروفًا: كل الفقراء يعرفون بالضبط كيف يعيش الأغنياء، إن لم يكن بسياراتهم الفارهة في الشوارع، فمن خلال شاشة التلفزيون، بل يعرفون أن علية القوم لم يحصلوا على كل هذا الترف إلا بالنصب.
كان لا بد أن يقوي الشعور بالمرارة في جانب، وبالذنب في الجانب الآخر، حتى لو تظاهر الجميع بغير ذلك.
«أنا أعرف جيدًا كيف حصلت على أموالك أو منصبك».. هكذا يقول القابعون في أسفل السلم في أنفسهم، بينما يعرف الآخرون، وإن لم يفصحوا عن ذلك قط، أنهم في الأساس محتالون، لم يحصلوا على مراكزهم إلا بالقوة أو بالنصب.
في مناخ كهذا، ليس غريبًا أن تنمو أشياء كثيرة مما نضج منه بالشكوى، أنواع جديدة وغريبة من الجرائم، التحرش الجنسي، والتعصب، والتشنج الديني.
المشهد الثاني.. أسرى "بقشيش السينما والحمام"
لم يكن الموقف جديدًا عليّ، ولكني أشعر بصدمة كلما صادفته، وكأنني أصادفه لأول مرة.
شابان يقفان عند مدخل باب السينما، لا يزيد عمر أي منهما على الثلاثين، ووظيفتهما التأكد من أنك تحمل تذكرة الدخول، وربما رافقك أحدهما إلى داخل الصالة ليريك مقعدك.
ليس في هذا أي شيء غريب، ولكن الصدمة جاءت من طريقة معاملتهما لنا، أنا وزوجتي، بمجرد أن أعطيتهما التذكرتين. بدا من أول كلمة نطقا بها أنهما لا يفكران إلا في البقشيش.
كنا قد وصلنا قبل بدء الفيلم بنصف ساعة، فإذا بهما يعرضان علينا أن نجلس في المقهى التابع للسينما، ويعدان بأنهما سيأتيان لإخبارنا بمجرد حلول موعد الدخول. استسخفت الطريقة المهينة التي كانا يتكلمان بها.
ووجدت الموقف قبيحًا جدا: شابان وسيمان، يرتديان بدلتين أنيقتين (لا بد أن إدارة السينما اشترطت ذلك)، ويقبلان أن يتسولا البقشيش بهذه الطريقة، ما إن مشيت خطوتين أخريين حتى اعترض سيري شاب آخر، له نفس المظهر، وبجانبه فتاة محجبة تعاونه في عمله. فما هذا العمل يا ترى؟ إنه يعرض عليّ أن أشترك في مسابقة لم أفهم فحواها بالضبط، ولكني فهمت من كلامه أنني إذا نجحت في المسابقة فسوف أحصل على هدية.
بعد أن استعدت هدوئي، رجعت إلى أحد الشابين اللذين استقبلاني عند دخولي، وسألته بضعة أسئلة:
ما الذي يقصده هذا الشاب الذي يعرض عليّ هدية؟
- إنه مندوب شركة سياحية تحاول أن تروج لنشاطها، وهذه المسابقة والهدية جزءان من عملية الترويج.
-سألته: أي كلية تخرجت فيها (إذ كنت متيقن أنه حاصل على شهادة جامعية).
- قال: إن معه شهادة في الحاسب الآلي.
- وزميلك؟
- خريج تجارة إنجليزي.
- هل أنت متزوج؟
- نعم ولي طفلان، أحدهما عمره سنتان، والأخرى عمرها ستة أشهر.
-هل تقيم مع أسرتك؟
- لا، نعيش في شقة بالإيجار.
- وما قيمة الإيجار؟
-أربعمائة وخمسون جنيها.
- لا تغضب مني إن سألتك عن مرتبك.
- مائتا جنيه.
- وهل تعمل زوجتك؟
- كيف تعمل ولنا طفلان في هذه السن؟ وإذا افترضنا أن خرجت زوجتي للعمل، فمتى نتقابل، وأنا أعمل من الرابعة بعد الظهر إلى الثانية عشرة ليلًا؟
- هل لك وظيفة أخرى في الصباح؟
- لا، لأنهم أحيانا يطلبون منا العمل في الصباح بدلا من المساء.
هكذا اتضحت لي أهمية البقشيش. ليس فقط أهميته، بل إنه مسألة حياة أو موت. هل من المستغرب إذن أن يقابلني هو وزميله، بهذه الطريقة المهينة؟ تركته وذهبت إلى دورة المياه. رأيت رجلًا آخر واقفًا على الباب ينتظر وصولي. هذا الرجل يختلف عن الآخر فى العمر، ولكنه لا يختلف عنه في الشعور بالذل.
كان أكبر سنًا وأكثر هزالًا، ويفصح وجهه عن سوء التغذية. كان هذا المنظر أيضا مألوفًا لي، ولكنه يصيبني كلما رأيته بشعور ممض لا يخلو من غضب. ليس غضبًا من الرجل ولكن مما اضطره إلى الوقوف هذه الوقفة، لم يكن المسكين يعرف ما الذي يمكنه أن يصنع، وما الخدمة التي يمكن أن يقدمها لي في هذا المكان لكي يحصل على مكافأة.
ولكنه يعرف أهمية حصوله على هذه المكافأة التي لا يفعل أي شيء لاستحقاقها. هل هذا بالضبط سبب الشعور بالذل المرسوم على وجهه؟ خمنت أن هذا الرجل لا يحصل على أي مرتب على الإطلاق، فإذا كان صاحب السينما قد تعطف على زميله بمائتي جنيه، فالأرجح أنه عرض على هذا الرجل الخيار بين وظيفة بلا مرتب، أو عدم التعيين على الإطلاق، فقبل أملًا في عطف الزبائن.
هذه الظاهرة منتشرة الآن في مصر أكثر بكثير مما نظن. وظائف لا بد أن عددها الآن يصل إلى ملايين، في القطاع المسمى بالخدمات. بائع لسلة أو لخدمة، يعرف أن المشتري يتوقع أن يحصل منه على خدمة صغيرة إضافية، كصاحب السيارة الذي يتوقع في محطة البنزين أن يأتي من يملأ سيارته بالوقود بدلا من أن يملأها بنفسه، أو زبون السوبرماركت الذي يتوقع أن يساعده أحد في وضع ما اشتراه في أكياس، أو أن يحملها له إلى سيارته، بدلًا من أن يحملها بنفسه، أو النزيل في الفندق الذي يريد أن يأتي من يحمل له حقائبه، أو الصاعد إلى قطار ويريد من يدله على مقعده.. إلخ.
ولكن البائع لا يريد أن يتحمل أجر من يقوم بهذه الخدمة، إذ إنه يعرف أن المجتمع فيه ملايين من المتبطلين الباحثين عن أي عمل، فيستغل ضعفهم بأن يخيرهم بين أن يقوموا بهذه الأعمال بلا أجر (أو بأجر تافه للغاية)، ويعتمدون على شطارتهم في التعامل مع الزبون، وبين أن يظلوا متبطلين.
هذه الظاهرة المنتشرة الآن في مصر ليست ظاهرة قديمة، إذا لم تعرفها مصر (بأي درجة ملحوظة) لا في عصر الملكية، ولا في عهد عبد الناصر، ولا في عصر السادات. كانت الظاهرة المنتشرة في عصر الملكية هو ما يسميه الاقتصاديون بـ«البطالة المقنعة».. رجال يعملون بأقل كثيرًا من قدراتهم، ولكنهم لا يعملون كوسطاء بين البائع والمشتري.
هكذا كان حال العمالة الزائدة عن الحاجة في الريف المصري، وحال الباعة المتجولين أو ماسحي الأحذية في المدن.
مشهد بلا عنوان
كلما فتحت النافذة في منزلي في الصباح رأيت شابًا في نحو الخامسة والعشرين. أعراف تاريخ حياته جيدا لطول ما التقيت به في هذا الشارع الذي أسكنه. أعرف أن أباه فعل المستحيل لكي يتم الولد دراسته الثانوية، ثم لكي يدخل الجامعة حتى حصل على بكالوريوس تجارة.
الآن بعد أن فعل هذا الشاب هو وأبوه المستحيل للحصول على وظيفة تلائم مؤهلاته، انتهى إلى الاشتغال بمسح التراب عن السيارات الرائعة المرصوصة أمام العمارة المقابلة، وأمله معلق، كآمال الرجال الذين وصفتهم حالًا، بكرم أصحاب السيارات.
ولكن هذا الكرم أمر غير موثوق به، ولا يمكن تقديره بدقة، ومن ثم لا يمكن التعويل عليه في اتخاذ قرار بالزواج أو عدمه، فهناك حاجات أهم وأكثر إلحاحا، منها إرسال بعض ما يكسبه إلى أمه الباقية في الصعيد.
المشهد الثالث.. المصريون وطريقة جديدة للموت
هذه طريقة جديدة للموت، لم يعرفها المصريون إلا منذ عشرين عامًا على الأكثر، وهي أن تدفع بضعة آلاف من الجنيهات لشخص متخصص في تهريب الأنفار إلى إيطاليا أو اليونان، ثم تركب سيارة، مع مجموعة من اليائسين أمثالك، تعبر بك الحدود إلى ليبيا، ومنها تركب مركبًا مطاطيًا مع نحو 14 شخصًا آخرين تأخذك إلى نقطة قريبة من الساحل الإيطالي أو اليوناني، وهناك تترك القارب وتعتمد على نفسك بالعوم إلى الشاطئ، في مكان يأمل أن تكون فيه حراسة الشواطئ ضعيفة، فتخترق نقاط الحراسة وتجد نفسك في دولة فيها فرص للعمل غير القانوني، بعكس مصر التي ليس فيها فرص للعمل القانوني أو غير القانوني.
المشكلة أن القارب المطاطي ضعيف أمام أي هياج في البحر المتوسط، وعادة ما يحمّله المهربون بأكثر من طاقته من أنفار، ومن ثم فاحتمال الغرق قبل الوصول إلى شاطئ إيطاليا أو اليونان كبير، وقد تكرر حدوث هذا الغرق عدة مرات في السنوات القليلة الماضية.
أقول إن هذه طريقة جديدة على المصريين للموت، وأنا أقصد بالطبع فقراء المصريين، إذ إن الأثرياء من المصريين ومتوسطي الحال لا يموتون بهذه الطريقة، فهم إذا أرادوا الذهاب إلى إيطاليا أو إلى اليونان ركبوا الطائرة أو الباخرة. والطريقة حديثة على فقراء المصريين لأن هؤلاء اعتادوا أن يموتوا في بيوتهم جوعًا وكمدًا، أو في الطريق العام نتيجة حوادث الأتوبيسات أو الميكروباصات، بسبب سوء حالة الفرامل، أو بسبب الإرهاق الشديد الذي يصيب السائق من طول ساعات العمل أو من مشقة القيادة في الطرق المصرية.
وحتى إذا مات فقراء المصريين غرقًا، فالمعتاد أن يغرقوا في عّبارة سيئة الصيانة أو غير صالحة للملاحة أصلا. أما أن يموت فقراء المصريين غرقًا في قارب مطاطي غير معد لعبور البحر الأبيض المتوسط فهذا هو الجديد حقا. ولكنه ليس الشيء الوحيد الجديد في هذا النوع من الموت.
هناك شيء آخر مهم، وهو أن فقراء المصريين الذين يموتون بهذه الطريقة ليسوا في العادة من الأميين، بل إن كثيرين منهم حاصلون على شهادة جامعية، ولم يتمكنوا برغم هذه الشهادة (بل وربما بسببها) من الحصول على عمل لائق وبمرتب معقول.
الأميون من المصريين إذا تركوا قراهم وقرروا الهجرة إلى خارج مصر نادرًا ما يذهبون إلى غير بلاد الخليج أو ليبيا، ومن ثم فهم نادرًا ما يتعرضون لخطر الغرق بالقرب من شاطئ دولة أوروبية. الظاهرة إذن مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنمو ظاهرة البطالة بين خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة منذ نحو عشرين عامًا، فهؤلاء هم الذين يشعرون بفجوة مؤلمة بين طموحاتهم التي قواها ما حصلوا عليه من تعليم، وبين واقعهم المزري وعجزهم عن تحقيق أبسط مطالبهم: وظيفة معقولة ومسكن يسمح لهم بالزواج.
المشهد الرابع "نساء نادي 6 أكتوبر وماراثون الهانم"
إنني أفهم أن يحب شخص امرأة بعينها أو رجلا بعينه، أما أن يحب «الإنسانية» كلها فأمر تحيط به الشبهات، ذلك أن الإنسان بطبعه، فيما أظن، يجد من الأسهل أن يوجه عواطفه إلى إنسان معين من أن يوجهها إلى مجردات «كالإنسانية جمعاء» أو «الحرية للجميع» أو «النساء عن بكرة أبيهم».. إلخ.
فإذا زعم أحد أنه لا يحب شخصا بعينه ولكنه يحب الناس جميعا، فإن من حقنا أن نشك في صدقه حتى يأتي بالديل، وقد عرفت في حياتي اشتراكيين وشيوعيين من هذا النوع، كثيرو الكلام عن كراهيتهم «استغلال الإنسان لأخيه الإنسان» وعن تعاطفهم البالغ مع «الكادحين» أو «المعذبين في الأرض»، ثم أجدهم يستغلون زوجاتهم أو أصدقاءهم أبشع استغلال.
كان منهم أيضا من لا يرد إلىّ الكتب التي استعارها مني، مع وعد قاطع بإعادتها، فأنا في نظرهم «برجوازي مستغل» لا يستحق الرحمة، وإنما الذين يستحقون الرحمة هم فقط «الكادحون». ليس كادحًا بعينه، بل الكادحون بوجه عام.
وأذكر أنني قرأت في مقال للفيلسوف البريطاني برتراند رسل وصفًا لمقابلته مع الزعيم الشيوعي لينين بعد نجاح ثورته في روسيا، وكان لينين يصف له ما فعلته الثورة الاشتراكية بملاك الأراضي الكبار الذين صادرت الثورة أراضيهم.
فقال رسل إنه فوجئ ودهش دهشة عظيمة عندما لمح على وجه لينين في أثناء حديثه عما فعلته الثورة بهؤلاء الملاك، ملامح قسوة بالغة، لم يستطع رسل أن يوفق بينها وبين ذلك التعاطف الشديد الذي كان لينين يتكلم عنه نحو فقراء الفلاحين.
تذكرت هذا وذاك عندما قرأت أخبارا عن العذاب الذي تعرضت له مجموعة من النساء يعملن كموظفات بمركز شباب مدينة 6 أكتوبر، إذا صدر قرار من وكيل وزارة الشباب بالجيزة بإلغاء انتدابهن للمركز عقابًا لهن على عدم تنفيذ بعض الأوامر المشددة بالحضور إلى إستاد القاهرة في يوم معين.
كان لهؤلاء السيدات أعذار وجيهة لم يلتفت إليها وكيل الوزارة. فمثلا ناهد عبد الحكيم لم تنفذ الأمر بسبب الحمل، وناهد عبد الخالق لديها طفل رضيع وتعاني شلل الأطفال، وهناك أعذار مماثلة لإيمان عبد الله وسهام صبري وربيعة ياسين وداليا عبد القادر وأحلام محمود وفاطمة سيد.. إلخ.
أما المناسبة التي دعت وزارة الشباب إلى إصدار هذه الأوامر المشددة بالحضور، والتي اضطرت هذه المجموعة من النساء البائسات إلى مخالفتها، فهي إقامة الماراثون النسائي للجري والمشي (والذي كتب اسمه بالعربية هكذا: مرأة.. ثون) والذي تقدمته السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية.
وقد وصفت جريدة الأهرام أهداف الماراثون بأنها جزء من أهداف حركة سوزان الدولية للمرأة من أجل السلام، ومن بينها «دعم مشاركة المرأة في عملية صنع السلام، وتوفير مجتمعات آمنة تكفل الأمان للمرأة والطفل».
وقائع يرى – من وجهة نظره – أنها كانت أقرب إلى طرق متعددة تؤدي إلى نهاية واحدة.. وهي الثورة على الأوضاع.. واضعًا علامة استفهام كبيرة في نهاية عنوان كتابه الذي كان «ماذا حدث للثورة المصرية؟.. أسباب ثورة 25 يناير 2011 ودواعي الأمل والقلق وآفاق المستقبل».
وفي مقدمة الكتاب قال الكاتب الراحل «مر أكثر من عشرة أشهر على قيام ثورة 25 يناير 2011 في مصر، التي أطاحت بعد أقل من شهر من قيامها، بعهد من أسوأ ما مرّ على مصر من عهود، وهو عهد حسني مبارك، الذي حكم مصر ما يقرب من ثلاثين عامًا، تدهور فيها الاقتصاد المصري، وأحوال المجتمع، ومركز مصر العربي والدولي.
وأشاعت الثورة فرحًا شديدًا بين نفوس المصريين، بنجاحها في التخلص من رأس النظام، والقضاء على فكرة توريث الحكم لابنه، وبزغت آمال قوية في أن يعقب هذا السقوط استئصال النظام من جذوره، ودخول مصر عهدًا جديدًا من النهضة والتقدم، ولكن سرعان ما تكاثرت العثرات على طريق الثورة، فبدأ القلق يتسرب إلى النفوس، والخوف من ألا تتحقق تلك الآمال العظيمة التي بعثتها الثورة».
وفي الباب الأول من الكتاب، والذي اختار له الدكتور «جلال» عنوان «دواعي الثورة» يرصد مشاهد عدة في المجتمع المصري، بدء من بوابة الوصول في مطار القاهرة، ومرورًا ببوابة السينما، وبوابة العمل، وصولًا إلى «بوابة الخروج» التي فتحها فقراء مصر في عرض البحر الأبيض المتوسط، برحلات «القوارب المطاطية» التي تحملهم إلى الجانب الآخر من العالم، على أمل الحصول على وظيفة غير قانونية، بعدما فشلوا في الحصول على وظيفة قانونية في بلادهم.
المشهد الأول.. شيال المطار.. خريج جامعة
كلما عدت إلى مصر، بعد غياب طويل أو قصير، راعني بمجرد أن تطأ قدمي أرض المطار، مظهر أو آخر من مظاهر المجتمع الطبقي، موظفون صغار في انتظار موظفين كبار، شخص يحمل جوازات لمجموعة مهمة من الناس يقوم بتشطيب إجراءات الجوازات بالنيابة عنهم ليخرجوا من المطار قبل غيرهم، أو مستخدمون لدى شركات السياحة، هم في الأغلب خريجو جامعات، لم يجدوا وظيفة أفضل من أن يحملوا اسم شركتهم ليراها الركاب العائدون.. إلخ.
بمجرد أن شرعت في وضع حقائبي في الأوتوبيس الذي يحملنا من المطار إلى موقف السيارات، انشقت الأرض عن شابين، سرعان ما أصبحا ثلاثة، ثم أربعة، يتنافسون على مساعدتي أنا وزوجتي في حمل الحقائب، ثم بمجرد أن وقف الأوتوبيس وشرعت في إنزال حقائب، انشقت الأرض مرة أخرى عن أربعة شبان آخرين يتنافسون على نفس العمل.
لاحظت أن المتنافسين على القيام بهذه المهمة لا يبدو عليهم ما كان يبدو قديمًا على الشيالين في مصر، فثيابهم الآن أفضل، وسنهم أصغر، ولكن الذل البادي على وجوههم أفظع مما كان يبدو على وجوه الشيالين القدامى.
اعتراني كالعادة في مثل هذه المواقف شعور بالذنب، لم أكن أشعر به طوال وجودي بالخارج، فالعائد من دولة أوروبية أو الولايات المتحدة، أو حتى من أي بلد عربي آخر، لا يصادف مثل هذا الموقف أبدًا.
نعم، هناك بالطبع الغني والفقير، ولكن ليس بهذا الشكل. نعم، يمكن تقسيم المجتمع هناك إلى طبقات، ولكن ليس هناك مثل ما تراه في مصر، منذ أول لحظة وصولك إليها، مزايا يحصل عليها علية القوم، ومذلة الطبقة الدنيا.
المجتمع الطبقي قديم جدًا بالطبع، سواء في مصر أو في العالم، ولكنه لم يكن دائما يسبب مثل هذا الشعور بالذنب من ناحية، ولا بكل هذه المرارة من ناحية أخرى، فحتى وقت قريب جدًا، ظل علية القوم يعتقدون بإخلاص أنهم يستحقون ما يعيشون فيه من نعيم، إما لأنهم جنس مختلف، وإما لأنهم من عائلات ممتازة، وإما حتى لمجرد أنهم يملكون أطيانا زراعية شاسعة.
وفي معظم الأحوال كانوا يعتبرون هذا الثراء والتميز عن غيرهم دليلا على رضا الرب عنهم، والطبقة الدنيا ظلت حتى وقت قريب تقبل هذا التفسير وكأنه من المسلمات: «نعم نحن من جنس رديء، أو ولدنا في عائلات وضيعة لا تملك جاهًا ولا أرضًا، مما يدل على غضب الله علينا لسبب أو لآخر».
حدث خلال مائة العام الماضية ما بدد هذه الأفكار أو أضعفها بشدة من الناحيتين: فلا الجنس ولا اللون ولا السلالة ولا التاريخ ولا الدين يمكن أن يبرر هذا التميز الطبقي، والمسألة كلها ظلم في ظلم، والذي زاد الأمر سوءا أن كل شيء أصبح معروفًا: كل الفقراء يعرفون بالضبط كيف يعيش الأغنياء، إن لم يكن بسياراتهم الفارهة في الشوارع، فمن خلال شاشة التلفزيون، بل يعرفون أن علية القوم لم يحصلوا على كل هذا الترف إلا بالنصب.
كان لا بد أن يقوي الشعور بالمرارة في جانب، وبالذنب في الجانب الآخر، حتى لو تظاهر الجميع بغير ذلك.
«أنا أعرف جيدًا كيف حصلت على أموالك أو منصبك».. هكذا يقول القابعون في أسفل السلم في أنفسهم، بينما يعرف الآخرون، وإن لم يفصحوا عن ذلك قط، أنهم في الأساس محتالون، لم يحصلوا على مراكزهم إلا بالقوة أو بالنصب.
في مناخ كهذا، ليس غريبًا أن تنمو أشياء كثيرة مما نضج منه بالشكوى، أنواع جديدة وغريبة من الجرائم، التحرش الجنسي، والتعصب، والتشنج الديني.
المشهد الثاني.. أسرى "بقشيش السينما والحمام"
لم يكن الموقف جديدًا عليّ، ولكني أشعر بصدمة كلما صادفته، وكأنني أصادفه لأول مرة.
شابان يقفان عند مدخل باب السينما، لا يزيد عمر أي منهما على الثلاثين، ووظيفتهما التأكد من أنك تحمل تذكرة الدخول، وربما رافقك أحدهما إلى داخل الصالة ليريك مقعدك.
ليس في هذا أي شيء غريب، ولكن الصدمة جاءت من طريقة معاملتهما لنا، أنا وزوجتي، بمجرد أن أعطيتهما التذكرتين. بدا من أول كلمة نطقا بها أنهما لا يفكران إلا في البقشيش.
كنا قد وصلنا قبل بدء الفيلم بنصف ساعة، فإذا بهما يعرضان علينا أن نجلس في المقهى التابع للسينما، ويعدان بأنهما سيأتيان لإخبارنا بمجرد حلول موعد الدخول. استسخفت الطريقة المهينة التي كانا يتكلمان بها.
ووجدت الموقف قبيحًا جدا: شابان وسيمان، يرتديان بدلتين أنيقتين (لا بد أن إدارة السينما اشترطت ذلك)، ويقبلان أن يتسولا البقشيش بهذه الطريقة، ما إن مشيت خطوتين أخريين حتى اعترض سيري شاب آخر، له نفس المظهر، وبجانبه فتاة محجبة تعاونه في عمله. فما هذا العمل يا ترى؟ إنه يعرض عليّ أن أشترك في مسابقة لم أفهم فحواها بالضبط، ولكني فهمت من كلامه أنني إذا نجحت في المسابقة فسوف أحصل على هدية.
بعد أن استعدت هدوئي، رجعت إلى أحد الشابين اللذين استقبلاني عند دخولي، وسألته بضعة أسئلة:
ما الذي يقصده هذا الشاب الذي يعرض عليّ هدية؟
- إنه مندوب شركة سياحية تحاول أن تروج لنشاطها، وهذه المسابقة والهدية جزءان من عملية الترويج.
-سألته: أي كلية تخرجت فيها (إذ كنت متيقن أنه حاصل على شهادة جامعية).
- قال: إن معه شهادة في الحاسب الآلي.
- وزميلك؟
- خريج تجارة إنجليزي.
- هل أنت متزوج؟
- نعم ولي طفلان، أحدهما عمره سنتان، والأخرى عمرها ستة أشهر.
-هل تقيم مع أسرتك؟
- لا، نعيش في شقة بالإيجار.
- وما قيمة الإيجار؟
-أربعمائة وخمسون جنيها.
- لا تغضب مني إن سألتك عن مرتبك.
- مائتا جنيه.
- وهل تعمل زوجتك؟
- كيف تعمل ولنا طفلان في هذه السن؟ وإذا افترضنا أن خرجت زوجتي للعمل، فمتى نتقابل، وأنا أعمل من الرابعة بعد الظهر إلى الثانية عشرة ليلًا؟
- هل لك وظيفة أخرى في الصباح؟
- لا، لأنهم أحيانا يطلبون منا العمل في الصباح بدلا من المساء.
هكذا اتضحت لي أهمية البقشيش. ليس فقط أهميته، بل إنه مسألة حياة أو موت. هل من المستغرب إذن أن يقابلني هو وزميله، بهذه الطريقة المهينة؟ تركته وذهبت إلى دورة المياه. رأيت رجلًا آخر واقفًا على الباب ينتظر وصولي. هذا الرجل يختلف عن الآخر فى العمر، ولكنه لا يختلف عنه في الشعور بالذل.
كان أكبر سنًا وأكثر هزالًا، ويفصح وجهه عن سوء التغذية. كان هذا المنظر أيضا مألوفًا لي، ولكنه يصيبني كلما رأيته بشعور ممض لا يخلو من غضب. ليس غضبًا من الرجل ولكن مما اضطره إلى الوقوف هذه الوقفة، لم يكن المسكين يعرف ما الذي يمكنه أن يصنع، وما الخدمة التي يمكن أن يقدمها لي في هذا المكان لكي يحصل على مكافأة.
ولكنه يعرف أهمية حصوله على هذه المكافأة التي لا يفعل أي شيء لاستحقاقها. هل هذا بالضبط سبب الشعور بالذل المرسوم على وجهه؟ خمنت أن هذا الرجل لا يحصل على أي مرتب على الإطلاق، فإذا كان صاحب السينما قد تعطف على زميله بمائتي جنيه، فالأرجح أنه عرض على هذا الرجل الخيار بين وظيفة بلا مرتب، أو عدم التعيين على الإطلاق، فقبل أملًا في عطف الزبائن.
هذه الظاهرة منتشرة الآن في مصر أكثر بكثير مما نظن. وظائف لا بد أن عددها الآن يصل إلى ملايين، في القطاع المسمى بالخدمات. بائع لسلة أو لخدمة، يعرف أن المشتري يتوقع أن يحصل منه على خدمة صغيرة إضافية، كصاحب السيارة الذي يتوقع في محطة البنزين أن يأتي من يملأ سيارته بالوقود بدلا من أن يملأها بنفسه، أو زبون السوبرماركت الذي يتوقع أن يساعده أحد في وضع ما اشتراه في أكياس، أو أن يحملها له إلى سيارته، بدلًا من أن يحملها بنفسه، أو النزيل في الفندق الذي يريد أن يأتي من يحمل له حقائبه، أو الصاعد إلى قطار ويريد من يدله على مقعده.. إلخ.
ولكن البائع لا يريد أن يتحمل أجر من يقوم بهذه الخدمة، إذ إنه يعرف أن المجتمع فيه ملايين من المتبطلين الباحثين عن أي عمل، فيستغل ضعفهم بأن يخيرهم بين أن يقوموا بهذه الأعمال بلا أجر (أو بأجر تافه للغاية)، ويعتمدون على شطارتهم في التعامل مع الزبون، وبين أن يظلوا متبطلين.
هذه الظاهرة المنتشرة الآن في مصر ليست ظاهرة قديمة، إذا لم تعرفها مصر (بأي درجة ملحوظة) لا في عصر الملكية، ولا في عهد عبد الناصر، ولا في عصر السادات. كانت الظاهرة المنتشرة في عصر الملكية هو ما يسميه الاقتصاديون بـ«البطالة المقنعة».. رجال يعملون بأقل كثيرًا من قدراتهم، ولكنهم لا يعملون كوسطاء بين البائع والمشتري.
هكذا كان حال العمالة الزائدة عن الحاجة في الريف المصري، وحال الباعة المتجولين أو ماسحي الأحذية في المدن.
مشهد بلا عنوان
كلما فتحت النافذة في منزلي في الصباح رأيت شابًا في نحو الخامسة والعشرين. أعراف تاريخ حياته جيدا لطول ما التقيت به في هذا الشارع الذي أسكنه. أعرف أن أباه فعل المستحيل لكي يتم الولد دراسته الثانوية، ثم لكي يدخل الجامعة حتى حصل على بكالوريوس تجارة.
الآن بعد أن فعل هذا الشاب هو وأبوه المستحيل للحصول على وظيفة تلائم مؤهلاته، انتهى إلى الاشتغال بمسح التراب عن السيارات الرائعة المرصوصة أمام العمارة المقابلة، وأمله معلق، كآمال الرجال الذين وصفتهم حالًا، بكرم أصحاب السيارات.
ولكن هذا الكرم أمر غير موثوق به، ولا يمكن تقديره بدقة، ومن ثم لا يمكن التعويل عليه في اتخاذ قرار بالزواج أو عدمه، فهناك حاجات أهم وأكثر إلحاحا، منها إرسال بعض ما يكسبه إلى أمه الباقية في الصعيد.
المشهد الثالث.. المصريون وطريقة جديدة للموت
هذه طريقة جديدة للموت، لم يعرفها المصريون إلا منذ عشرين عامًا على الأكثر، وهي أن تدفع بضعة آلاف من الجنيهات لشخص متخصص في تهريب الأنفار إلى إيطاليا أو اليونان، ثم تركب سيارة، مع مجموعة من اليائسين أمثالك، تعبر بك الحدود إلى ليبيا، ومنها تركب مركبًا مطاطيًا مع نحو 14 شخصًا آخرين تأخذك إلى نقطة قريبة من الساحل الإيطالي أو اليوناني، وهناك تترك القارب وتعتمد على نفسك بالعوم إلى الشاطئ، في مكان يأمل أن تكون فيه حراسة الشواطئ ضعيفة، فتخترق نقاط الحراسة وتجد نفسك في دولة فيها فرص للعمل غير القانوني، بعكس مصر التي ليس فيها فرص للعمل القانوني أو غير القانوني.
المشكلة أن القارب المطاطي ضعيف أمام أي هياج في البحر المتوسط، وعادة ما يحمّله المهربون بأكثر من طاقته من أنفار، ومن ثم فاحتمال الغرق قبل الوصول إلى شاطئ إيطاليا أو اليونان كبير، وقد تكرر حدوث هذا الغرق عدة مرات في السنوات القليلة الماضية.
أقول إن هذه طريقة جديدة على المصريين للموت، وأنا أقصد بالطبع فقراء المصريين، إذ إن الأثرياء من المصريين ومتوسطي الحال لا يموتون بهذه الطريقة، فهم إذا أرادوا الذهاب إلى إيطاليا أو إلى اليونان ركبوا الطائرة أو الباخرة. والطريقة حديثة على فقراء المصريين لأن هؤلاء اعتادوا أن يموتوا في بيوتهم جوعًا وكمدًا، أو في الطريق العام نتيجة حوادث الأتوبيسات أو الميكروباصات، بسبب سوء حالة الفرامل، أو بسبب الإرهاق الشديد الذي يصيب السائق من طول ساعات العمل أو من مشقة القيادة في الطرق المصرية.
وحتى إذا مات فقراء المصريين غرقًا، فالمعتاد أن يغرقوا في عّبارة سيئة الصيانة أو غير صالحة للملاحة أصلا. أما أن يموت فقراء المصريين غرقًا في قارب مطاطي غير معد لعبور البحر الأبيض المتوسط فهذا هو الجديد حقا. ولكنه ليس الشيء الوحيد الجديد في هذا النوع من الموت.
هناك شيء آخر مهم، وهو أن فقراء المصريين الذين يموتون بهذه الطريقة ليسوا في العادة من الأميين، بل إن كثيرين منهم حاصلون على شهادة جامعية، ولم يتمكنوا برغم هذه الشهادة (بل وربما بسببها) من الحصول على عمل لائق وبمرتب معقول.
الأميون من المصريين إذا تركوا قراهم وقرروا الهجرة إلى خارج مصر نادرًا ما يذهبون إلى غير بلاد الخليج أو ليبيا، ومن ثم فهم نادرًا ما يتعرضون لخطر الغرق بالقرب من شاطئ دولة أوروبية. الظاهرة إذن مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنمو ظاهرة البطالة بين خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة منذ نحو عشرين عامًا، فهؤلاء هم الذين يشعرون بفجوة مؤلمة بين طموحاتهم التي قواها ما حصلوا عليه من تعليم، وبين واقعهم المزري وعجزهم عن تحقيق أبسط مطالبهم: وظيفة معقولة ومسكن يسمح لهم بالزواج.
المشهد الرابع "نساء نادي 6 أكتوبر وماراثون الهانم"
إنني أفهم أن يحب شخص امرأة بعينها أو رجلا بعينه، أما أن يحب «الإنسانية» كلها فأمر تحيط به الشبهات، ذلك أن الإنسان بطبعه، فيما أظن، يجد من الأسهل أن يوجه عواطفه إلى إنسان معين من أن يوجهها إلى مجردات «كالإنسانية جمعاء» أو «الحرية للجميع» أو «النساء عن بكرة أبيهم».. إلخ.
فإذا زعم أحد أنه لا يحب شخصا بعينه ولكنه يحب الناس جميعا، فإن من حقنا أن نشك في صدقه حتى يأتي بالديل، وقد عرفت في حياتي اشتراكيين وشيوعيين من هذا النوع، كثيرو الكلام عن كراهيتهم «استغلال الإنسان لأخيه الإنسان» وعن تعاطفهم البالغ مع «الكادحين» أو «المعذبين في الأرض»، ثم أجدهم يستغلون زوجاتهم أو أصدقاءهم أبشع استغلال.
كان منهم أيضا من لا يرد إلىّ الكتب التي استعارها مني، مع وعد قاطع بإعادتها، فأنا في نظرهم «برجوازي مستغل» لا يستحق الرحمة، وإنما الذين يستحقون الرحمة هم فقط «الكادحون». ليس كادحًا بعينه، بل الكادحون بوجه عام.
وأذكر أنني قرأت في مقال للفيلسوف البريطاني برتراند رسل وصفًا لمقابلته مع الزعيم الشيوعي لينين بعد نجاح ثورته في روسيا، وكان لينين يصف له ما فعلته الثورة الاشتراكية بملاك الأراضي الكبار الذين صادرت الثورة أراضيهم.
فقال رسل إنه فوجئ ودهش دهشة عظيمة عندما لمح على وجه لينين في أثناء حديثه عما فعلته الثورة بهؤلاء الملاك، ملامح قسوة بالغة، لم يستطع رسل أن يوفق بينها وبين ذلك التعاطف الشديد الذي كان لينين يتكلم عنه نحو فقراء الفلاحين.
تذكرت هذا وذاك عندما قرأت أخبارا عن العذاب الذي تعرضت له مجموعة من النساء يعملن كموظفات بمركز شباب مدينة 6 أكتوبر، إذا صدر قرار من وكيل وزارة الشباب بالجيزة بإلغاء انتدابهن للمركز عقابًا لهن على عدم تنفيذ بعض الأوامر المشددة بالحضور إلى إستاد القاهرة في يوم معين.
كان لهؤلاء السيدات أعذار وجيهة لم يلتفت إليها وكيل الوزارة. فمثلا ناهد عبد الحكيم لم تنفذ الأمر بسبب الحمل، وناهد عبد الخالق لديها طفل رضيع وتعاني شلل الأطفال، وهناك أعذار مماثلة لإيمان عبد الله وسهام صبري وربيعة ياسين وداليا عبد القادر وأحلام محمود وفاطمة سيد.. إلخ.
أما المناسبة التي دعت وزارة الشباب إلى إصدار هذه الأوامر المشددة بالحضور، والتي اضطرت هذه المجموعة من النساء البائسات إلى مخالفتها، فهي إقامة الماراثون النسائي للجري والمشي (والذي كتب اسمه بالعربية هكذا: مرأة.. ثون) والذي تقدمته السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية.
وقد وصفت جريدة الأهرام أهداف الماراثون بأنها جزء من أهداف حركة سوزان الدولية للمرأة من أجل السلام، ومن بينها «دعم مشاركة المرأة في عملية صنع السلام، وتوفير مجتمعات آمنة تكفل الأمان للمرأة والطفل».