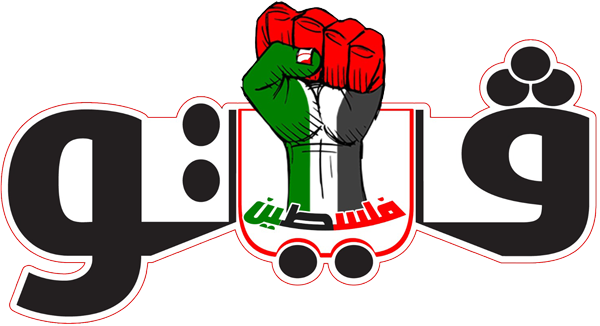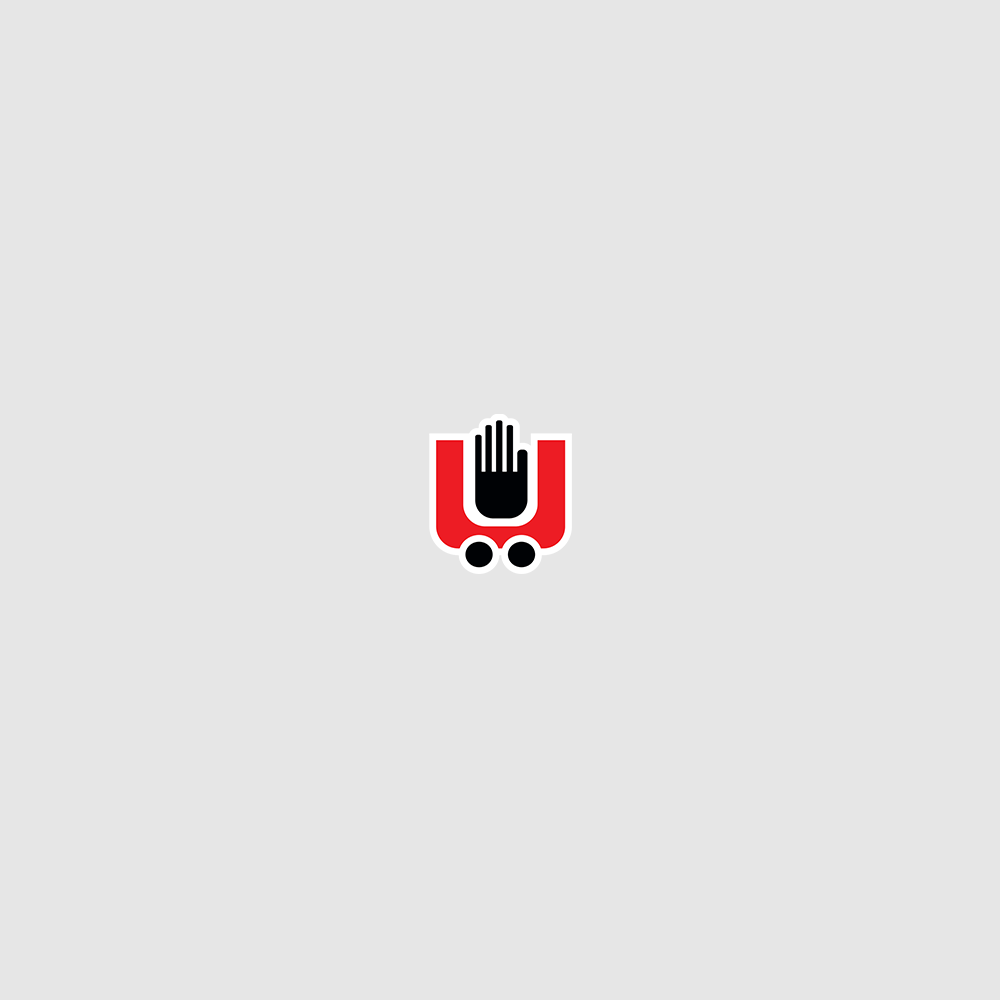بين الإفساد والإصلاح
شهدت صفحات الصحف وشاشات التلفاز في الأسابيع الماضية نقاشات وحوارات مطولة حول المستشفيات الجامعية، بعضها كان أطرافه ممن عملوا أو يعملون فيها، وبعضهم لهم خبرات بوضع تلك المستشفيات في الدول المرجعية، لكن ممن سمعتهم أو قرأت لهم من لا نعلم لهم أي سابقة عمل أو خبرة أو حتى مجرد اهتمام بتلك المستشفيات، وجاءت أقوالهم ومقالاتهم بمفردات واحدة، تتحدث عن ملكية كليات الطب لهذه المستشفيات، والحفاظ على ما أسموه مجانية العلاج فيها..
وكلام كثير مفاده أن التزام أعضاء هيئة التدريس بالعمل في المستشفيات الجامعية يهدمها، وأن تواجد الأساتذة بشكل دائم ليلا ونهارا وتحملهم مسئوليات محددة في المستشفيات بجوار تلاميذهم ومتدربيهم يمنع التعليم الطبى، وأن تفرغ الأساتذة للعمل بالمستشفيات يؤدى إلى توقف البحث العلمى!
ولن أعيد مناقشة منطقية ذلك الطرح لأنه يبدو جليا أمام أي محايد منصف، وقد كتبت فيه من قبل في مقال أسميته "الفساد في المستشفيات الجامعية"، والذي تسبب في إغضاب البعض من زملائى وأساتذتى حتى اعتبرنى نفر منهم خائنا، واعتبروا قبولى لمبدأ تحديد مسئوليات العمل في المستشفيات والرقابة والمحاسبة هو بمثابة موافقة منى على المس بكرامة الأساتذة، وأنا الذي كنت أرفع دائما شعار الكرامة أولا.
وقد يعلم كثير من الزملاء ويشهد المنصفون منهم على أننى لم أقبل أيا من النسخ السابقة للقانون والتي تواترت منذ بدأ التفكير في مشكلة المستشفيات الجامعية في عام ٢٠٠٨، بسبب أساسي وهو ضرورة التأكد من التوازن بين الحقوق والواجبات والأجر مقابل ممارسة المهنة، وتحمل مخاطرها ومسئولياتها حتى استطعنا بعد جهد جهيد الوصول إلى الصيغة المتوازنة التي صدر بها القانون، وهي التي نصت عليها المادة ١٤ "يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والعلاجية والبحثية مقابل أجر، وذلك كله على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية".
ورغم أن القانون ١٩ لسنة ٢٠١٨ طرح لأول مرة حلولا لأهم مشكلات المستشفيات الجامعية، وهى التمويل فنص على مصادره من الموازنة العامة ومن التعاقدات والتبرعات واستثمار الأرصدة وشدد على منع التعاقد بأقل من سعر تكلفة الخدمة الحقيقى وهو ما كان من أهم أسباب تدهور وخسائر المستشفيات، حيث كان التعاقد يتم مع التأمين الصحى ونفقة الدولة بأسعار تقل كثيرا عن التكلفة الفعلية مما أدى إلى تناقص المستهلكات والأدوية وجودة الخدمة وتعثر الصيانة والتطوير وطول قوائم الانتظار.
وكان إيجاد علاقة رسمية واضحة لأول مرة بين أعضاء هيئة التدريس والمستشفيات وهى علاقة الالتزام بعمل محدد مقابل أجر محدد هو بداية إصلاح ما أفسده الدهر، والعمل المجاني بنظام اقتسام الوقت الذي أدى إلى أن تعيين بعض كليات الطب أضعاف ما تحتاج المستشفيات من قوة بشرية للعمل فيها دون مقابل، مما أثر بالسلب على التعليم والتدريب والبحث، بل ووضع الأساتذة أنفسهم.
حيث أصبحت رواتبهم لا تليق أبدا بمكانتهم العلمية ولا تكفى لإعالة أسرهم وتدفعهم دفعا إلى ارتياد العمل الخاص بمشاكله ومغرياته التي لا تتناسب مع شموخ العلماء. لم يعد للأستاذ مكان يستطيع أن يجلس فيه ليعمل ويبحث، ولم يعد لديه مساعدون في مهامه العلمية والبحثية والتعليمية.
تسبب النظام الفاسد في الانتقاص من مكانة العلماء وصارت ضغوط الحياة عليهم أقوى من البحث عن تلك الحقوق واستعادة تلك المكانة.
وصرت أقرأ وأسمع كلاما لا علاقة له بالعلم أو الواقع، حيث لا توجد كلية طب في العالم تقوم على إدارة أي مستشفى أو يتولى عميده سلطة تلك الإدارة، ولا يوجد مستشفى في العالم يتزايد قوة العمل فيه سنويا دون النظر إلى قدرتها الاستيعابية، أو حتى الحد الأدنى المطلوب من الممارسة الطبية للعاملين بها للحفاظ على مهاراتهم بل وترخيص مزاولة المهنة لكل منهم.
ثم نأتى لقواعد التعليم الطبى الحديث التي تمنع أن تكون جهة التدريب هي نفس جهة الرقابة على تنفيذ برنامج التدريب وهى نفس جهة تقييم إتمام التدريب، فقد انتهت دول العالم أجمع إلى أن الفصل التام بين المراحل الثلاث مطلوب وأساسي ليكون هناك تدريب حقيقى، وصار التدريب التخصصى يجرى في كل المستشفيات التي تعتمد للتدريب وبواسطة مدربين معتمدين وتحت رقابة لصيقة ومستمرة من جهاز رقابى مسئوليته التأكد من تنفيذ البرنامج التدريبى، ثم يكون تنظيم امتحان موحد على المستوى القومى يتغير الممتحنون فيه كل عام ويخضع لقواعد علمية دقيقة لضمان المستوى المطلوب ومنع تذبذب هذا المستوى بين الأعوام.
توقفت كل جامعات العالم عن منح درجات بحثية كالماجستير والدكتوراه على أنها درجات تخصصية إكلينيكية تمنحها كل جامعة على حدة دون رقابة محايدة لتنفيذ البرامج التدريبية أو توحيد قياسي لبرامج التدريب وطرق التقييم وتستبدلتها ببرامج تدريب عيارية ومؤسسات مسئولة عن التدريب في كل بلد (البورد أو الزمالة).
لقد تأخرنا عشرات السنين عن الركب العالمى فلم يعد هناك تعليم تلقينى في كليات الطب وانتهى عصر المحاضرات والدروس الخصوصية منذ زمن بعيد، وتحول التعليم كليا إلى إكساب المهارات بالتدريب العملى على أيدي أساتذة بنظام اليوم الكامل وطوال أيام الأسبوع، وصار الأساتذة مسئولين فقط عن طلبة الكلية إضافة إلى المطلوب منهم سنويا من إنتاج بحثى حقيقى يضيف إلى العلم ويطرح حلولا للمشكلات وإجابات على الأسئلة العلمية ويلبى احتياجات المجتمع.
وزادت المجتمعات من تقديرها للعلماء فاهتمت بهم مادية ومعنويا ووفرت لهم سبل التفرغ للتعليم والبحث ضمانا لاستمرار تطوير العلوم وتقدم الإنسانية.
هناك مقاومة كبيرة لدى البعض ممن تتعارض مصالحهم أو عقيدتهم السياسية مع محاولات الإصلاح سواء توحيد برامج التدريب أو التوحيد القياسي لمستوى الخريجين، عن طريق امتحان الترخيص أو تجديد ترخيص مزاولة المهنة للتأكد من الحفاظ على المهارات وضمان الأمان للمرضى، وحتى تطبيق التأمين الصحى الشامل والذي تضمن إصلاح النظام الصحي بإنشاء هيئة الرعاية الصحية التي من المفترض أن تضم كل المستشفيات المملوكة للدولة كما هو في معظم الدول الغربية لتحقيق التكامل بينها ومنع الفساد وإهدار المال العام وتحقيق المفادة الإدارية.
إن الأصوات التي تتعالى من وقت إلى آخر في محاولة لمنع الإصلاح أو عرقلته خاصة عندما تأتى من سياسيين مقنعين يحاولون الترويج لأفكارهم الأيديولوجية عن الملكية والمجانية، والانفصام عن العلم الحديث في الإدارة الطبية واقتصاديات الصحة والتعليم الطبي إنما هم يلعبون دور محامي الشيطان الذي يستغل مقاومة الإصلاح، وخوف البعض من تأثر مصالحه بتطبيق النظم الحديثة أو تقليل سلطاته ومظاهر سيطرته التي قد تكون موجودة حاليا، لكنى على ثقة أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح وأن عجلة التاريخ لا تعود للوراء وأن مصر ستلحق بركب الحضارة الإنسانية بتطور التعليم وإصلاح النظام الصحى.