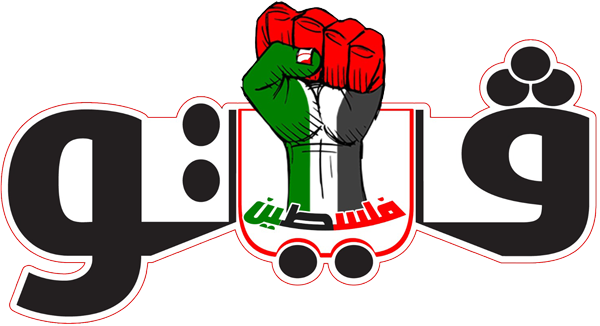في 14 نقطة.. تحديات تهدد الموارد المائية في أفريقيا

رغم أن القارة الأفريقية تعد أغنى القارات من الناحية المائية لوجود أنهار وأمطار ومياه جوفية بها، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود تحديات تواجه الأمن المائي للقارة السمراء.
وفي 14 نقطة يوضح الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الأفريقية، تلك التحديات، وطبيعتها والأخطار التي قد تترتب عليها.
1- النمو السريع لسكان القارة الأفريقية بمعدل 3% سنويا، حيث بلغ في عام 2010 نحو 1030 مليون نسمة ثم إلى 1136 مليون نسمة عام 2014، إلى أن بلغ 1300 مليون نسمة في منتصف عام 2018.
2- عدم تجانس توزيع الأمطار مكانيًا، فهناك ندرة في المناطق الصحراوية ووفرة في الوسط والغرب.
3- التوزيع الزمني غير المتجانس أيضًا لمياه الأمطار، وتتركز الأمطار في كثير من الدول الأفريقية في فصل مطري واحد، كما أنها أيضًا متذبذبة من عام إلى آخر.
4- التوزيع غير المتجانس أيضًا للمياه السطحية، حيث تحتوي دولة واحدة فقط على أكثر من ثلث موارد القارة المائية المتجددة سنويًا.
5- البخر الشديد الذي يسود معظم الدول الأفريقية، والذي يصل إلى أكثر من 80% نتيجة ارتفاع متوسط درجات حرارة الهواء، وانخفاض الرطوبة النسبية وزيادة ساعات السطوع الشمسي.
6- تهديد التغيرات المناخية، فالقارة الأفريقية شأنها شأن باقى القارات، معرضة للتأثر بالتغيرات المناخية خلال العقود المقبلة، سواء بالسلب أو بالإيجاب، وهذه التغيرات تشمل جفاف في مناطق، يقابلها أمطار في مناطق أخرى.
وانقسمت الرؤى والسيناريوهات إلى ما يؤيد نقص الموارد المائية في المستقبل، مسترشدين بموجات الجفاف التي تجتاح بعض المناطق العالمية، مثلما حدث في بحيرة تشاد، والتي تراجعت بنسبة 95% خلال الخمسين عاما الأخيرة، نتيجة قلة الأمطار والاستخدام الجائر للمياه، كما أن مياه الأمطار قد ازدادت في بعض المناطق الأخرى مثل منابع نهر النيل الإثيوبية في نهاية القرن الماضي.
7- الطبيعة الجيولوجية وقلة الأمطار ساعدا على انتشار المسطحات الصحراوية والكثبان الرملية خاصة في شمال أفريقيا، وناميبيا وصحراء كالهارى في الجنوب.
8- الاستخدام الجائر للمياه في أفريقيا خاصة في مجال الزراعة الذي يستهلك 82% من المياه المتاحة، 13% للأغراض المنزلية، 5% للصناعة.
9- ما زالت طرق الري التقليدية «الري السطحي» هي السائدة في الزراعة المروية الأفريقية، فعلى سبيل المثال في مصر معظم الأراضى المزروعة حاليا، تروى بنظام الرى السطحى. فالمساحة المزروعة حاليا من الأراضى القديمة والجديدة نحو 8 ملايين فدان، منها نحو 6 ملايين فدان تزرع بنظام الري السطحى، حيث يستخدم المزارعون مياها أزيد من احتياجاتهم، ويفقد جزء كبير من مياه الرى عن طريق البخر والرشح.
10- استخدام المياه في الممارسات الزراعية الخاطئة مثل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في الأراضي الصحراوية، التي تعد استنزافًا للموارد المائية، كما يحدث في زراعة الأرز في دلتا النيل وبعض الواحات المصرية، وكذلك قصب السكر في وادي النيل في مصر والسودان، وبالتالي تدني إنتاجية وحدة المياه بسبب عدم كفاءة استخدامها.
11- تلوث المجاري المائية «الأنهار وقنوات الري» نتيجة إعادة مياه الصرف الزراعي الملوثة بالأملاح ومبيدات الآفات والحشائش، أو مياه الصرف الصحي غير المعالج بطريقة سليمة إلى النظام المائي في حالة غير قابلة للاستعمال، أو مياه التعدين والصرف الصناعى.
12- زيادة ملوحة المياه الجوفية غير المتجددة عن طريق السحب الجائر الذي يؤدي أيضًا إلى انخفاض منسوب الماء الجوفي واختلاطها بالمياه المالحة كما هو الحال في المناطق الساحلية.
13- ضعف البنية التحتية في معظم الدول الأفريقية يؤثر على جودة الحصول على المياه، وإدارة الصرف الصحي، وإنتاج الطاقة الكهرومائية، وكفاءة الري، وتخزين المياه، وعدم التحكم في آثار الفيضانات.
14- إزالة الغابات في دول المنابع للتوسع الزراعى أو الحصول على أخشاب يؤدى إلى انتشار التصحر وتغير نمط البخر والأمطار.