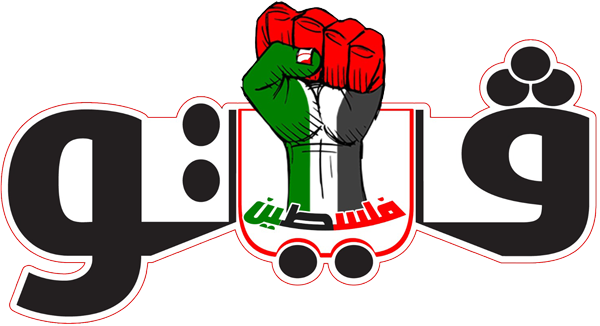ومن جهة أخرى!
الطبيعي أن تكون هناك وجهات نظر متعددة في كل ما يتعلق بالنشاط الإنساني ما لم يكن هناك نص مقدس واضح لا يحتمل التأويل، ثم إن فلسفة الكون قائمة على التوازن، بمعنى أن كل خلق الله زوجين بدءا من الرجل والمرأة والأرض والسماء والجبال والبحار فكل ما حولنا اثنين إلا الله الواحد الأحد، وفِي هذا قيل إن الشرك في السياسة ذروة الإيمان..
لأن الحياة الأحادية لا تستقيم وفشلت كل التجارب الأحادية ذات الرأي الواحد والحزب الواحد وكادت أن تندثر، وما بقي منها طور نفسه في صيغ متعددة وبدا من معظم التجارب أن الشعوب المقهورة لا تبدع ولا تتقدم ولا تنتج، وعندما تغيرت واقتربت من التعددية وفكت قيودها أصبحت قوى كبرى، وفِي الصين وروسيا أكبر برهان، ولعل الفرق بين الكوريتين يكمن في الانفتاح والديمقراطية والنمط الرأسمالي ومنح الإنسان أدنى حقوقه في الاختيار بين بدائل متعددة..
ومن المدهش أن يمنح الله عباده حرية الإيمان أو الكفر ويأتي من يفرض على الإنسان نمطه السياسي والفكري والحزبي وفِي هذا يدهشنا القرآن في قول الله تعالى (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين) وفِي أية أخرى (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض).
وقد ناضل كثيرون عبر آلاف السنين للارتقاء بالإنسان ومنحه الحرية كأعظم ما يميزه عن بقية المخلوقات والأمر، هكذا فإن المعارضة الوطنية هي الوجه الآخر للنظام، وهي جزء منه وليست عدوة ولا جماعات من الخونة والعملاء كما يظن بعض ولاة الأمر، ممن توقف إدراكهم عند عصر مضى، وربما كانت أولويات الفترة الماضية تحتم على صانع القرار منح استقرار المؤسسات وتحويل شبه الدولة لدولة الأهمية، وربما كانت الظروف الخانقة اقتصاديا واجتماعيا تستدعي تأجيل الإصلاح السياسي ريثما تستعيد الدولة عافيتها وتخرج من الرعاية الحرجة التي كانت في أمس الحاجة إليها..
لكن حان الوقت لبدء عملية الإصلاح السياسي بنفس منطق وآليات الإصلاح الاقتصادي، بمعنى أن يكون التأسيس على معايير سليمة تتجنب كل خطايا الماضي وأول تلك الخطوات أن يكون إنشاء الأحزاب شعبيا من القاعدة وليس من السلطة أو بتوجيهات منها، حتى لا تعيد إنتاج الماضي الذي أوصل بلدا عريقا بحجم مصر لهذا الوضع المتردي، ثم إن تجربة أحزاب السلطة كلها فشلت في أي اختبار تعرضت له وكانوا يقولون لنا إن عضوية الحزب الوطني ثلاثة ملايين تلاشت تماما أمام عدة آلاف من الإخوان في الانتخابات وفِي السيطرة على ميادين مصر خلال انتفاضة ٢٥ يناير..
ولهذا فإن أي محاولات لتشكيل حزب للأغلبية وآخر للمعارضة قد تبدو متسرعة، وربما يكون من الملائم الانتظار لما ستُفرزه الانتخابات المحلية من كوادر وقوى سياسية يمكن أن تعطي مؤشرات حقيقية للأوضاع السياسية في الشارع، ويرتبط بذلك إعادة النظر في الأداء الإعلامي وتنظيمة باحتراف ومهنية، ووضع الكفاءات في المواقع القومية، بحيث يكون إعلام الدولة هو القاطرة التي تقود الإعلام الخاص، وليس العكس..
مع منح المساحة المعقولة لوجهة النظر الأخرى لتعمل دون قلق أو خوف لأن الصوت الواحد والمبالغة في التأييد أفقد الجميع المصداقية أمام القارئ والمشاهد مما يخلق فراغا يملؤه للأسف الإعلام المعادي لكل ما هو مصري، ومن المعلوم أنه كلما زادت مساحات الحرية وتعددت الآراء اختفى الإعلام المعادي، ولم يعد للشائعات مكان وبنفس المنطق كلما تعددت منصات الحوار زادت فرص التعبير والتغيير السلمي بمعنى مؤسسات الدولة هي القادرة على امتصاص التوتر والقلق وإتاحة البدائل بقدرتها على تسويق رؤية وخطط النظام.
وجاء وقت علينا كانت النقابات المهنية والجامعات بجوار الأحزاب والقوى السياسية تدير المشهد السياسي وتوفر الفرص لتخفيف الاحتقان وتقديم البدائل، وفِي الوقت نفسه ترشيح الكوادر المؤهلة للبرلمان والمحليات، لكنها للأسف اختفت فجأة كلها مرة واحدة، وبدا أن الحياة السياسية في حالة موت سريري بعد أن كانت مصر كلها تُمارس السياسة ليل نهار وعلى شاشات الفضائيات، وظهور مئات الائتلافات والرغبة في إنشاء الأحزاب والترشح والمشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وفجأة وبفعل فاعل اندثرت كل هذه المظاهر وهو ما يدعو للقلق..
لأن الانتقال من درجة الغليان للتجمد السياسي مؤشرا على أن ما تم في هذا البلد عبر السنوات السابقة كان مخططا، وأن هناك من كان يدير المشهد بالريموت كنترول، وإننا كأمة كنا نعيش كومبارس في مسلسل عبثي، أو أن للممارسة السياسية مواسم في حياة المصريين كالبراكين التي تفور مرة واحدة وتقذف بالحمم في كل إتاحة ثم ما تلبث أن تنحصر وتهدأ، وفِي كل الأحوال يبدو أن هناك شيئا غير مريح..
وإن العلاج الوحيد هو العودة للفطرة السياسية بالممارسة اليومية المنضبطة، وفتح نوافذ الحوار والاشتباك بالرؤى حتى لا نظل أسرى الغرف المغلقة بالهواء الآسن، نريد وجهات نظر متعددة وأحزاب متعددة كما نص الدستور، نريد حرية منضبطة دون أوصياء أو بصاصين حتى لا نعيد إنتاج الماضي، وكأننا لا نتعلم أبدا مما جرى خاصة إذا كان البركان يفور ويقترب من الانفجار.