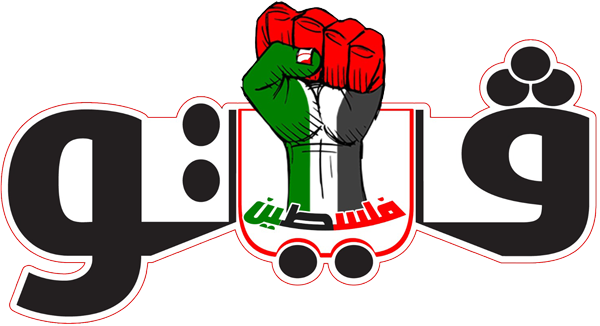حكايات من دفتر الفوضى
يبدو أن الأشخاص المنضبطين مثلي لا خيار لهم في بلد قال عنها رئيسها إنها شبه دولة، سوى أن تصاب بـ"الاكتئاب" أو أن تكون فوضويًا أو تتعايش مع الفوضى، ساعتها ستشعر أنك لم تعد تسبح ضد التيار.
الحكاية باختصار تبدأ منذ نحو ست سنوات عندما قررت العودة من الغربة بدولة الإمارات اعتقادًا منى أن بلدنا بعد ثورة يناير أصبحت بصدد مناخ مختلف، يفتح آفاقًا أفضل للحياة فيها، فور عودتي صدمتني حالة الفوضى والانفلات السلوكي في الشوارع، بحيث أصبح الذهاب والعودة للعمل خصوصًا بالسيارة رحلة عذاب يومية، تفوق طاقة احتمال البشر، اتخذت القرار واخترت راحتي لا مهنتي، وقاطعت النزول ولزمت بيتي تجنبًا لما يصدر عني من انفعالات وتوترات لا يحمد على صحتي عقباها من سوء سلوك البشر، الذي طفح على السطح وفوضى المرور والزحام والسير العكسي والشوارع الخانقة والتكاتك.
غير أن ملازمتي لسكني في مكان قالوا عنه إنه "كمبوند" ومقاطعتي النزول لم يحميني من الأذى، ولم يوفر لي حقي في حياة هادئة، فالضرر يطالك حتى وأنت "كانن" في بيتك، ومنذ ست سنوات وأنا أصارع طوفان الإزعاج في معارك يومية دفاعًا عن ما كنت أعتقد أنه حق ويأست من تحقيقه.
فالمكان الذي كان يفترض أن يكون راقيًا أصبح بسبب غياب الدولة والقانون أقرب للأحياء الشعبية، تملأه التكاتك التي يقودها البلطجية والأطفال المشردون بدون رادع، ولأن كل أعمال البناء مخالفة أو "شمال" كما يقولون، فقد تم بناء خمس قطع أراضي فضاء حول عمارتي، وجميعها تتم فجرًا بما يصاحبها من أعمال صب الخرسانة وصوت رافعات الطوب والخبط والرزع، وما إن ننتهي من عذاب العمارة حتى تبدأ مرحلة عذاب تشطيب الشقق، المثير للدهشة أن العمال يبدأون عملهم المزعج في الخامسة صباحًا، ويغادرون عند الحادية عشر صباحًا، ولا يبدأون من العاشرة صباحًا إلى السادسة مساءً كما ينص القانون، وكأن هناك من يحرضهم أو يدفع لهم مكافأة لإيقاظ النائمين فجرًا.
اعتقدت أننا في دولة بها قانون ولجأت لسلطاتها لكي تمنع الإزعاج قبل التاسعة صباحًا كما هو متبع في كل الدول المحترمة، غير أن السلطة المعنية بكل أسف لم تعد تتحرك إلا في بلاغات القتل، وأصبحت تقابل بلاغات الإزعاج بالسخرية، باعتبارها نوعًا من الترف والرفاهية لا يجوز الالتفات إليها.
قررت أن أنزل بنفسي أكثر من مرة فجرًا إلى حيث أعمال الإزعاج وأواجه العمال، وأطلق صرخة استغاثة لعل الجيران المتضررين مثلي يسمعون صوتي وينزلون من بيوتهم ليتضامنوا معي ونوقف هذا الإزعاج المتكرر، ولكن الكل يراك ويهز رأسه ثم ينصرف وكأن الأمر لا يعنيه، لم أسلم بالطبع من تجاوزات العمال اللفظية من نوعية "أعلى ما في خيلك اركبه"، وعندما تهددهم باستدعاء الشرطة يبتسمون ابتسامة سخرية، مشفقين على ذلك الكائن الغريب الذي يتوهم أن البلد فيها شرطة، حتى انتابني شعور بأنني شخص خارج معطيات الزمن.
منذ 6 سنوات وأنا أنصح الجيران الذين يأوون الكلاب التي تنبح ليلًا كالميكروفون بالتخلص منها، لأنها بلا فائدة سوى إزعاجنا، تارة بالحسنى والمعروف وتارة أخرى بالترجي والاسترضاء والاستعطاف، وما زالت الكلاب تنبح.
منذ 6 سنوات وأنا أمارس واجبي في استيقاف سائقي الميكروفونات المتحركة المسماة بـ "التكاتك" ونصحهم بالحسنى والذوق بعدم تشغيل أغاني الـ "دي جي" لأن صوتها يزعج السكان.. ولا فائدة.
منذ 6 سنوات وأنا أنصح بائعي أنابيب البوتاجاز والباعة الجائلين بعدم الإزعاج في السابعة صباحًا.. ولا فائدة.
منذ 6 سنوات وأنا أنصح جيراني الذين ينتهكون حرمة الطريق والذين يركنون سياراتهم عمودي على الرصيف لأنهم يضيقون الشوارع، بحيث إذا مرت سيارتان متقابلتان لا يتسع لهما الطريق ويضطر أحدهما للرجوع إلى الخلف ليسمح بمرور السيارة المقابلة، وكانت النتيجة أن هناك من ينظر إليك باعتبارك كائنًا غريبًا يتدخل فيما لا يعنيه.
عداك عن مواكب الزفاف التي تخترق حاجز السكون ليلًا على طريقة "زوار الفجر" مصحوبة بطلقات نارية وكلاكسات توقظ كل النائمين، وسارينات إنذار السيارات والموتسيكلات المزعجة التي تنطلق بدون سبب في أوقات مبكرة ومتأخرة من الليل، وغيرها الكثير من أشكال الإزعاج التي لا يتسع المجال لذكرها.
حذرت في السابق وسأظل أحذر من خطورة تغييب دور الشرطة المجتمعية أو شرطة "إنفاذ القانون"، في مصر، لأنه لا معنى ولا جدوى لأي قوانين رادعة سيتم تشريعها في البرلمان، لإعادة الانضباط لسلوك الفوضويين في هذا البلد طالما أن السلطة المعنية بتنفيذها ما زالت في إجازة طويلة.
لقد وصلت إلى مرحلة الكفر بأننا نعيش في دولة، لأنها باختصار سقطت في كل اختبارات إثبات وجودها وفشلت في رفع الضرر عن أكثرية منضبطة في مواجهة أقلية منفلتة، فقدت الأمل في تغيير أي شيء، تجمعت بداخلي طاقة غضب كبرى من تعمد الدولة تجاهل هذه البجاحة المتناهية للبلطجية، وما يمارسونه من إيذاء متعمد للآخرين وعدم اتخاذها العقاب الرادع، وكلما استيقظت فجرًا على أصوات إزعاج، التزم الصمت تجنبًا لحرق دمي، لأنني باختصار اقتنعت أنها صارت غابة وليست دولة، وأن الشكوى للشرطة مذلة والكلام مع الفوضويين إهانة و"قلة قيمة".
وأخيرًا.. إذا كانت حالة اللادولة أو شبه الدولة واضحة للجميع.. لماذا لا يستدعي الرئيس السيسي وزير الداخلية ويوجهه بعودة حقيقية ومخلصة لشرطة إنفاذ القانون، وإنهاء حالة الفوضى المجتمعية والسلوكية الصارخة والواضحة للجميع، فرجل الشرطة له كل الاحترام والتقدير طالما أنه يطبق القانون، وكما قلت في السابق "خذوا حريتي وامنحوني دولة قانون".