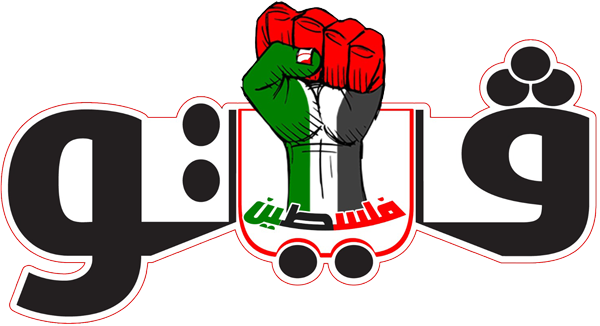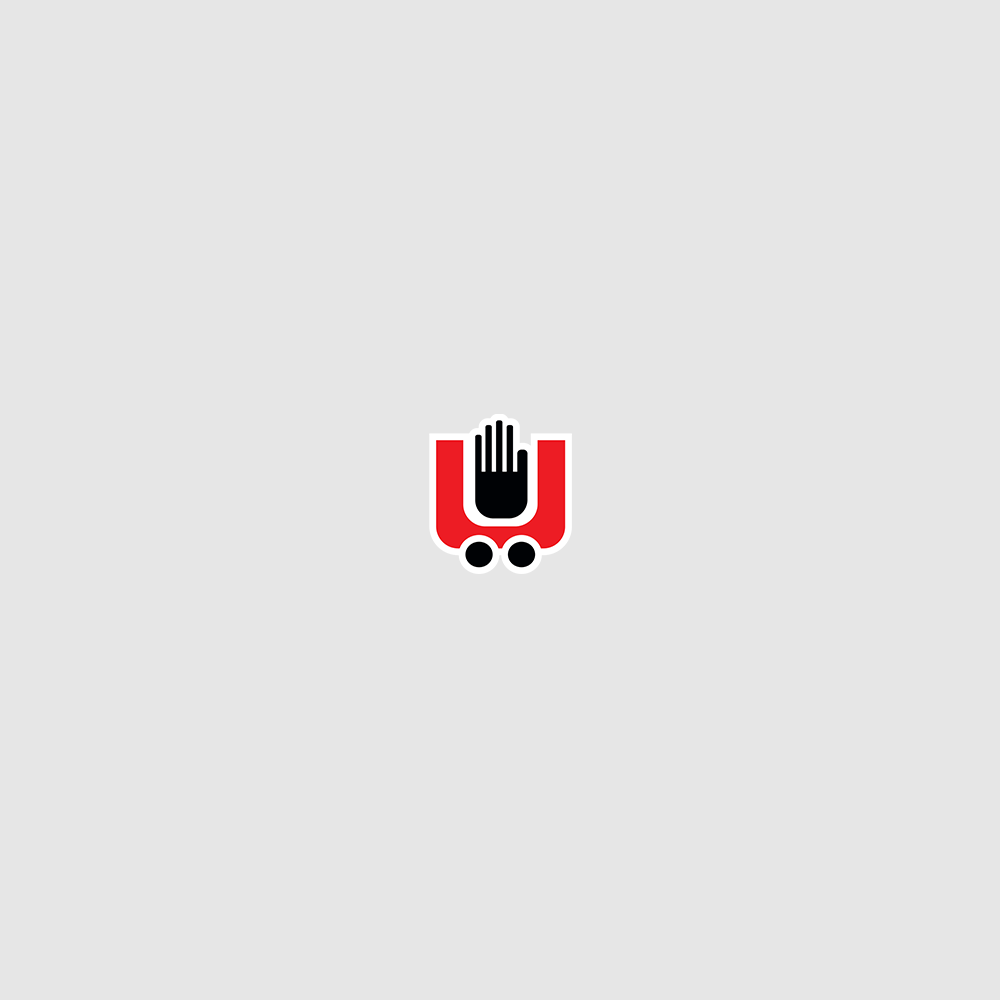مين يعمل إيه؟
أظهرت الأيام الماضية أن الفساد صار ثقافة في مصر، فقد تضافرت عوامل تدهور التعليم وغياب التخطيط والرقابة لتنتج فوضى عارمة في مختلف جوانب الحياة المصرية.
أرغب قبل أن أبدأ مقالي أن أوجه التحية إلى رجال الرقابة الإدارية الذين ما فتئوا مؤخرا يوجهون ضربات موجعة لأوكار الفساد، وهي التي لن يكون تأثيرها في كشف تلك القضايا فحسب بل في ردع كثير من الفاسدين عن الاستمرار فيما تعودوا على عمله ربما لعشرات السنين.
والفساد في القطاع الطبي من أخطر أنواع الفساد لأنه يرتبط ارتباطا مباشرا بحياة البشر، فالقطاع الطبي قطاع مرغوب ماديا وأدبيا نتيجة الثقافة الخاطئة التي توجه المصريين منذ نعومة أظفارهم للحلم إما بكلية الطب أو بكلية الهندسة، والمسميات الفاسدة كمسمى كليات القمة. ورغم تدهور المردود المادى والأدبي للمهنتين في مصر دونا عن دول العالم بسبب الفساد أيضا والذي جعل العاملين في المؤسسات الإنتاجية والاقتصادية الممولة من المال العام يستولون على القدر الأعظم، وربما كل أرباح تلك المؤسسات على شكل رواتب ومكافآت ومزايا اجتماعية، وتوظيف لأبناء العاملين بدون وجه حق، تاركين من يعملون في المؤسسات الخدمية خاصة الصحة والتعليم والمحليات يستجدون لمحاولة الوصول إلى أقل مستوى معيشي آدمي، في ظل رعاية الدولة لهذا الفساد والتي لم تهتم حتى رغم الضغوط الرهيبة لفاتورة الإصلاح الإقتصادي بتحقيق بعض العدالة في توزيع ناتج استثمار المال العام على كل العاملين بالدولة.
بدأ الفساد في القطاع الصحي بتدهور الخدمة المقدمة في المؤسسات الصحية العامة، واضطرار المرضى إلى اللجوء للمؤسسات الخاصة، التي بدأت بالمؤسسات الخيرية من مستوصفات ومستشفيات، ثم مؤسسات خاصة منخفضة التكاليف من عيادات مجمعة ومراكز ومستشفيات اقتصادية، ثم مراكز ومستشفيات فاخرة.
أدى هذا إلى لجوء المرضى للصيدليات مباشرة في محاولة لتجنب المعاناة الجسدية والمعنوية والمالية، وبدأ الصيادلة ومعاونيهم في تشخيص ووصف العلاج للمرضى في الصيدليات بالمخالفة للقانون الذي يصنف تلك الممارسات كممارسة للطب ممنوعة على غير المرخص لهم بتلك الممارسة، عانى المرضى والمجتمع من تلك الممارسات خاصة مع انعدام الرقابة.
تأثر الأطباء بظاهرة الفرنجة التي بدأت منذ السبعينات باستخدام بعض المفردات غير العربية في محاولات ادعاء الثقافة والتمدن، حيث استخدمت المؤسسات والمحال أسماء أجنبية، وبدأ الأطباء في التخلص من ألقاب طبيب وحكيم وغيرها التي كانت شائعة في النصف الأول من القرن الماضي، ويشهد عليها تراثنا السينمائي والأدبي (مثال أغنية حكيم عيون لعبد الوهاب وأغنية يا طبيب القلب لليلى مراد....إلخ) إلى لقب دكتور، وخاصة أن فيه مساواة بين المتخصصين وغير المتخصصين من الأطباء، رغم ما في ذلك من مخالفة قانونية، نظرا لعدم وجود تلك الكلمة في أي قانون مصري متعلق بالطب سواء تراخيص الأفراد أو المنشآت..
كما أخطأت نقابة الأطباء وما زالت في السماح بكتابة ذلك اللقب في اللافتات وبطاقات العضوية والمكاتبات الرسمية نظرا لرغبة بعض القائمين على إدارتها في الانتفاع الأدبي من تلك المخالفات. واستغلت باقي المهن الطبية والصحية ذلك الخطأ الاستراتيجي الكبير من الأطباء في القيام بالممارسة الطبية استهدافا للمكسب المادي وللمردود الأدبي.
ومع بداية انتشار التعليم الجامعي الخاص في التسعينيات تلقف المستثمرون ذلك وفتحت عشرات كليات الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي الخاصة دون أي تنسيق أو تخطيط أو رقابة حقيقية لضبط أعداد المقبولين وأعداد الخريجين بالنسبة لاحتياجات سوق العمل، والمحافظة على المستوى المادي والاجتماعي والأدبي للخريجين الذين سيحملون أمانة الحفاظ على حياة البشر وجودتها، حتى أضحت مصر أكثر بلاد العالم في نسبة الصيادلة لعدد السكان، وأصبح عدد ممارسي العلاج الطبيعي في مصر ما يقارب أربعة أضعاف عددهم في بريطانيا، ويقارب عددهم في الولايات المتحدة التي يصل تعداد سكانها لأكثر من أربعة أضعاف سكان مصر..
وتستمر محاولات المتربحين في زيادة الإعداد مدعين أن هذا هو الاستثمار، ساعين لتحقيق مزيد من المكاسب المادية ولو بتدمير الوطن، ناهيك عن التأكد من مستوى الخريج في ظل وضع التعليم المصري ككل.
وبدأ الفساد والمكاسب الكبيرة تدفع لزيادة العائد عن طريق زيادة عدة سنوات الدراسة دون سبب لتحقيق الفائدة المزدوجة ماديا ودعما لمحاولات ممارسة الطب دون وجه حق بحجة طول سنوات الدراسة. وفي ظل تلك الفوضى العارمة والانعدام الكامل للرقابة وفي بعض الأحيان الفساد السياسي لم يكن صعبا على آخرين التسلل إلى مجال الممارسة الطبية، والتي حددها قانون ممارسة مهنة الطب بـ"إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأي طريقة كانت.. أو وصف نظارات طبية.. أو بوجه عام ممارسة الطب بأي صفة"..
فأصبحنا نرى خريجي كليات ليس لها علاقة بالصحة يلقبون أنفسهم بألقاب مثل دكتور أو استشاري بعد دورة لأسابيع أو شهور في التغذية أو التجميل أو التخسيس أو التخاطب أو علم النفس أو مكافحة العدوى.. لتفتح لهم أبواب الإعلام بالتوافق والاتفاق على حياة البشر وصحتهم.
أصبحت مراكز التخسيس والتجميل والتغذية وغيرها التي يديرها غير المرخص لهم بذلك ملء السمع والبصر تنصب على المرضى، وتهدم المنظومة الصحية المتهالكة.
إن المشرع كان حكيما في حماية المريض بتحديد نوع الدراسة والترخيص الذي يؤتمن على القيام على صحة الإنسان لكن تضارب المصالح وفساد التعليم وتضخم أعداد بعض المهن عن الحد الأقصى لتناسب تكوين الفريق الطبي واحتياجات المجتمع ونزعة التمرد لبعض أعضاء الفريق ورفضهم الالتزام بدورهم وسعيهم إلى التنافس دون وجه حق بدلا من التكامل والتناغم لتقديم خدمة طبية جيدة دفع البعض إلى محاولة تقنين الوضع الفاسد الحالي باقتراح مشروعات قوانين تكرس للفوضى وتمكن من الممارسة الطبية إلى غير المعدين والمرخص لهم بذلك.
أعلم أن الإصلاح ليس سهلا وأن الفساد في مجتمعنا قد أصبح ثقافة عامة وأن المصالح الشخصية أصبحت هي الغالبة ولو أدت إلى تدمير المجتمع، لكنني واثق أن هناك آخرين مستعدون للعمل سويا وتحمل ضريبة الإصلاح من أجل الوطن.
أصبحت مراكز التخسيس والتجميل والتغذية وغيرها التي يديرها غير المرخص لهم بذلك ملء السمع والبصر تنصب على المرضى، وتهدم المنظومة الصحية المتهالكة.
إن المشرع كان حكيما في حماية المريض بتحديد نوع الدراسة والترخيص الذي يؤتمن على القيام على صحة الإنسان لكن تضارب المصالح وفساد التعليم وتضخم أعداد بعض المهن عن الحد الأقصى لتناسب تكوين الفريق الطبي واحتياجات المجتمع ونزعة التمرد لبعض أعضاء الفريق ورفضهم الالتزام بدورهم وسعيهم إلى التنافس دون وجه حق بدلا من التكامل والتناغم لتقديم خدمة طبية جيدة دفع البعض إلى محاولة تقنين الوضع الفاسد الحالي باقتراح مشروعات قوانين تكرس للفوضى وتمكن من الممارسة الطبية إلى غير المعدين والمرخص لهم بذلك.
أعلم أن الإصلاح ليس سهلا وأن الفساد في مجتمعنا قد أصبح ثقافة عامة وأن المصالح الشخصية أصبحت هي الغالبة ولو أدت إلى تدمير المجتمع، لكنني واثق أن هناك آخرين مستعدون للعمل سويا وتحمل ضريبة الإصلاح من أجل الوطن.