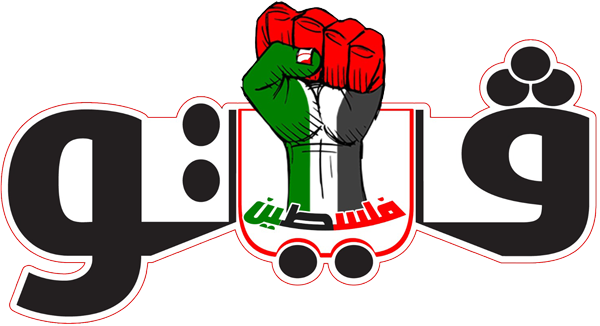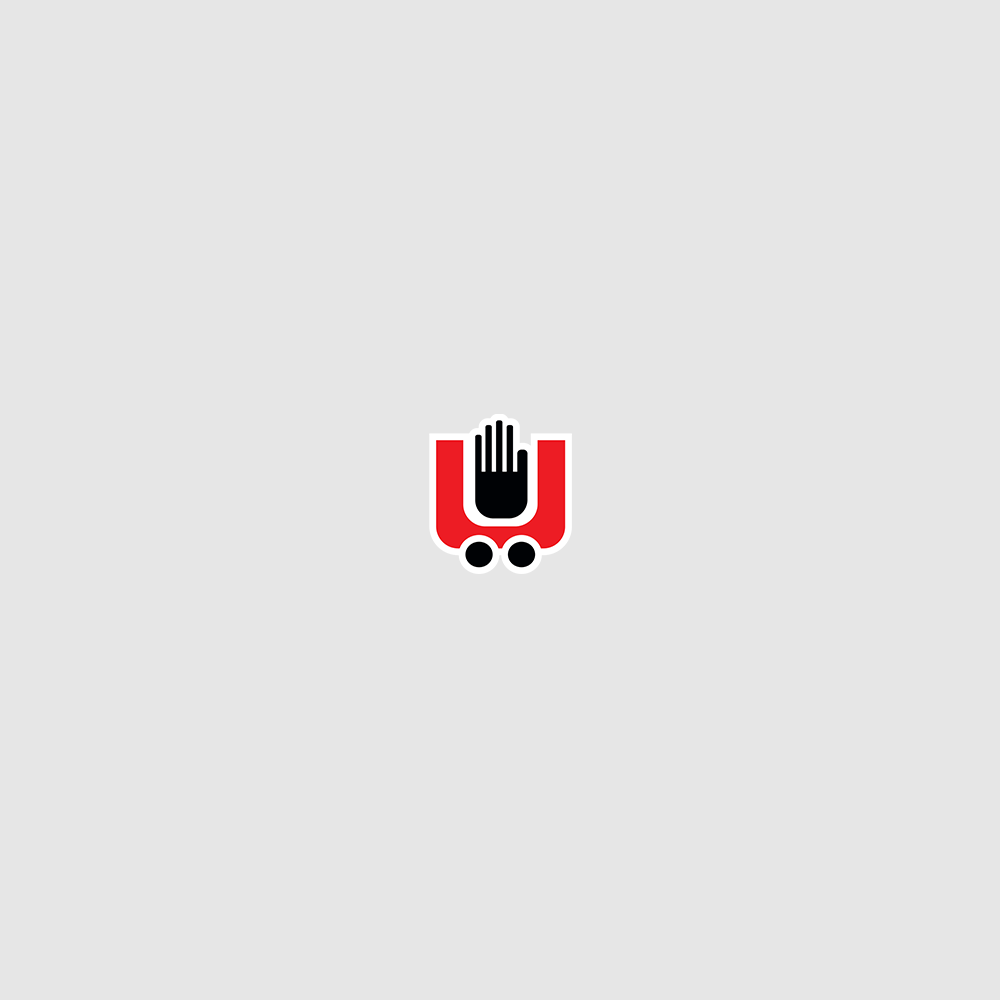إلى وزارة الداخلية: يا «ضابط».. يا اتنين عُور!
في تقديري إن منظومة الأداء الراقي والمنضبط للشرطة وأجهزة الأمن، هي العامل الأهم للحفاظ على حالة التناغم المأمولة بين السلطة والشعب.. وأي انحراف عن تلك المنظومة من شأنه أن يُلْبِسُ الجميع في الحائط، ويشكل تهديدا أشد خطرا على البلاد والعباد من خطر العدوان الخارجي.. ويضع المجتمعات على حافة السقوط في غياهب الفوضى.
مقدمة لا بد منها في خضم المشاعر السلبية تجاه الداخلية، لما اقترفه بعض المنتمين إليها في الآونة الأخيرة.. ولا أدري لماذا ألَحَّ على ذهني صديق راحل شغل عدة مواقع مهمة بوزارة الداخلية.. أتحدث عن العميد سمير عودة ضابط المباحث المهني المحترف باعتراف قيادات الداخلية.. كان صاحب أسلوب فريد في التعامل مع من يستشعر توقيفه عن طريق الخطأ، أو الواضح عليه الاحترام ولا تتناسب مآلات توقيفه مع ما ارتكبه من خطأ هو في الغالب دون قصد.. كان يساومه على إطلاق سراحه مقابل نكتة جديدة.. أحيانا تكون النكتة سمجة أو قديمة، لكنه كان يتصَنَّع الضحك إعجابا بها، ثم يطلق سراح المواطن.
ما وددت قوله إن هناك نماذج تستحق الاحترام والإعجاب.. والعبد لله شخصيا كانت له تجارب لمواقف من الصعب أن يخرج منها المواطن سالما من بين براثن رجال الشرطة.. إذ كنت ألجأ للدعابات إذا ما أوقعني حظي العثر في كمين أشعر بتوتر أفراده، فأنتقي ضابطا أشم على ملامحه رائحة السماحة وأبدأ في إطلاق إفيهات خفيفة ثم التوسل بأسلوب الأغاني الشهيرة.. بدأت مرة بسؤال الضابط هل هذه لجنة يا باشا؟ قال لأ كمين..
فقلت متوسلًا: والنبي يا "كمين" حوش عني هواك.. وذات مرة كان ضابط الوردية في حالة مزاجية تدفعك إلى لعن اليوم الذي ولدت فيه.. وكنت بصحبة صديق سحبوا رخصته بلا داع.. أي والله.. المهم أن الضابط كان يمر بالقرب منا، فرفعت صوتي مُحَدِّثا صديقي يا ضابط "بالضاد".. فالتفت إلينا بتكشيرة من ذلك النوع الذي يرعب المعيز ويقطع الخلف.. فقلت وأنا أوجِّه كلامي لصاحبي: ما بدهاش.. "يا ضابط" يا اتنين عُور، فابتسم ضابط الوردية ومرت الليلة التي كانت على وشك السواد..
موقف ثالث، كنا عائدين إلى الشرقية بعد توديع ابنة عمتي بمطار القاهرة، استوقفنا كمين على الطريق الصحراوي بعد منتصف الليل.. قررت القيام بدور البطولة وغادرت السيارة، وتوجهت إلى الضابط قائد الكمين، تطلعت في وجهه فتملكني الذعر من التجهم الذي علاه، ثم سألني: جايين منين؟.. قالها بلهجة مرت عليَّ كأنها لقطة من فيلم رعب، ولا أدري كيف تماسكت؟!.. فقلت له بهدوء شديد: كنا بنوَصَّل مُنَى.. قسما بالله كاد يسقط مغشيا عليه من الضحك.
هناك بالفعل أمثلة لرجال الشرطة تضع الواحد منهم على الجرح يشفى.. وهناك لا مؤاخذة نماذج (لا داعي للغلط).. لكن الخطأ من آحاد هؤلاء كفيل بقلب الترابيزة على الجهاز بأكمله.. هكذا جرت العادة في ردود الأفعال حيال أي خطأ لرجال الأمن مهما صغر حجمه.. لذا على رجل الشرطة أن يتحسس موضع قدمه بتركيز وذكاء شديدين قبل أي خطوة.
أختم بانطباع شخصي أراه مهمًا.. وهو أن التطلع إلى ضباط الداخلية في مجملهم شيء يشرح القلب.. لكن التطلع إلى بعضهم شىء يقطَّع القلب.. صادفت واحدًا من النوع الثانى فأطَلْت النظر في صورته، التي طافت بي عَبْرَ انطباعات شَتَّى.. فتارة تثير الريبة، وتارة تثير الشفقة، وتارة تثير الدهشة.. فانطلق السؤال: كيف دخل من الأساس كلية الشرطة واتجاهات بُؤبُؤ العين بحاجة إلى ترصيص وضبط زوايا ؟! إلا إذا كان من خريجى شرطة المعهد الدينى؟!
حالة الضابط المذكور فتحت الباب واسعًا لتوجيه النقد الشرس لعملية القبول بالشرطة ودخول من لا يستحقون، بسبب ضآلة المجاميع، والكوسة، وبطرق أخرى لا أملك الدليل على تأكيدها، بينما يشير إليها هيئة ومستوى ذكاء الخريجين اللذان ينعكسان مع الوقت على أداء الداخلية ويسيئان إليها بسبب هذا النوع..
خذ عندك مثلًا تحريات ضابط من النوع الذي أقصده.. تجدها لا تنير الطريق أمام النيابة أو المحكمة، بقدر ما تثير الحيرة والشك، لدرجة أن محاميًا حديث التخرج بإمكانه إفساد أي قضية بسبب "عبث وضحالة المحاضر ومذكرات التحريات".. حتى أننى لا أندهش لو قرأت تحريات ضابط من ذلك الصنف حول قضية قتل تقول: وقد أكدت التحريات من خلال مصادرنا السرية أن آخر حاجة شالها القتيل من على الأرض قبل ما ينام هي رِجْلِيه!