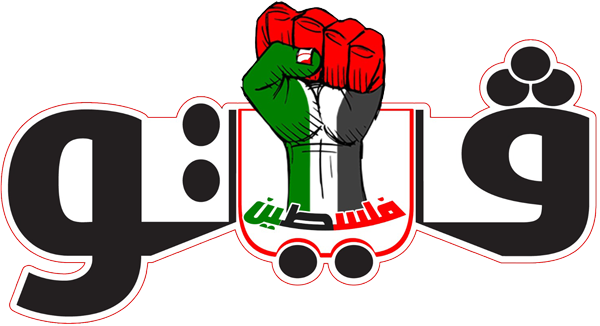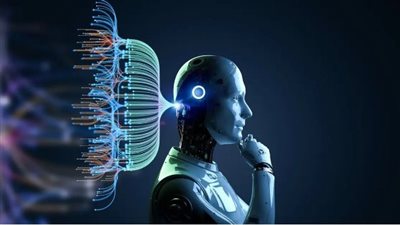د. عمار على حسن يرصد: الخط البــــــــــيانى لعملية إصلاح الأزهر

ولد الأزهر من رحم السياسة مرتديًا ثوب الدين، حين أريد له أن يجذر التشيع في العقلية والنفسية المصرية ويزيح الانحياز للمذهب السنى، فبدا بذلك مؤسسة ذات طابع "أيديولوجى" أكثر من كونها ذات سمت دينى. ورغم مرور أكثر من عشرة قرون على ميلاده، لا يزال الأزهر يجاهد ليبقى في قلب الظواهر المرتبطة بالسلطة سلبيًا وإيجابيًا، متحديًا، سواء في مواقف بعض رموزه أو بعض إنتاجه الفقهى والمعرفى، كل أولئك الذين يريدون فصل "السياسي" عن "الدينى"، ومطوقًا مجالات تمتد من الأمور المحلية البحتة حتى العلاقات الدولية.
وفى السنوات الأخيرة جلبت السياسة على الأزهر مشكلات حادة، لاسيما قبيل ثورة يونيو وبعدها، وكان الأمر قد تعدى الظروف المحلية إلى الأبعاد الدولية بعد تداعيات أفرزها حادث 11 سبتمبر 2001، تتمثل في المطالبة بـ"تعديل المناهج الدينية"، وهى مسألة يرى القائمون على الأزهر أنها تعد على سيادة هذه المؤسسة العريقة، التي باتت "جامعًا وجامعة". لكن هذا التصلب تهزه ضغوط هنا وهناك، يساندها اقتناع البعض من داخل الأزهر نفسه، بحيث يبدو من المتوقع أن يلين مع الأيام وتوالى الضغوط، ليجد الأزهريون أنفسهم في نهاية المطاف بحاجة حقيقية إلى الخروج من حواشى بعض الكتب الصفراء، والدخول في متن الحياة العصرية استجابة لـ"فقه الواقع"، الذي تعطل طويلًا في حياة المسلمين، خاصة أتباع "المذهب السنى".
هنا يبقى أمام الأزهر خياران، لا ثالث لهما على الأرجح، شأنه في ذلك شأن المؤسسات الأخرى، السياسي منها والاجتماعى والثقافى والتعليمى، في مصر، أو في العديد من البلدان الإسلامية الأخرى:
1 ـ التطوير من الداخل: ولا يعنى الاقتصار على ما ينتجه الأزهريون من معرفة دينية وعلمية فقط، بل يمتد إلى حصيلة الجدل الدائر بينهم وبين المسلمين في شتى أرجاء المعمورة، باعتبار الأزهر، مؤسسة دينية عالمية تتعدى حدود مصر وتقدم نفسها ويراها الآخرون على أنها تمثل مرجعية لأتباع المذهب السنى في العالم أجمع.
2 ـ التطوير من الخارج: ويعنى هنا إجبار الأزهر على تعديل مناهجه التعليمية ورؤيته الدينية، بما يخدم المصالح الآنية والآتية لقوى خارجية، تتمثل تحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ترى في تصورات الأزهر الراهنة، النابعة من قراءته للنص القرآنى والسنة النبوية، ما ينتج عداءً منظمًا ومبررًا عقديًا وفقهيًا ضدها.
ويرفض الأزهر إملاء أي شروط خارجية عليه، تنال من مناهجه التعليمية ورؤيته الدينية ومساره السياسي، النابع من كون الإسلام ينزع بطبعه نحو السياسة، لأنه يقدم رؤية متكاملة للحياة، لا تقتصر على المسائل الروحية، بل تشمل الواقع المعيش بشتى جوانبه. ومن ثم لا تبقى المشكلة في "تديين السياسة"، بل في "تسييس الدين". فمحاولة تهذيب السياسة والساسة بإطار قيمى أخلاقى نابع من الدين، تبدو مسألة محمودة، لكن المذموم تمامًا هو ممارسة السياسة تحت لافتة دينية، أو باسم الدين.
وبالطبع فإن الأزهر لا يقدم نفسه في اللحظة الراهنة بوصفه مؤسسة سياسية، لكن تعاطيه مع السياسة سيظل أمرًا قائمًا، بالتوازى مع دوره الدينى والعلمى، بعد أن صار "جامعة"، إلى جانب دوره كـ"جامع". هذا يجعل من الضرورى عند تناول تاريخ الأزهر أو دوره الحياتى المزاوجة بين عمودين أساسيين يقف عليهما هذا البناء الإسلامى الشامخ، الأول هو: الدور السياسي للأزهر.. والثانى يتمثل في "جهود إصلاح الأزهر سواء في بنيته المؤسسية أو مناهجه التعليمية أو رؤيته الدينية.
أولًا: تجارب إصلاح الأزهر: خط بيانى يتصاعد دومًاث فقد مر الأزهر طيلة التاريخ الحديث والمعاصر بمحاولات عدة لإصلاح أوضاعه، سواء كانت إدارية تتعلق بهيلكه ووضعه المالى أو التشريعات التي تحكم حركته، أم كانت تتعلق برؤيته الدينية ومناهجه التعليمية. وليس هنا مجال الحديث عن محاولات الإصلاح الإدارى والمالى، فالاهتمام سينصب على ما جرى من محاولات النهوض بالدور التعليمى والدينى للأزهر، لأن هذا هو محل الاهتمام حاليًا، ليس في مصر وحدها، ولا في العالم الإسلامى فحسب، بل في العالم أجمع.
وإذا كانت الوظيفة التعليمية للأزهر قد بدأت عقب الانتهاء من بنائه بسنوات قليلة حين جلس أبو الحسن بن النعمان قاضى القضاة ليتحدث في "فقه آل البيت" فإن أول محاولة حقيقية لإصلاح التعليم الأزهرى انتظرت أكثر من ثمانية قرون، إذ تمت أيام تولى محمد العروسى المشيخة، خلال الفترة المتراوحة بين 1818 و1829، حيث سعى إلى إدخال علوم الطب والكيمياء والطبيعة لتشكل جزءًا من المناهج التعليمية للأزهر، لكن سعيه خاب، نظرًا لعدم اقتناع القائمين على الأمر وقتها بأن الأزهر يمكنه أن ينتج تعليمًا وعلمًا خارج الدين. ولما جاء من يقتنع بالفكرة مات العروسى فدفنت معه مؤقتًا.
نعم انتعش الدور التعليمى للأزهر في العصرين المملوكى والعثمانى، بعد طول إهمال في عهد الأيوبيين لحساب مدارس اختصت بتدريس فقه المذهب السنى، لكن هذا الانتعاش كان بمثابة "توسع أفقى" في هذا الدور، إذ زيد في عدد المدارس الدينية بعد تجديد بناء الأزهر وتوسيع مساحته، فزاد معها عدد الطلاب الملتحقين به، وعدد المدرسين الذين يعقدون حلقات العلم الدينى فيه. لكن ظل الأمر مقتصرًا في أغلب الأحوال على تدريس العلوم الدينية من فقه وحديث وتوحيد ومنطق وعلم كلام، إلى جانب مبادئ في علم الفلك والرياضيات والآداب. ولم يكن الطلاب مقيدين بالانتظام في حضور دروس العلم، ولم تكن هناك لوائح تنظم سير العملية التعليمية، وتحدد مناهج الدراسة ومدتها وأعضاء هيئة التدريس. بل كان الطلاب أنفسهم يتحكمون في تعيين مدرسيهم، من خلال الإقبال على حلقاتهم من عدمه. فمن يداوم الطلاب على حضور دروسه، وتتسع حلقته العلمية، يجيز شيخ الأزهر صلاحيته للتدريس، والعكس صحيح.
ووضع الشيخ حسن العطار، الذي تولى مشيخة الأزهر في الفترة من 1830 و1834، لبنة جديدة في بناء إصلاح التعليم الأزهرى، مستغلًا علاقته المتوازنة مع محمد على، من جهة، وسعة إطلاعه من جهة ثانية، إذ كان ملمًا، إلى جانب علوم الدين، بعلم الفلك والطب والكيمياء والهندسة والموسيقى والشعر، ما حدا بالمؤرخ المصرى العظيم عبد الرحمن الجبرتى إلى أن يصفه قائلا: "قطب الفضلاء، وتاج النبلاء ذو الذكاء المتوقد والفهم المسترشد، الناظم الناثر، الآخذ من العلوم العقلية والأدبية بحظ وافر".
وقد استفاد العطار مما خلفته الحملة الفرنسية من علوم، ومن رحلاته إلى أوربا وبلاد الشام، في سعيه إلى إصلاح الأزهر، وكانت الثمرة إنتاج جيل من رواد النهضة المصرية الحديثة، ممن تتلمذوا على يد العطار، وفى مقدمتهم رفاعة رافع الطهطاوى، ومحمد عياد الطنطاوى.
لكن الخطوة الفارقة على درب إصلاح التعليم الأزهرى جاءت في عهد الخديو إسماعيل، ودشنها قانون صدر عام 1872، لتنظيم حصول الطلاب على شهادة "العالمية"، وتحديد المواد الدراسية بإحدى عشرة مادة زاوجت بين العلوم الدينية والأدبية، إذ حوت الفقه والأصول والحديث والتفسير والتوحيد والنحو والصرف والبيان والبديع والمعانى والمنطق. كما حدد القانون طريقة امتحان الطلاب، بأن يوضع الطالب موضع المدرس، ويصبح ممتحنوه في موضع الطلبة، فيلقى الأول درسه ويناقشه الآخرون في مختلف فروع العلوم، نقاشًا مستفيضًا قد يمتد لساعات طويلة، بعدها يتم الحكم على مستواه العلمى.
وبعد هذا بربع قرن تقريبًا، وتحديدا عام 1896، دبت عافية الإصلاح قوية في ربوع الأزهر، بفعل عدة قوانين صدرت في عهد الإمام حسن النواوى، الذي تولى المشيخة خلال الفترة من 1896 إلى 1900، كان للإمام العظيم محمد عبده دور كبير في سنها. وحددت هذه القوانين سن القبول للأزهر بخمسة عشر عامًا، شريطة الإلمام بمبادئ الكتابة والقراءة. والأهم كان إدخال عدة علوم على المناهج التعليمية الأزهرية، منها التاريخ الإسلامى والهندسة وتقويم البلدان (الجغرافيا). وبمقتضى القانون نفسه أضيفت "شهادة" قبل العالمية سميت "الأهلية"، كانت تتيح لحاملها الخطابة بالمساجد، أما من يحصل على "العالمية"، فيحق له التدريس بالأزهر.
وقد فتح الإمام محمد عبده، برؤيته المستنيرة الموسوعية، نوافذ الأزهريين على الحياة الفكرية العامة، فراح تلاميذه، أو من تأثروا بأفكاره، يكتبون إلى الصحف اليومية، بعد طول احتجاب. ومن بين هؤلاء محمد شاكر وإبراهيم الحيالى وعبد المجيد اللبان ومحمد حسنين مخلوف، ومن بعدهم مصطفى لطفى المنفلوطى وعبد العزيز البشرى ومصطفى عبد الرازق وقاسم أمين ومحمد الههيادى وعبد الرحمن البرقوقى، بل وصل الأمر إلى أن بعضهم أصدر مجلات أدبية، مثل "الثمرات" لحسن السندوبى، و"عكاظ" لفهيم قنديل، و"البيان" لعبد الرحمن البرقوقى، وشارك كثيرون في الجدل الفكرى الذي أحاط بالحياة الاجتماعية والأحوال السياسية، التي سبقت وواكبت وأعقبت ثورة 1919.
وخلال عهد الإمام سليم البشرى (1900ـ 1902/ 1909 ـ 1916) أنشئت "هيئة كبار العلماء"، تحديدًا عام 1911، التي تغير اسمها في ظل مشيخة الإمام محمد مصطفى المراغى (1928 ـ 1929/1935 ـ 1945) إلى "جماعة كبار العلماء"، وكانت تتكون من صفوة علماء الأزهر، وهى نواة لـ"مجمع البحوث الإسلامية" الذي يشتد حضوره راهنًا في الحياة الاجتماعية، إلى جانب "جبهة علماء الأزهر" التي تملأ الدنيا صخبًا من خلال تعليق بعض أعضائها على الأحداث الجارية، أو رقابتهم على بعض الأعمال الفكرية والثقافية، التي يدور حولها لغط، ويتهمها البعض بالتجديف في الدين، وهى المسألة التي زادت بشكل ملموس في عهد إمامة الشيخ جاد الحق على جاد الحق (1982 ـ 1996).
لكن بذرة تحول الأزهر إلى "جامعة" غرست عام 1930، في عهد الإمام محمد الأحمدى الظواهرى (1929 ـ 1944)، حيث تم إنشاء ثلاث كليات هي "أصول الدين" و"الشريعة" و"اللغة العربية"، فلما جاء عام 1961، صدر القانون رقم 103، الذي بات الأزهر بمقتضاه "جامعة"، بعد أن أضيفت إلى كلياته الثلاث المذكور كليات مدنية مثل "الهندسة" و"الطب" و"الإدارة" و"الزراعة" و"البنات"، وقد كان ذلك في عهد الإمام محمود شلتوت (1958 ـ 1964).
ووازى هذه التطور في البنية التعليمية تدرج في الإصلاح الفكرى للأزهر، كان يعلو ويهبط، يتوهج ويخبو، حسب التكوين العقلى لمن يتولى المشيخة. وإذا كانت حركة النهضة المصرية قد اشتد عودها مع بداية القرن العشرين، فإن الأزهر في ذلك الآونة، كان يقوده رجلًا ناصر الثورة العرابية، وتولى نظارة دار الكتب، وكان صديقًا لمحمود سامى البارودى، وتحمس بقوة لأفكار الإمام محمد عبده الإصلاحية، وهو الشيخ على محمد الببلاوى (1902 ـ 1905). لكن خلفه الشيخ عبد الرحمن الشربينى (1905 ـ 1906)، كان تقليديًا سلفيًا، عادى الإصلاح وتحيز للقديم. فلما جاء المراغى وضع نواة رقابة الأزهر على المنتج الفكرى من خلال إنشاء هيئة تراقب البحوث والثقافة الإسلامية والكتب التي تهاجم الدين. وتبعه الظواهرى، الذي كان إصلاحيًا إلى حدٍ كبير، يميل إلى تجديد الفقه بما يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية، ويسعى إلى أن يكون علماء الدين ملمين بمجريات الواقع، وأن يفهموا في السياسة قدر فهمهم في الفقه والأصول والحديث..إلخ. وقد كان الظواهرى يطبق هنا أفكاره التي ضمنها في كتاب وسمه بـ"العلم والعلماء"، دافع فيه باستماتة عن الأفكار الإصلاحية لمحمد عبده، ما دفع الخديو عباس حلمى إلى محاربته، وجمعت نسخ الكتاب لتحرق في ساحة الجامع الأحمدى بطنطا، لكن مصادرة الكتاب، لم تحل دون ذيوعه، فانكب الطلاب ينسخون منه صورًا باليد، ويتبادلونها. وأعاد الإمام عبد الحليم محمود طبع الكتاب، حين كان يتولى أمانة مجمع البحوث الإسلامية.
وبعد الظواهرى تبوأ مشيخة الأزهر رجل مستنير، من تلاميذ محمد عبده، إنه الإمام مصطفى عبد الرازق (1945 ـ 1947)، الذي درس الفلسفة والآداب بجامعة السربون، فزاوج بين ثقافة الغرب وتراث الإسلام، ولذا نادي بانفتاح الأزهر على الغرب، وشيد قاعة محمد عبده بالأزهر لتكون ملتقى للمؤتمرات الدولية الإسلامية، وترجم بعض الكتب الدينية، وفى مقدمتها "رسالة التوحيد" إلى اللغة الفرنسية. وواصل خلفه الإمام محمد مأمون الشناوى (1947 ـ 1950) ما أمكنه مسيرة عبد الرازق، حين أرسل نوابغ طلاب الأزهر لتعلم اللغة الإنجليزية، كى يصبحوا دعاة عصريين قادرين على مخاطبة "الآخر". أما الإمام عبد المجيد سليم (1950 ـ 1951/ 1952 ـ 1954)، فقد انصب اهتمامه على تحرير الفقه من التقيد بالمذاهب، التي حاول التقريب بينها، ودعا إلى إعمال العقل في الأمور الدينية.
وبعد ثورة يوليو 1952، حاول أغلب من تولوا مشيخة الأزهر تطويع رأى الدين لخدمة السياسات السائدة، فشلتوب أفتى بأن "القوانين الاشتراكية لا تتعارض مع الإسلام"، والدكتور محمد الفحام الذي تولى المشيخة في الفترة من (1969 ـ 1973)، اعتبر أن الانقضاض على الاشتراكية بمقتضى ما أسماها السادات ثورة التصحيح عام 1971 هو "خطوة تأتى من أجل كفالة الحريات للوطن والمواطنين وسيادة القانون وبناء لدولة الجديدة".
لكن الأزهر كان قد استوعب الكثير من الأفكار الإصلاحية التي روج لها رواده على مدى قرن من الزمان، يبدأ من منتصف القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين، إلا أنه لم يتخذ خطوات فارقة على هذا الدرب، نظرا لطغيان "السياسي" على "الدينى" و"الفكرى" معًا عقب قيام ثورة يوليو، بما جعل الخط البيانى في إصلاح الأزهر، يعلو ببطء لا يقارن أبدًا بالقفزات التي كانت حدث من قبل، حين شرع أنصار الليبرالية في طبع بصماتهم على الرؤية الدينية، بما يمكنها من أن تلقى بغمارها تدريجيًا في الواقع المعيش، وتخرج من إسار الكتب القديمة، التي أنتجها الفقهاء في عصور ولت.
ثانيًا: شيوخ الأزهر والسياسة: مسارات متعرجة في مساحات ضيقة
شكلت عناصر ثلاثة الدور السياسي للأزهر في مسيرته التاريخية، كانت تجتمع أحيانًا فيتعاظم هذا الدور، بغض النظر عما إذا كان خصمًا من رصيد المجتمع أم لصالحه، وأحيانًا أخرى كان يتوافر أحدها أو اثنين منها، فيقل دور الأزهر السياسي. لكنه، في جميع الأحوال، لم ينقضِ تمامًا.
أ ـ العنصر الأول: هو شخصية شيخ الأزهر من حيث فهمه للواقع السياسي وإلى أي اتجاه يميل انحيازه الفكرى والنفسى، للجماهير الغفيرة ومصالحها أم لمصلحته الذاتية مع السلطان وحاشيته.
ب ـ العنصر الثانى: يتمثل في طبيعة السياق الاجتماعى ـ السياسي السائد. ففى الظروف التي كانت السياسة فيها حاضرة وضاغطة إما بفعل الحروب أو القلاقل أو الصراعات الداخلية أو احتداد المشكلات الحياتية للناس، كان لا بد للأزهر أن يدلى بدلوه فيما يدور ويتخذ من المواقف ما يتماشى مع سير الأحداث، إذ إن المجتمع المصرى، كان ولا يزال، ينتظر رأى الدين فيما يجرى اجتماعيًا وسياسيًا.
ج ـ العنصر الثالث: يتعلق بشخصية الحكام أنفسهم. فهناك من بينهم من لجأ إلى الأزهر لكسب الشرعية، وهناك من استمد شرعيته من روافد أخرى. هناك من أفسح المجال لعلماء الأزهر كى ينخرطوا في الحياة السياسية وهناك من أوصد الباب أمامهم تمامًا. هناك من كان يؤمن بأن للدين رؤية سياسية واجتماعية وهناك من أراد له أن ينكفئ على أمور العقيدة والعبادة مبتعدًا عن الهموم والأحوال الحياتية.
وقد بدأ الدور السياسي لشيخ الأزهر يبرز في ظل مشيخة الإمام محمد الحفنى (1757 ـ 1767)، الذي بلغ في هذا المضمار شأنًا عاليًا، رسم الجبرتى ملامحه قائلًا: "كان شيخ الأزهر محمد الحفنى قطب رحى الديار المصرية، ولا يتم أمر من أمور الدولة وغيرها إلا بإطلاعه وإذنه". وقاد احتجاج الشيخ أحمد العروسى على إساءة الوالى العثمانى أحمد أغا لأهالي الحسينية إلى صدور فرمان سلطانى بعزل هذا الوالى. واضطر خلفه إلى أن يحضر إلى الأزهر ليسترضى علماءه. وبعد العروسى كان الأزهر على موعد مع رجل زاوج بين الدين والسياسة، في الفكر والحركة، وهو الشيخ عبد الله الشرقاوى (1793 ـ 1812)، الذي عاصر هبات المصريين ضد الحملة الفرنسية، وكان واحدًا من رموز الشعب آنذاك، وحشد طاقة الأزهر في طليعة مقاومة الاحتلال، وعينه نابليون بونابرت ضمن عشرة في "مجلس الشورى" الذي أنشأه لاسترضاء المصريين. وكان الشرقاوى ممن أخلعوا الولاية على محمد على واشترطوا عليه الحكم بالعدل، لكنه نقض العهد، وتخلص من مشايخ الأزهر ومن بينهم الشرقاوى. أما الشيخ الشنوانى (1812 ـ 1818) فكان دائمًا يسدى النصائح لمحمد على، رغم عزوفه عن الاتصال بمن بيدهم السلطة، وقد كان أيضًا من قادة الحركة الوطنية إبان الحملة الفرنسية.
وكان الشيخ حسن العطار من قادة الحركة الوطنية ضد الحملة الفرنسية، وتولى المشيخة بعد تدخل شخصى من محمد على، وكان يميل إلى الاحتفاظ بعلاقة "متوازنة" مع السلطة، مبررًا ذلك بأن مصلحة الأزهر تقتضى ذلك. أما الشيخ إبراهيم الباجورى (1847 ـ 1860)، فقد حرص على إعلاء كرامة علماء الأزهر في مواجهة السلطة، وكان عباس باشا الأول يحضر دروسه، ولم يعبأ باعتراض رجال الحكم على قيامه بتعيين هيئة من العلماء تحل محله في القيام بأعمال المشيخة حين أنهكه المرض. واصطدم الشيخ مصطفى محمد العروسى (1860 ـ 1870) مع السلطة، لاعتراضها على قيامه بفصل عدد من المدرسين بالأزهر رأى أن مستواهم العلمى دون المستوى المطلوب. وكان خلفه محمد المهدى العباسى (1870 ـ 1882/1882 ـ 1885)، الذي لم يتحمس للثورة العرابية، فتمت إزاحته من منصبه وقت عنفوانها، لكن بعد انكسارها أعاده الخديو توفيق، لكن لم يلبث أن اختلف معه، فطلب إعفاءه من منصبه، فاستجيب له.
أما الإمام شمس الدين الإنبابى (1882 ـ 1882/1885 ـ 1896)، فقد أفتى بعدم صلاحية توفيق للحكم، بعد أن باع مصر للأجانب، مناصرًا بذلك عرابى ورفاقه. لكن معارضته للخديو عباس الثانى قادت إلى تدخل السلطة في شئون الأزهر بإنشاء مجلس إدارة له، نال من صلاحيات شيخه. كما قادت معارضة خلفه الشيخ حسونة النواوى (1896 ـ 1900) للحكومة في إقدامها على تعديل قانون المحاكم الشرعية، إلى إبعاده من منصبه، لكن العلماء تضامنوا معه، فلجأت الحكومة إلى حل وسط بتعيين شيخ يمت بصة قرابة له هو الشيخ عبد الرحمن النواوى.
وتسببت مناصرة الشيخ على محمد الببلاوى لأفكار محمد عبده إلى اصطدامه بالخديو عباس، الذي رفض مقترحاته لإصلاح الأزهر، فما كان منه إلا أن استقال.
ولعب خلفه الشيخ عبد الرحمن الشربينى دورًا مضادًا، بعد أن لجأ إليه الخديو ليحارب حركة الإصلاح في الأزهر بفعل أفكار محمد عبده. لكنه لم يلبث أن استقال عندما تمادى الخديو في معاداة أنصار الإصلاح. وعارض الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوى (1917 ـ 1927) ما انتواه الملك فؤاد من إعلان نفسه خليفة للمسلمين بعد سقوط الخلافة العثمانية، مبررًا ذلك بأن مصر لا تصلح دارًا للخلافة، لوقوعها تحت الاحتلال الإنجليزى. ورفض الجيزاوى الاستجابة لطلب الإنجليز بإغلاق الجامع الأزهر إبان ثورة 1919، وصدر في عهده قانون قيد سلطة الملك في تعيين شيخ الأزهر، حين أشرك رئيس الوزراء في هذا. ولم ترق محاولة الحكومة حرمان شيخ الأزهر من بعض الأوقاف الخاصة به، للشيخ المراغى فاستقال، لكنه لم يكن مناهضًا للسلطة، شأنه في ذلك شأن خلفه الظواهرى، الذي تعاون مع الملك فؤاد في توسله بالأزهر لكسب الشرعية، وتدعيم سلطته المضادة لمصالح الشعب. وكانت ذريعة الظواهرى في هذا هي أن مصلحة الأزهر في التبعية للملك لا للحكومة أو الأحزاب. ونكل الملك في عهد الظواهرى بعلماء الأزهر، ففصل بعضهم وشرد آخرين، بعد أن صدر قانون خول الملك سلطة تعيين شيخ الأزهر ووكيله، وشيوخ المذاهب الأربعة، ومديرو المعاهد الدينية.
وفى ظل مشيخة الإمام محمد مأمون الشناوى، أصدرت مجموعة من العلماء بيانًا شهيرًا دعت فيه إلى الجهاد ضد إسرائيل بعد صدور قرار تقسيم فلسطين عام 1947. وأدت المواقف الوطنية للإمام عبد المجيد سليم إلى عزله، إثر معارضته لفساد الملك فاروق قائلًا عبارته الشهيرة، حين قرر الملك تخفيض المخصصات المالية للأزهر: "تقتير هنا وإسراف هناك"، في إشارة إلى بذخ فاروق. واستمر الخلاف بين الملك والأزهر في عهد الإمام إبراهيم حمروش (1951 ـ 1952)، فأعفى من منصبه بعد أن رفض طلب فاروق عدم اشتغال علماء الأزهر بالسياسة.
وبعد ثورة يوليو مال شيوخ الأزهر في الغالب الأعم إلى تأييد توجهات السلطة. فالإمام محمد الخضر حسين (1952 ـ 1954) وهو تونسى الأصل، وصف الثورة بأنها "أعظم انقلاب اجتماعى مر بمصر منذ قرون"، لكنه لم يلبث أن قدم استقالته لخلاف مع الرئيس جمال عبد الناصر حول إلغاء المحاكم الشرعية. وجار خلفه الشيخ عبد الرحمن تاج (1954 ـ 1958) عبد الناصر في خلافه مع محمد نجيب فأفتى سريان عقوبة التجريد من شرف المواطنة على من يتآمر ضد بلاده، قاصدًا بذلك نجيب، وهاجم الإخوان المسلمين بعد حادث المنشية 1954، من خلال بيان أخذ عنوان "مؤامرة الإخوان"، اتهم الجماعة بأنها تشوه الدين الإسلامى. وأفتى الشيخ شلتوت بعدم تعارض قوانين الاشتراكية مع الإسلام، كما سبقت الإشارة. ولم يجاهر برفض القانون رقم 103 لسنة 1961، الذي أعطى رئيس الجمهورية حق تعيين شيخ الأزهر، ووكيله، وتحجيم صلاحياته عبر تعيين وزير يختص بشئون الأزهر.
وسار الشيخ حسن مأمون (1964 ـ 1969) على الدرب نفسه، فكان موقفه سلبيًا من القانون، المذكور سلفًا، إذ صدر حين كان مأمون عضوًا في مجلس الأمة ورئيسًا للمحكمة الشرعية. وبات أول من طبق عليه هذا القانون حين تولى مشيخة الأزهر. وكان مأمون من المدافعين عن القوانين الاشتراكية، ووصف الإخوان بأنهم "مجرمون".
ولما جاء الفحام، أيد "ثورة التصحيح"، كما تقدم، وأيد خلفه الدكتور عبد الحليم محمود موقف السادات من القوى اليسارية بعد أحداث 17 و18 يناير 1977 الشهيرة، ووصف الشيوعيين بأنهم "ملحدون لا ينتمون إلى جماعة المسلمين"، لكنه عارض مسألة تبعية الأزهر لوزير شئون الأزهر، واستجاب السادات له، فصدر القانون رقم 350 لسنة 1975، الذي بمقتضاه صار شيخ الأزهر بدرجة رئيس وزراء، من الناحية المالية، ويتبع رئاسة الوزارة إداريًا. ونادي الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار، الذي تولى مشيخة الأزهر خلال الفترة من 1979 إلى 1982، بعدم معارضة الحاكم إلا في الأمور الجوهرية، وسعى إلى تجنيب الأزهريين أي صدام مع السلطة، بعد قرارات سبتمبر 1981 التي زج السادات بمقتضاها كل معارضيه في السجن.
أما الشيخ جاد الحق على جاد الحق فهو إن كان قد أيد معاهدة السلام مع إسرائيل حين كان يتولى الإفتاء، فقد رفض التطبيع بعد توليه المشيخة اعتراضًا على عدوان إسرائيل المستمر على الفلسطينيين، وأعلن من بعد، تأييده للانتفاضة الفلسطينية، والعمليات الاستشهادية، وندد بموقف الولايات المتحدة المنحاز إلى إسرائيل دومًا، كما رفض مشروع الشرق أوسطية. وعارض جاد الحق فتاوى إباحة عائدات البنوك وشهادات الاستثمار ورفض توصيات المؤتمر الدولى للسكان، الذي استضافته القاهرة عام 1996.
وأخيرًا، فمن المعروف عن الدكتور محمد سيد طنطاوى، الذي تولى المشيخة عام 1996، مجاراته للسلطة السياسية في مواقفها، وتراجعه عن أي رأى أو فتوى كان قد أصدرها طالما لم تلقَ قبولًا لدى السلطة، الأمر الذي جعل التناقض يعترى مواقف الأزهر في السنوات الأخيرة.
ويحاول الشيخ أحمد الطيب أن يعيد للأزهر بعض استقلاليته وهيبته، لكن جهوده حتى الآن متعثرة ومترددة، وتحتاج إلى قدر كبير من الإقدام والرؤية الشاملة العميقة، التي تبدأ بتخليص مناهج الأزهر نفسه من ركام سيئ خلقته التصورات الدينية المتزمتة والمتطرفة عبر سنين طويلة.
المصادر:
بحث الخط البيانى لعملية إصلاح الأزهر للدكتور عمار على حسن «بتصرف»